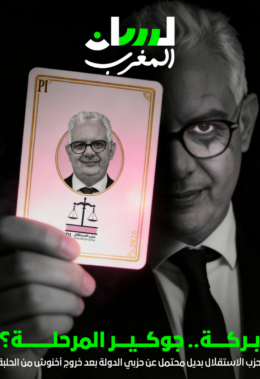“ما بعد 31 أكتوبر 2025”

بالفعل، “هناك ما قبل 31 أكتوبر 2025، وهناك ما بعده”. في أسبوع سالَ كثير من المِداد بشأن التحول الذي شهدته قضية الصحراء المغربية. قرار مجلس الأمن رقم 2797 خطوة كبيرة نحو الحل.
احتفى المغرب بالقرار باعتباره انتصاراً لحقّ. وفي سياق هذا الاحتفال، أعادت قوى سياسية التذكير بمطلب الديمقراطية، مع لزوم تثمين القرار، وأخصّ بالكلام جماعة العدل والإحسان، كبرى قوى المعارضة، التي صارت تُفصِّل أكثر في مواقف كانت لعقود مُجملة.
بالمحصّلة، كل النقاش جرى تحت سقفِ الوطن والوحدة، بمسؤولية تقرّ بنجاح الدولة على طريق صون جزءٍ من كيان الوطن، في زمن تفتّت الأوطان وتغيّر الجغرافيات.
الآن، يُفترض أن يتعمّق النقاش أكثر بشأن ما يستجلبه هذا التحوّل من تأثيرات داخلية. وغير بعيد، يُفترض تدوير النقاش حول علاقة هذه الانعطافة التاريخية في قضية الصحراء بالديمقراطية الداخلية، التي لا تقلّ أهمية عن “الوحدة”، إن لم تكن لازمةً لها، وأحد أهم عناصر تثبيتها.
وأقول بهذه الفكرة إيماناً بأن الدولة الديمقراطية تُضعِف مزاعمَ الانفصال، والعكس صحيح. ومعنى هذا أن الدولة الديمقراطية مُستقطِبةٌ وجالِبة، لا مُنفِّرة، وهي ضَمانَة، والأقدرُ على إرسال إشارات موثوقة حول مضمون الوطن والمواطنة المحميّة بدولة الحق والقانون.
لهذا، أجد كثيراً من الوجاهة في مطلب الديمقراطية في سياق التحوّل التاريخي بشأن قضية الصحراء. ومن يريد افتعال تناقضٍ بين الوحدة الترابية لبلدنا ومطلب الديمقراطية إنما يخدم، بشكل ما، أُزْعُومة الانفصال التي تُخَوِّف من الدولة المركزية ونواياها.
والدولة التي كافحت عقوداً للدفاع عن الوحدة الترابية، وبدأت مع قرار مجلس الأمن “فتحا جديدا في مسار ترسيخ مغربية الصحراء” (الخطاب الملكي)، ستواجه تحديّات لا تقلّ أهمية، ترتبط بالبناء الداخلي، في علاقة بالصحراء وقضايا النخبة هناك، ومن يُفترض أن “يحكم”، وشبكة المصالح والامتيازات، وحتى الريع، وكذا انشغالات العائدين المحتملين وتوقّعاتهم، والتحديات المرتبطة بإدماجهم واستيعابهم، وغيرها.
وعلى الوجه الآخر، تبرز تحديثات فيما يرتبط بباقي مناطق المغرب الموحَّد، حتى لا نكون أمام “مغربين”، بل في وضعية “عدالة ترابية”. إننا نتحدث في الجوهر عن واحدة من كبرى عمليات إعادة تعريف (وتوزيع) السلطة قد يكون شهدها المغرب الحديث.
على هذا الأساس، يصير لنقاش الديمقراطية معنىً، إن لم يكن قُطب الرحى ضمن التحولات التي سيشهدها المغرب على مجموع ترابه، وليس في منطقة الصحراء وحدها. وعلى هذا الأساس أيضا، يجوز القول إن القرار الأممي يطلق مسارا جديداً، يتجاوز الإقناع بمقترح الحكم الذاتي أساسا للحل السياسي في الصحراء، إلى عملية بناء وتنزيل داخلي شاقة ودقيقة، يُفترض أن تجيب، في مرحلة ما، عن سؤال حدود تأثير نموذج الحكم في الجنوب المغربي على باقي المناطق.
أما خارجياً، فيلزمُ الانتظار أكثرَ لقياس مدى تأثير القرار الأممي، الذي نقل القضية فعلاً إلى مستوى جديد، يخدم استراتيجية المغرب الوحدوية داخلياً، ورؤيته التصالحية للمنطقة المغاربية، المعبّر عنها بشكل واضح في خطاب الملك محمد السادس الأخير.
نحتاج وقتاً لفهم سلوك جبهة البوليساريو للمرحلة المقبلة. ومع ذلك، نسجّل ملاحظة تبدو مهمة، ترتبط بتعديلٍ في الموقف خلال أيام: ليلة الجمعة 31 أكتوبر أصدرت الجبهة بيانا اعتبرت فيه قرار مجلس الأمن “انحرافا خطيرا” وجزمت أنها “لن تكون طرفاً في أي عملية سياسية أو مفاوضات” على أساسه. ويوم الاثنين ( 3 نونبر)، يعلن محمد بيسط، القيادي فيها، عقب لقائه وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، أن القرار “إيجابي” و”ننتقل الآن لبحث آليات تطبيقه”.
نفس الأمر يمكن رصده في سلوك الجزائر، التي أسميتها في مقالي للأسبوع الماضي بـ”دولة الوصاية” على قرار البوليساريو، إذ نلمسُ تغيّرا بين الجمعة وما تلاها من أيام، يمكن تبيُّنُه ما بين كلام المندوب الجزائري لدى الأمم المتحدة، الذي تحدث عن قرار “يُحدث خللاً في التوازن بين طرفَي النزاع” و”يخلّ بمبادئ الأمم المتحدة”، وبين تصريحات وزير الخارجية الذي تحدث عن “جوانب إيجابية”، وترويجه أن الجزائر “كانت قاب قوسين أو أدنى من الموافقة عليه” لو حُذفت عبارة “السيادة المغربية”.
هذا يعني أن اللهجة تغيّرت في غضون أيام، لتغيّر تكتيكات التعامل مع القرار الأممي. ولربما نتوقّع في المرحلة المقبلة مزيداً من “إنضاج” الجواب السياسي للتعامل مع الحقائق المُستجدّة.
الآن، وبدون استعجال، وبحسب المتاح من مؤشرات، نجازفُ بالقول إن البوليساريو، ومن خلفها الجزائر، تحاول التموقع من داخل القرار الأممي، لتحقيق غرضين على الأقل: أولهما عدم الوقوع في حالة صدام مع الشرعية الدولية ممثلة بقرار مجلس الأمن، بالتعبير عن الاستعداد لـ”بحث آليات تطبيقه”، أي التفاوض، مادامت مقاطعة المفاوضات قد تعني عزلة دولية.
وثانيهما، المناورة من داخل القرار، بالتأسيس لمقولات جديدة/ قديمة، عبر افتعال حالة تناقض بين خطة الحكم الذاتي وتقرير المصير، وأيضا عبر الاشتغال على فكرة أن القرار الأممي يعتبر خطة الحكم الذاتي المغربية حلا من بين حلول على الطاولة، لا خياراً حصرياً أو مرتكزاً للتفاوض.
هذا التكتيك يهدف إلى خدمة استراتيجية تعويم النقاش وتمطيطه، وأيضا دحرجته بعيداً عن خطة الحكم الذاتي، لكسب مزيد من الوقت على أمل تغيّر موازين القوة التي تميل لصالح الرباط، المسنودة برؤية مغربية واضحة، تُقابَل بارتباكٍ يشكّل عناصر مأزقٍ كبير في الجهة المقابلة، التي فقدت القدرة على المبادرة وعلى إنتاج الفعل.
وإنّ مسارعة المغرب إلى التزامه بإعلان خطة حكم ذاتي مُحَيّنة وتفصيلية تُظهر جدّيته، وأيضا حرصه على حماية الزخم الدولي الناشئ عن ليلة 31 أكتوبر من التلاشي، وثالثاً تهدفُ إلى محاصرة أي نزوعٍ للتلاعب والإغراق في تأويل القرار للتهرّب من التفاوض وفق الأسس الجديدة التي وضعها مجلس الأمن.
قصارى القول
وإنْ ضخّ قرار مجلس الأمن مناسيبَ تفاؤل عاليةً لجهة تقريب الحل، فإنه راعى توازنات إقليمية، يشتغل المغرب على إدارتها بمساعدة داعميه، خاصة واشنطن، عبر سياسة “اليد الممدودة”، وفق رؤية تقوم على معطى أن اختصار الطريق نحو الحل يوجد جزء منه في الجزائر. بهذه الخلفية، وعلى ما أعتقد، يُمكن تفسير تصريحات وتحركات مسعود بولس، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ومادام هناك أملٌ، لا خيار غير تدبير هذه العلاقة الإقليمية على قاعدة (لا غالب ولا مغلوب)، ولأنّ القضية، وهذا أمرٌ بالغ الأهمية، ليست من نوعِ النزاع الحدودي بين الدول ممّا يصلح معه الحسم العسكري، وإنما ترتبط بجزءٍ من المغاربة لعِبت برؤوسهم نزوع الانفصال، ولا بدّ من “صبرٍ بلا حدّ” لتجريب كل مسارات التسوية السلمية التوافقية المُرضية لاستخلاصهم من أوهام التقسيم.
لهذا، وبقدرِ أهمية القرارات الأممية، تبقى التسوية الإقليمية أجدى، و”المصالحات” مع جزءٍ من مكونٍ أساسي من الشعب المغربي مطالباً حيوياً، بحيث يكون “جميع المغاربة سواسية، لا فرق بين العائدين من مخيمات تندوف، وبين إخوانهم داخل أرض الوطن” ( الخطاب الملكي).