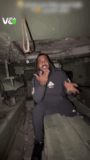غرفة العمليات3.. رئيس ضعيف!

هناك لحظات في السياسة تصنع فيها الأفعال أكثر مما تصنعه الأقوال. لكن في تلك الليالي الطويلة، حيث كانت ساعات الفجر تُقاس بعدد القتلى العائدين من فيتنام، تحوّلت غرفة العمليات في البيت الأبيض من مركز للقرار إلى شاهد على تآكل القرار نفسه.
لقد كانت “الوضعية”، بتعبير الأميركيين، عبارة عُقدة، وكانت الغرفة التي يفترض أن تفككها، تعمّقها.
لا نتحدث هنا عن غرفة العمليات كأداة هندسية لإدارة الأزمات، بل كمسرح داخلي تعكس فيه شاشات الرادار ارتباك النفس الرئاسية، وتكثّف فيه أجهزة التسجيل صوتَ القلق، وتدوّن الأقلام الدقيقة لحظات الانهيار البطيء.
في هذه الحلقة من سلسلة “غرفة العمليات”، نقترب من الرئيس ليندون جونسون، لا كصانع قرار، بل كرجل تائه بين أنين الهاتف ونبض التلغراف.
الخميس 20 ماي 1965. والساعة تشير إلى الثانية فجرا. واشنطن نائمة، لكن رئيس الولايات المتحدة مستيقظ. يرفع سماعة الهاتف، ويتصل بغرفة العمليات ليسأل: “ما قصة هذا الكولونيل الذي قُتل؟”، ثم يسترسل في السؤال عن الطائرات التي عادت من هانوي، وعن الضربات الجوية، وعن الأسماء… يسأل عن كل التفاصيل.
لا شيء يبدو تافها بالنسبة له، لأن كُلّ شيء أصبح يُقاس بميزان الدم.
لم يكن جونسون رئيسا يخشى التفاصيل، بل كان يعيش داخلها. لم يكن لديه وقت واحد في اليوم، بل ثلاثة: صباحٌ نشط، مساءٌ اجتماعي، وليلةٌ طويلة من المكالمات والقراءات والقلق المتّصل.
سجلت أجهزة الـ«ديكتابيلت» مكالماته في الساعة الواحدة صباحا، ثم في الثانية، فالثالثة، والخامسة… وكأن النوم بالنسبة إليه لم يكن إلا رفاهية لا تليق بقائد يخوض حربا لا يؤمن بها، لكنه لا يستطيع مغادرتها.
في إحدى مكالماته، سأل الرئيس جونسون عن هوية امرأتين أمريكيتين قُتلتا في سايغون، طالبا أسماءهما. وفي أخرى، سأل عن نوعية المطار الذي قصفه الطيران الفيتنامي الجنوبي: “هل هو مطار نفاث؟”، “هل هو شمال الخط السابع عشر؟”، “هل عادت الطائرات؟”.
كانت التفاصيل وسيلته الوحيدة للشعور بالسيطرة، لكنها في الحقيقة كانت تكشف عن عجزه.
لقد قالها بنفسه: “قراراتك لا تكون أفضل من المعلومات التي تصلك”. كان يطارد “نبض القرار”، لكنه لم يكن يدرك أن التفاصيل التي يطاردها ليست هي ما سيُغيّر مجرى الحرب. فهذه الأخيرة لم تكن تُربَح بعدد الجثث، ولا تُدار من وراء الهاتف، ولا تُخاض كأنها جلسة تشريعية في الكونغرس.
في السياسة الداخلية، كان جونسون أسدا سياسيا، يمرّر القوانين كما لو أنه يقطع زبدةً ساخنة: قانون حقوق التصويت، قوانين الهجرة، البيئة، الصحة، الإسكان… أما في الشأن الخارجي، وتحديدا في فيتنام، فقد كان عاجزا، ومرتبكا، وتائها.
يقول المؤرخ مايكل بيسكلوس: “لم ير جونسون أي طريق للنصر في فيتنام”، لكنه مع ذلك، ظل يمضي فيها خطوة بخطوة، يلتهمه القلق من فقدان “المصداقية الأميركية”.
لم تكن غرفة العمليات إلا مكبّرا لهذا التناقض: مكان يجتمع فيه الرئيس بجنرالاته، يضع خرائط “كِه سانه” فوق الطاولة، ينقل كُرسيا من المكتب البيضاوي ليجلس به لساعات، يحدّق في مجسّمات الحرب كما لو أنها رقعة شطرنج.
لكن الجنود الحقيقيين لم يكونوا قطعا يمكن تحريكها بالأصابع، والخصم لم يكن مجرد خصم استراتيجي، بل فكرةُ استعمارية لم تعد قابلة للحياة.
لم تكن “ريزوليوشن روم” كما كان يُطلق عليها، غرفة تُصدر قرارات مصيرية فقط، بل أصبحت مرآة تكشف عن التآكل النفسي للرئاسة.
لاحظ مساعدو جونسون تدهور حالته النفسية، بعضهم استشار أطباء نفسيين لمحاولة فهمه. الأصوات في التسجيلات تظهر موظفين مرعوبين، يخاطبون رئيسا عابسا، بصوت خشن، كأنهم يسيرون على الزجاج. ضحك أحدهم في مكالمة مع جونسون، فتلقى ملاحظة رسمية لاحقا: لا تضحك، حتى ولو كان كل شيء “هادئا”.
في تلك الغرفة، لم يكن هناك مكان للمرح، ولا لحظات طريفة، ولا قصص تُروى. “لم أتذكّر موقفا واحدا مضحكاً في غرفة العمليات”، يقول مساعد الرئيس توم جونسون. كان هذا المكان مختوما برائحة السجائر، مكدّسا بالتقارير، تضج فيه الهواتف، لكن تتناقص فيه القناعة.
لم يكن جونسون فقط أسير غرفة العمليات، بل كان مدمنا على الاتصال. 72 هاتفا في مزرعته. وأجهزة تسجيل، وشاشات، وتقارير مكتوبة تصل كل ساعة، ونظام مراقبة يكاد يكون مَرضيا. لكنه مع كل هذه الترسانة التقنية، لم يكن يملك استراتيجية. كان فقط يملك القدرة على السؤال.
كان هذا الرئيس يخشى أن يكون الطيار الذي يرتكب الخطأ القاتل هو شاب من “جونسن سيتي” في تكساس، مسقط رأسه. كان يخشى أن تؤدي ضربة خاطئة إلى حرب مع السوفييت أو الصينيين. كان يعرف حدود القوة، لكنه لم يعرف طريق الخروج.
قد لا تسقط الدول بشكل مكشوف، وقد لا تنكسر الرئاسات في المظاهرات أو المحاكمات. أحيانا، يكون السقوط صامتا، في غرفة مغلقة، حيث يرن الهاتف في الرابعة فجرا، ليسأل رجل متعب: “هل عادت طائراتنا؟”.
والجواب يأتي من موظف مرهق: “نعم، سيدي. كل شيء هادئ”.
لكن الحقيقة ألا شيء كان هادئا. كانت الغرفة تغلي، والرئاسة تتآكل، والحرب تضيع، ورئيس الولايات المتحدة، سيد أكبر دولة في العالم، لا يملك من أدوات الحكم إلا القلق.
وهكذا، في قلب أقوى مؤسسات الدولة، كانت غرفة العمليات شاهدة لا على قرارات كبرى، بل على لحظات ضعف بشريّ، وخوف رئاسيّ، وسقوطٍ سياسيّ ناعم، لا يُعلن في مؤتمر صحفي، بل يُسجل على شريط “ديكتابيلت”، ويُحفظ في الأرشيف.
في المقال المقبل، سنغوص أكثر في التحوّل التكنولوجي الذي عرفته هذه الغرفة، وكيف سبقت بعض مؤسسات الدولة إلى مفاهيم التنصّت والتتبع والمراقبة، في زمن لم تكن فيه كلمة “رقمي” قد وُلدت بعد.
لكن قبل ذلك، دعونا نتأمل: ماذا يحدث حين يصبح الرئيس نفسه هو نقطة ضعف القرار؟