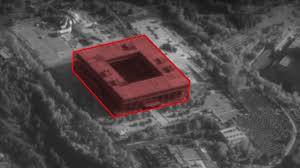صباغين الحمير
أفرجت الحكومة أخيرا عن زيادات في الأجور، ظلت موعودة منذ عامين كاملين، أي منذ توقيع ما يعرف باتفاق 30 أبريل 2022، والذي التزمت فيه الحكومة بمنح زيادة عامة في الأجور. لكن وكما يقول المثل المغربي “وقتما جا الخير ينفع”، وتضيف مقولة عربية ما مفاده أن تأخر الوصول أفضل من عدم الوصول.
يتعلق الأمر بجرعة اوكسيجين لا يمكن إنكارها أو تبخيسها، لكنها حتما لا يمكن أن تصبح مطية للتطبيل والتهليل كأن أحوال المغاربة تغيّرت بمجرد وقوف مجموعة من النقابيين المتقاعدين إلى جانب الحكومة في صورة جماعية هذا الاثنين 29 أبريل 2024.
أول ما ينبغي تدقيقه، لمنح الموضوع حجمه الحقيقي، هو عدد المعنيين بالزيادات المعلنة في الأجور.
يتعلّق الأمر بجزء صغير من مجموع الأجراء في المغرب، والذين يشكلون أصلا أقلية ضمن النسيج الاجتماعي الذي يغلب عليه الطابع غير المهيكل، واحتراف جل المغاربة لأنشطة زراعية أو حرفية خاصة. بالتالي نحن أمام قرار يستهدف أقلية داخل الأقلية.
وإذا جمعنا جميع المغاربة الذين يحصلون على دخل في شكل أجر شهري، فإننا لن نبلغ حتى الخمسة ملايين مغربي، بما أن مجموع الموظفين، مدنيين وعسكريين، لا يصل إلى المليون، ومجموع أجراء القطاع الخاص أقل من أربعة ملايين.
داخل هذه الأقلية من المغاربة، حصرت الحكومة قرار الزيادة في الأجور في الموظفين الذين لم يستفيدوا من زيادات أخرى في إطار مفاوضات قطاعية، وتعني أساسا كلا من قطاعات التعليم والتعليم العالي والصحة، وهي القطاعات الثلاثة التي تشكل أغلبية موظفي الدولة.
أي أن زيادة الألف درهم الموعودة خلال أكثر من عام من الآن، لن تشمل سوى أقل من نصف الموظفين المدنيين للدولة.
أما عن القطاع الخاص، فالأمر لا يعدو أن يكون أكثر من تحسين لمؤشرات توجد على الورق فقط. لأن الأمر لا يتعلّق بزيادات عامة ولا تخفيض حقيقي في الضريبة على الدخل يمكنه أن ينعكس على الأجور الصافية، بل هو مجرد رفع للحد الأدنى للأجور، في الوقت الذي تفيد أرقام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن قرابة 40 في المائة من أجراء القطاع الخاص، يتقاضون أصلا أقل من الحد الأدنى للأجر، المعمول به حاليا.
لو أن الحكومة التزمت بتمكين نصف أجراء المغرب أولا من الحد الأدنى للأجر دون زيادة، لكان الأثر أكبر والفائدة أوضح. وبما أن الأمر يتعلّْق برفع الحد الأدنى من 3100 درهم إلى 3400 درهم شهريا، فتعالوا نبحث عن عدد المعنيين بهذه الخطوة.
تفيد إحصائيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي تضمنها تقريره السنوي الأخير، أن حوالي 780 ألف أجير في القطاع الخاص يتقاضون أجرا يتراوح بين 3000 و4000 درهم.
وسنفترض جدلا وبكل السخاء الممكن، أن 400 ألف منهم، أي أكثر من النصف، يتقاضون أجرا يقل عن 3400 درهم، وبالتالي هؤلاء هم كل المعنيين بقرار الزيادة في الحد الأدنى، دون الحديث عمن سيلتحقون منهم بفئة الذين يتقاضون أجرا أقل نمن الحد الأدنى القانوني، والذين يقارب عددهم المليوني أجير.
باحتساب جميع المعنيين بالزيادات المعلنة في الأجور، بمن في ذلك الموظفين العسكريين وشبه العسكريين الذين ينبغي بكل تأكيد أن يكونوا في مقدمة المستفيدين بما أنهم لا يستطيعون ممارسة الاحتجاج النقابي، فإننا نكون أمام أقل من مليون مغربي، سيحصلون على زيادات تدريجية في الأجور في أفق العام 2026.
في حقيقة الأمر، هناك تحفّظ لابد من تسجيله قبل استعمال كلمة الزيادة، لأن الأمر يتعلّق في الواقع بتعويض جزئي لانخفاض كبير في القدرة الشرائية لجميع المغاربة وقع في العامين الأخيرين، بما أن معدل التضخم تجاوز في بعض الأوقات العشرة في المئة، وبات المغربي مطالبا بدفع مقابل مضاعف في كثير من الأحيان، للحصول على بضائع وخدمات أساسية.
كما أن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الأخيرة التي أعلنتها مؤسسات رسمية، تقول إن معدل البطالة في ارتفاع، والقادم أسوأ بفعل غياب بوادر إقلاع حقيقي في معدل النمو خلال ما تبقى من ولاية هذه الحكومة.
وحتى الفتات الذي تم تقديمه لبعض الفئات كدعم اجتماعي مباشر، جاء في مقابل سحب أشكال أخرى من الدعم مثل تيسير و”راميد” ودعم الأرامل، ودعم المقاصة الموجه لغاز الطهي…
تماما مثلما جاءت زيادات الحكومة والباطرونا في أجور بعض الموظفين والأجراء، في إطار صفقة إذعان كبيرة وغير مسبوقة، حصلت بموجبها الحكومة على موافقة مسبقة من النقابيين المتقاعدين لتمرير إصلاحات التقاعد التي لا تعني في النهاية سوى اقتطاعات جديدة من الأجور وعمل لسنوات إضافية ونيل معاشات أقل، وتمرير تشريعات خطيرة وحساسة تتعلق بالنقابات والإضراب…
أي أن الحكومة “اشترت” ما لا يباع ممن لا يملك، بينما البعض مصرّ على إرغامنا على الضحك والشعور القسري بالسعادة، مصداقا لمقولة إن لم تستطع مقاومة الاغتصاب فاستمتع به.
ذكرني ما يحصل بمقال كتبه الزميل سليمان الريسوني، فكّ الله سجنه، في سياق آخر لكنه نُشر تزامنا مع ذكرى فاتح ماي قبل ست سنوات، واختار له عنوان “صباغين الحمير”.
ما نعيشه اليوم لا يكاد يختلف عن تلك الممارسة المتداولة في التراث الشعبي، لمن يشتري من الرجل الراغب في استبدال دابته بأخرى أفضل، حماره المعروض للبيع في السوق، ثم يعمد إلى صباغته ثم يعيده إلى السوق ليبيعه لصاحبه الأصلي، والذي يعود إلى بيته فرحا بدابته “الجديدة”، بينما هو في الواقع اشترى حماره لكن بثمن أكبر من ثمن بيعه، والفرق الوحيد هو أنه طلي بصباغة سرعان ما ستزول ليكتشف الحقيقة المرة.