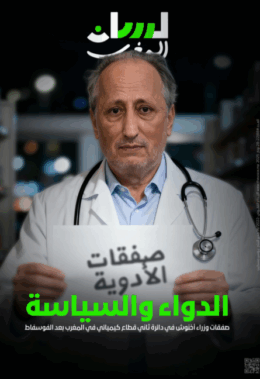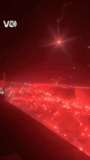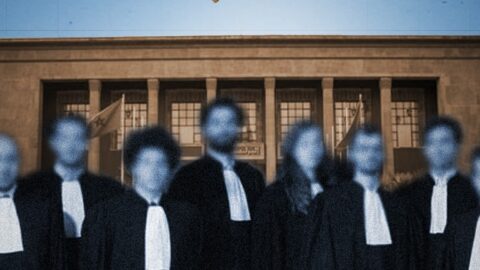سعيد الصديقي يكتب: تعامل المغرب ببرغماتية مع تطور النظام الدولي منذ اعتلاء الملك محمد السادس الحكم

خصّ أستاذ العلاقات الدولية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، سعيد الصديقي، العدد الخاص من مجلة “لسان المغرب” الصادر بمناسبة الذكرى 25 لوصول الملك محمد السادس إلى الحكم، بمساهمة هذا نصها الكامل:
تسلم الملك محمد السادس مقاليد الحكم بالمغرب بعد عقد من الزمان تقريبا من سقوط جدار برلين. وفي أوج نظام الأحادية القطبية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية الذي لم يكن يسمح بهامش واسع للمناورة، خاصة بالنسبة للدول الصغيرة والمتوسطة.
بعد أقل من سنتين من تسلّمه الحكم، ستقع أحداث 11 سبتمبر 2001، وما تلاها من ضغوط على الدول الإسلامية في ظل أجواء شعار الرئيس الأمريكي الأسبق، جوج بوش الابن: ”من ليس معنا، فهو ضدنا“.
هذا النظام الدولي المفرط في أحاديته، والتحديات الاقتصادية والاجتماعية الداخلية الثقيلة، جعل صانع القرار الخارجي بالمغربي ينأى بنفسه عن القضايا الدولية -بما في ذلك بعض القضايا الإقليمية التي كانت فيها للدبلوماسية المغربية الريادة في العهد السابق- والتركيز على المبادرات الداخلية.
لكن”الحرب الدولية على الإرهاب“، أرخت بظلالها على الساحة الداخلية، وشوشت إلى حد ما على الآمال المعلقة على المرحلة الجديدة. لكن بعد سنوات قليلة سينمو نفوذ قوى دولية أخرى تدريجيا، وتظهر ملامح نظام دولي متعدد الأقطاب، ليفسح المجال أمام المغرب ليتحرر تدريجيا من قيود الحرب الباردة والأحادية القطبية. لذلك يمكن الحديث عن مرحلتين في تدبير السياسة الخارجية المغربية في عهد الملك محمد السادس:
المرحلة الأولى هي الفترة الثانية من نظام الأحادية القطبية، أي بعد بلوغ هذا النظام قمته مع بداية الألفية الجديدة. وقد تميزت هذه المرحلة بتحديات أمنية وسياسية كثيرة، ضيّقت إلى حد ما من هامش المناورة لاسيما الدول الصغيرة والمتوسطة.
شهدت هذه المرحلة أحداثا كبيرة مثل 11 سبتمبر 2001، والغزو الأنجلو-أمريكي للعراق ابتداء من مارس 2003، والانتفاضة الفلسطينية الثانية… ولم تكون هذه المرحلة في اتجاه خطي ثابت، بل كانت فيها للمغرب فرص خاصة على المستوى الاقتصادي، ولاسيما مع حلفائه الغربيين، مثل اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي التي دخلت حيز التنفيذ في 2000، وباقي الاتفاقيات القطاعية اللاحقة المرتبطة بها، واتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة (وقعت في 2004 ودخلت حيز التنفيذ في 2006). وبالمقابل، شابت هذه المرحلة خلافات وشد وجذب مع شركائه. لكن عموما، حافظ المغرب إلى حد ما على قواعد السياسة الخارجية المغربية التقليدية، وتعامل مع ضغوط وتحديات هذه المرحلة بواقعية وبرغماتية.
يمكن القول أن حضور المغرب وتأثيره تراجع نسبيا خلال هذه الفترة. وقد ساهمت أيضا، بالإضافة إلى طبيعة النظام الدولي في ذلك الوقت، شخصية الملك الجديد والرهانات الداخلية، في التقليل من النشاط الدولي للمغرب، مقابل التركيز على القضايا الداخلية، لاسيما في ملف الإنصاف والمصالحة والمبادرات الاجتماعية.
أما المرحلة الثانية فتتزامن مع الولاية الأولى لباراك أوباما في البيت الأبيض، حيث بدأ العالم يشهد تدريجيا تنامي قوى دولية جديدة مقابل تباطؤ النفوذ الأمريكي. ستسمح البيئة الدولية الجديدة متعددة الأقطاب للمغرب بتطوير سياسته الخارجية، التي يمكن رصد أهم ملامحها في ما يلي:
أولا، السعي لتنويع الشركاء، حيث دخل المغرب إما في اتفاقات شراكة أو علاقات استراتيجية مع عدد من الدول، لاسيما الصاعدة منها مثل الصين وروسيا والهند وتركيا..
ثانيا: التعامل بندية مع حلفائه التقليديين، ومطالبتهم صراحة بالخروج من المنطقة الرمادية بشأن قضية الصحراء. واتخاذ مواقف واضحة، والرد بسرعة وحزم على مواقف ومبادرات بعض الدول الغربية تجاه قضية الصحراء، كما حدث مع أمريكا في 2013، والسويد في 2015، وإسبانيا وألمانيا في 2021، والبرود الدبلوماسي الحالي مع فرنسا.
ثالثا: تعزيز المغرب لحضوره في بعض الفضاءات الإقليمية المهمة، وعلى رأسها القارة الإفريقية، سواء على مستوى الثنائي بتنمية علاقاته مع العديد من الدول الإفريقية على كل المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية والثقافية… وحصوله على عضوية منظمة الاتحاد الإفريقي التي أصبح فيها فاعلا أساسيا، ودوره النشيط في المساعي لحل بعض النزاعات لاسيما في ليبيا وفي بعض الخلافات السياسية في غرب إفريقيا ومنطقة الساحل، وزيادة استثماراته في إفريقيا، وتقديم أو الانخراط في مبادرات استراتيجية مثل مبادرته الأطلسية لتمكين دول الساحل الحبيسة من الولوج إلى المحيط الأطلسي، وانضمامه إلى المبادرة الأمريكية ”الشراكة من أجل التعاون الأطلسي“ …
يمكن القول إن المغرب تعامل ببرغماتية مع تطور النظام الدولي منذ اعتلاء الملك محمد السادس الحكم. ولعل هذه السلاسة في التكيف مع تغير بنية النظام الدولي يعود إلى كون المغرب دولة” النظام الواقع“على المستويين الإقليمي والدولي، حيث يعمل دائما على الحفاظ على موقعه في النظامين الإقليمي والدولي، وتنمية مصالحه، لكن مع الحرص على عدم إحداث تغيير جوهري في الوضع القائم أو إخلال في توازن القوى الإقليمي.
يبدو أن هذه الاستراتيجية هي الأسلم والأكثر واقعية للمغرب في هذه المرحلة، نظرا لأن قدراته تتساوى نسبيا مع قدرات دول محيطه الإقليمي القريب، ولا يمكن لأي دولة أن تكون مهيمنة أو قائدة فيه.