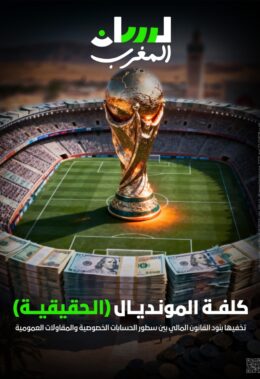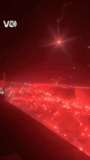حق النسب والعمل المنزلي.. خبراء يناقشون أبرز تعديلات مدونة الأسرة

في سياق النقاش المستمر حول التعديلات المرتقبة على مدونة الأسرة، نظّم رواق وزارة العدل، يوم الجمعة 18 أبريل 2025، ندوة فكرية ضمن فعاليات الدورة الثلاثين للمعرض الدولي للنشر والكتاب، تحت عنوان: “مدونة الأسرة بين الواقع والمستجدات التشريعية: مقاربة تحليلية”.
حق النسب
في هذا السياق، اعتبرت زهور الحر، المحامية بهيئة الدار البيضاء، أن الدفاع عن حق الطفل في النسب داخل مدونة الأسرة يمثل مسألة جوهرية تتعلق بكرامته ومكانته في المجتمع، إذ لا يُختزل في رابطة قانونية فقط، بل يُعد جزءاً أساسياً من هوية الطفل وانتمائه، ويُعتبر من أهم ثمار العلاقة الزوجية، مشددة على أن مصلحة الطفل يجب أن تُقدَّم على أي اعتبار، بعيداً عن النزاعات المرتبطة بوضعية الزواج.
وأوضحت الحر، خلال مداخلتها بالندوة، أن المغرب صادق على عدد من الاتفاقيات الدولية، من بينها المادة 8 من اتفاقية حقوق الطفل، التي تكرس حق الطفل في الحفاظ على هويته، كما أشارت إلى مقتضيات قانونية داخل مدونة الأسرة، من بينها المادة 54، التي تنص على حماية نسب الأطفال المولودين خارج إطار الزواج.
غير أن الممارسة القضائية، حسب الحر، ما زالت تكشف عن العديد من الثغرات، لا سيما حين تُستبعد وسائل علمية دقيقة في إثبات النسب، كاختبارات الحمض النووي (الخبرة الجينية)، حيث أكدت أن هذه الخبرة، رغم قوتها العلمية، لا تُعتمد في عدد كبير من المحاكم، معتبرة أنه “من غير المنطقي تجاهل وسيلة علمية ثبتت فعاليتها في قضايا تمس بشكل مباشر مستقبل الطفل وهويته”، متسائلة “كيف يُحرم طفل من نسبه رغم وجود دليل علمي يثبته؟”
وفي هذا الإطار، دعت الحر إلى مراجعة مدونة الأسرة لسنة 2004، التي “لم تعد تواكب التحولات التي يشهدها المجتمع، كالعزوف عن الزواج والخوف من المسؤولية، وهي عوامل ساهمت في تفكك عدد من الأسر”، وشددت على أن معالجة هذه الإشكالات يجب أن “تتم في إطار يحفظ الأسرة ويحمي القيم الإسلامية المغربية”، داعية إلى “تجديد الاجتهاد الفقهي والقانوني بما يراعي التطورات المجتمعية ويصون كرامة كل الأفراد”.
تثمين العمل المنزلي
ومن جهتها، تطرقت بثينة الغبزلوري، أستاذة التعليم العالي، إلى موضوع تثمين العمل المنزلي، الذي يطرح بدوره نقاشا كبيرا فيما يتعلق بمدونة الأسرة، حيث أكدت على أن العمل المنزلي، هو نشاط اقتصادي غير مدفوع الأجر، تؤديه غالباً النساء “دون اعتراف رسمي بمساهمتهن الجوهرية”، حيث أشارت إلى أن هذا العمل يُعامل في الغالب كـ”أمر بديهي، لا يستحق التقدير أو الاعتراف”، رغم كونه جزءاً أساسياً من الحياة اليومية للأسر والمجتمعات.
وفي هذا الإطار، أكدت المتحدثة على ضرورة تثمين هذا النوع من العمل، بالنظر إلى أبعاده الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، إذ يساهم في الناتج القومي وفي استقرار الاقتصاد، وأضافت أنه “لو توقفت النساء عن أداء هذا الدور، لتطلب الأمر تدخل الدولة وتخصيص ميزانيات ضخمة لتعويض تلك الخدمات”، وهو ما يبرز ضرورة الاعتراف به كمكوّن اقتصادي فعّال.
وعلى المستوى الاجتماعي والنفسي، شددت على أن البيئة المتوازنة التي تخلقها النساء داخل البيت تمثل ركيزة للاستقرار الأسري والمجتمعي، لكن في المقابل، أشارت إلى أن تقديم المرأة لهذا العطاء دون مقابل مادي أو حتى معنوي “يترك آثاراً سلبية على تقديرها لذاتها ويُعمّق شعورها بالإحباط والتهميش”.
مقترحات لم تنل نصيبها
من ناحية أخرى، أكدت قلوب فيطح، محامية بهيئة المحامين بطنجة ونائبة برلمانية، على أهمية عدد من التعديلات التي لم تنل نصيبها الكافي من النقاش، رغم ما تحمله من قيمة كبيرة، وعلى رأسها، ذكرت مقترح إحداث هيئة غير قضائية تُعنى بالصلح والوساطة، يكون دورها محصوراً في محاولة الإصلاح بين الزوجين وتوثيق ما يتم الاتفاق عليه بخصوص ترتيبات الطلاق، دون أن يكون لها طابع قضائي، معتبرة أن هذه الهيئة تمثل بديلاً فعّالاً عن الصلح الشكلي المعتمد حالياً داخل المحاكم، الذي يعاني من “ضعف الموارد البشرية واللوجستيكية”.
وأشارت فيطح إلى أن هذه الهيئة من شأنها أن تسهم في تعزيز تماسك الأسرة وحماية حقوق جميع أفرادها، لما توفره من بيئة مناسبة لحل الخلافات بعيداً عن أجواء التقاضي، وأضافت أن “اقتصار دورها على الوساطة دون سلطة قضائية، يجعلها أكثر مرونة في التعامل مع الحالات الأسرية الحساسة، ويساهم في تقليل الضغط على المحاكم وتفادي الإجراءات المعقدة التي قد تُفاقم الوضع بين الطرفين”.
وفيما يتعلق بزواج القاصرات، شددت فيطح على أهمية مقترح رفع سن الزواج إلى 18 سنة، من أجل حماية الفتيات من الزواج المبكر وما يترتب عنه من مخاطر صحية واجتماعية، كما أكدت أن الاستثناء المسموح به في سن 17 يجب أن يكون محكوماً بشروط صارمة، وتحت رقابة قضائية دقيقة، حتى يظل فعلاً استثناء وليس قاعدة معمول بها.
كما أكدت المتحدثة على أهمية مقترح تمكين الأم الحاضنة من الولاية القانونية على أطفالها خلال فترة الحضانة، خاصة فيما يتعلق بالإجراءات الإدارية والتربوية والصحية، وأوضحت أن هذا التمكين يجب أن يتم دون الحاجة إلى إذن مسبق من الأب أو اللجوء المتكرر إلى القضاء، لما يشكله ذلك من “عبء على الأم وعرقلة لمصلحة الطفل”.