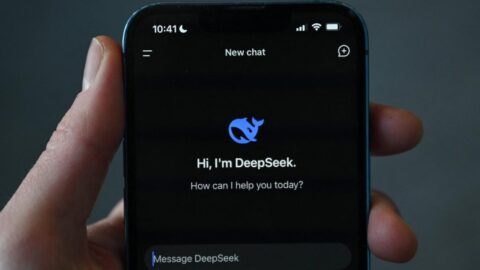حرّاس الذل!

كما لو أن التاريخ يعيد نفسه، ابتلينا اليوم بزمن نضطر فيه إلى الدفاع عن حق المقاومة في الوجود أمام من يُفترض أنهم بنو جلدتنا!
كأننا في سوق نخاسة، نقف لنبرر وجودنا لمن لا يعرفون من الوطن إلا اسمه، ويكتفون بإلقاء اللوم على الضحية كلما رفعت رأسها ورفضت الخضوع.
قرأت لبعض الفضلاء محاولات للحجاج والاستدلال على أن المطلوب ممن يشاهد من بعيد، أن يدافع عن الموقف، وعن المبدأ، وعن الضمير.
حاولوا أن يشرحوا لهم كيف أن إسرائيل قتلت وذبّحت قبل أن تولد حماس أو يولد حزب الله.
ناشدوهم أن يتأملوا كيف تمارس الإبادة والتهجير في الضفة حيث لا تحكم ولا تسيطر حماس…
لكنك كنت أسمعت لو ناديت حيّا..
مضحك هو الحال حين تضطر أن تشرح لأبناء جلدتك أن الدفاع عن البيت حين يُهاجَم ليس شغباً أو تهوّرا أو إثارة للفوضى، بل هو واجب وشرف لا يسقط بالتقادم.
عجبي ممن يستغربون مقاومة الفلسطينيين واللبنانيين، ويُلقون علينا محاضرات في الأدب و”ضبط النفس” كأن ذلك الشاب الذي يخرج من النفق ليعانق الدبابة حاملا عبوة ناسفة، وهو يعلم علم اليقين أن خيمة أهله في المخيّم ستٌقصف، لم يكن ليفعل ذلك لولا أنه صادف تدوينة لمواطن مغربي يحيي شجاعة المقاومين!
لا يدرك المتخلّفون أنهم يخطئون العنوان، لأن من نذروا حياتهم للمقاومة لم يولدوا كي يقنعوا العالم بعدالة مقاومتهم، بل ولدوا كي يكتبوا بدمائهم قصيدة الحرية التي تعيد رسم العالم وفق أبجدياتهم، لا وفق منطق استسلام وتخاذل من لا يُطلب منهم مال ولا دم، بل مجرد موقف محترم.
يطالبنا البعض بالجلوس كأننا في أمسية ثقافية نقرأ الشعر على وقع قصف الطائرات ودوي الصواريخ!
يريدون منا أن نُهذّب مواقفنا، وأن نحلق ذقون الثوار، وأن نرتدي قفازات ناعمة حين نناقش حقهم في الحياة والكرامة، لأن “اللباقة” هي المطلوبة في زمن الخضوع!
يحق لمن لا يقاوم ولا يرفع صوته ضد من يساوم، أن ينضم إلى صفوف النائمين في أسرّة التخاذل المريح.
يمكنهم البقاء في سكونهم، وليتركوا الآخرين يعيدون صياغة المعاني من جديد، ويعرّفون العالم أن الكرامة لا تُقاس بحسن السلوك أمام الطغاة، بل بقدرتك على الصراخ في وجههم حتى وأنت محاصر بالقيود.
أقصى درجات السخرية السوداء أن يطالب البعض الضحية بحسن السلوك أمام جلادها، وأن يسخّروا أنفسهم لخدمة سردية الظالم، ويمكّنوا الظلم من أن يتجرأ على تغيير الحقائق حتى يحتفظ بوجهه القبيح مستتراً خلف قناع العدالة الزائف.
أن تُطالب الضحية بحسن السلوك أمام جلادها كأن تُطلب من الأرض أن تخفي جراحها، وتفرض على البحر أن يكتم هديره في ليلة العاصفة. هو أن تُخضع الضحية لمنطقٍ منحرف يرى أن الألم الذي يُعانيه يجب أن يكون مقبولاً ولائقًا، حتى لا يزعج مسامع من اعتادوا على مشاهدة الجثث كجزء من روتين حياتهم اليومي.
إنهم يطلبون من الضحية أن تنسى حقوقها، أن تتعلم دروس الذل وأن تصفق للطغاة، وكأن الرحمة تأتي من يد تحمل السوط. هذا المنطق القاسي هو من يحاول إعادة صياغة التاريخ ليجعل من القاتل بطلاً ومن الضحية متسولاً على عتبات العدل.
يريدون ضحايا مقبولة، لا ترفع أصواتها حين تُضرب، ولا تصرخ حين تُذبح.
كأني بهم لم يسمعوا كيف كان عبد الكريم الخطابي، بصلابته وإيمانه بعدالة قضيته، تجسيداً للرفض المستمر للهزيمة.. وكيف ظل حتى بعد نفيه، صوتا يلهم الثوار عبر البحر، ليصل صداه إلى كل من يحمل في قلبه رغبة في الكرامة والحرية.
كأنهم لم يقرؤوا عن عسو أو بسلام الذي قاد المقاومة ضد الفرنسيين في جبال الأطلس الشرقي، ووقف في معركة بوكافر عام 1933، رفقة رجاله الحفاة، مسلحين بإرادة لا تعرف الخنوع، ضد جيش فرنسي مدجج بالسلاح والطائرات.
كأني بالانهزاميين لم يعرفوا موحا أوحمو الزياني، القائد الذي حوّل جبال الأطلس إلى معاقل للثوار ضد القوات الفرنسية. وحقق رفقة الزيانيين في معركة الهري عام 1914، نصرا تاريخيا ضد القوات الفرنسية رغم أنهم كانوا يعانون من نقص في العتاد والعدد.
هؤلاء رجال قاوموا بقوة عقيدتهم وبإيمانهم بحقهم في الحرية والكرامة، وصمدوا لسنوات في وجه جبروت الاستعمار الفرنسي، يرفعون إلى اليوم بذكراهم، راية الحرية في كل زقاق وكل واد.
يا دعاة الاستسلام.. يا من تذرفون دموع التماسيح على جثث الأطفال كأنها وليدة السابع من أكتوبر.. يا من حوّلتم مشهد الموت إلى فرصة للبكاء المجاني، ولتبرير الاستسلام والترويج لثقافة الخنوع.. لا لفضح الجريمة.
أين كنتم عندما كانت جثث الأطفال تُركل في شوارع غزة والقدس والخليل قبل أن يسمع العالم باسم طوفان الأقصى؟ أ
ين كانت دموعكم عندما كان الاحتلال يمارس أبشع صنوف الإبادة، ويهدم البيوت على رؤوس ساكنيها بلا رادع؟
الإبادة تُمارس بلا هوادة منذ عقود، والتهجير سياسة ممنهجة، والموت يتحول إلى رقم آخر في سجلات الظلم.
كفوا عن البكاء الكاذب، فالشهداء ليسوا ضحايا هجوم أو مقاومة، بل هم ضحايا احتلالٍ لم يعرف يوما طريقا للرحمة.
لا تنظروا إلى الدمار وترفعوا أصابع الاتهام إلى المقاومة، وكأن لسان حالكم يقول إن القتل مشروع إذا لم تكن هناك حجارة تتطاير من أياد عارية.
ألم تتعلموا من التاريخ أن المستسلمين أول من يُداسون في النهاية؟ وأن من يرضخ لسطوة الظالم لن يسلم من سوطه؟
ألم تقرأوا، يا حرّاس الذل، في سيرة الأبطال الذين واجهوا المستعمرين في جبال الريف والأطلس والصحراء، كيف أن الصمود لا يُقاس بحجم العتاد، بل بصلابة الموقف؟