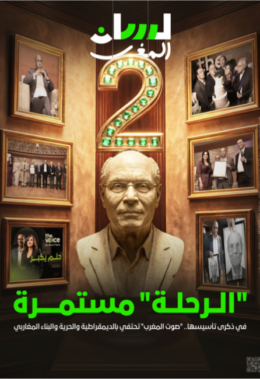حراك جيل زد المغربي: هبة عابرة أم عاصفة هادرة؟.. تأملات هادئة في حالة متحركة

لم تكن شوارع المغرب في خريف 2025 مسرحًا لغضبٍ عابر، بل لولادةِ وعيٍ جديدٍ يُعيد صياغة علاقة الشباب بالدولة والسلطة والمعنى. فجأة، كسر جيلٌ تربّى على الشاشات جدار الصمت، وخرج يحمل هاتفه كما لو كان رايةً، يهتف بلغةٍ لم تعرفها الأحزاب ولا الإعلام. لم تكن الحكاية عن ارتفاع الأسعار ولا عن أزمة خدمات، بل عن أزمة ثقة، عن جيلٍ يرى وطنه يُدار بمنطق الماضي بينما يعيش هو في زمن المستقبل.
في تلك اللحظة، بدا أن المغرب لا يواجه أزمةً اجتماعية فحسب، بل مراجعة تاريخية لجوهر العقد الوطني. وحين رفرف هاشتاغ #GenZ212 فوق الساحات، لم يكن مجرد شعار، بل إعلانًا عن ميلاد جيلٍ يرى الإصلاح فعلًا من تحت لا من فوق، ويطالب بدولةٍ تُدار بالضمير قبل الإدارة. من هنا يبدأ السؤال الذي يهزّ الوعي العربي:
هل ما نراه في المغرب هبّةٌ عاطفية عابرة، أم عاصفة هادرة ستغيّر وجه السياسة في المنطقة بأسرها؟
فما بدأ كغضبٍ مغربي محدود تحت شعار #GenZ212 سرعان ما بدأ يتجاوز الحدود الافتراضية، ليُثير في كل عاصمة عربية السؤال ذاته: فهل يمكن أن تنتقل هذه العدوى؟
جيلٌ عربي كامل يتأمل ما يجري في الرباط والدار البيضاء ومراكش، كما كان جيلٌ سابق يتأمل ما جرى في تونس عام 2011.
لكن الفارق هذه المرة أن الشرارة ليست سياسية بل أخلاقية، لا تنادي بإسقاط الأنظمة بل بإصلاح الإنسان والعقد الاجتماعي.
في المغرب، ولد جيلٌ يرى في ذاته وعيًا عربيًا جديدًا: جيلٌ لا يثور ليحرق، بل ليُعيد تعريف الوطن والكرامة والمعنى.
ومن هنا يبدأ السؤال الاكبر: هل سيبقى هذا الحراك محليًا، أم أنّه بداية موجة وعيٍ عربية ثانية تتسلّل من الرباط إلى بغداد، ومن عمّان إلى الخرطوم، بهدوءٍ لا يقل زلزلة عن ربيعٍ مضى؟
وقبل الدخول في تفاصيل الرصد والتحليل، ينبغي التذكير بأنّ هذا الحراك لا يزال في طور التشكّل والتفاعل، ولم يبلغ بعدُ مرحلته الناضجة أو المستقرة. ومن ثمّ، فإنّ القراءة التالية تستند إلى المؤشرات الدالة التي ظهرت حتى الآن، وتتعامل معها بوصفها إشاراتٍ أولى على وعيٍ جماعيٍّ آخذٍ في التكوّن. كما أنّ مقاربة هذا الحراك لا تُبنى على أدوات السياسة التقليدية، بل على التحليلين الاجتماعي والسيميائي، الذين يتيحان فهمه، كظاهرةٍ رمزيةٍ، تعبّر عن تحوّلٍ في القيم والخيارات، لا كمجرّد حركةٍ ذات خلفيةٍ سياسيةٍ محددة. فمهما تكن السياقات أو الدوافع الكامنة وراءه، يبقى هذا الحراك، في جوهره، تعبيرًا حقيقيا، عن لحظةٍ اجتماعيةٍ حقيقية، تستمدّ مشروعيتها من راهنيتها ومصداقيتها، لا من القوى التي تحاول تأويلها أو توظيفها.
أولا: سياق حراك جيل زد:
قبل أن نقرأ ما يفعله جيل زد، علينا أن نفهم ما ورثه. فلا يولد الحراك من فراغ، ولا تنفجر المجتمعات صدفة؛ بل حين تتراكم الخيبات في الطبقات العميقة من الوعي الجمعي، ويصبح الصمت نفسه شكلاً من أشكال العصيان. من هنا، لا يمكن فهم ما جرى في سبتمبر 2025 دون العودة إلى المسار الطويل الذي أعاد تشكيل علاقة المغاربة بالدولة، وبالرمز، وبالمستقبل — مسار بدأ منذ الربيع المغربي سنة 2011، ومرّ بمحطات الإصلاح الدستوري، ثم خيبة الانتظار، وصولًا إلى لحظة التطبيع سنة 2020 التي فجّرت شرخًا رمزيًا عميقًا في الوجدان الوطني.
1. السياق العام: من الربيع المغربي إلى توقيع التطبيع:
منذ الربيع المغربي عام 2011، عرفت البلاد ما سُمّي حينها بـ”الاستثناء المغربي”، حيث تمكنت الدولة من امتصاص موجة الغضب عبر إصلاح دستوري سريع أُعلن في يوليوز من تلك السنة، بدا وكأنه تعاقد جديد بين الملكية والمجتمع. لكن سرعان ما اكتشف المواطن أن ما تغيّر في النص لم يتغير في الواقع؛ فالقوانين بقيت فوق الإرادة الشعبية، والسلطة الحقيقية ظلت في أيدي الدوائر ذاتها، بينما عادت النخبة الحزبية إلى لعب دورها القديم في تزيين الواجهة الديمقراطية دون أن تمسّ جوهر المخزن أو هندسة السلطة..
تدريجيًا، نشأت حالة من الانفصال الوجداني بين الأجيال: جيل الإصلاح الذي صدّق الوعود الدستورية، وجيل جديد لم يرَ من الإصلاح سوى ارتفاع الأسعار وتراجع الخدمات وتفاقم اللامساواة. وما بين الجيلين، تحوّل “الاستثناء المغربي” من نموذج للمرونة السياسية إلى قناع يخفي بنية الجمود.
ثم جاءت اتفاقية التطبيع مع إسرائيل في ديسمبر 2020 لتفتح جرحًا رمزيًا عميقًا؛ فبالنسبة لقطاع واسع من الشباب، لم تكن مجرد خطوة دبلوماسية، بل انفصامًا بين خطاب الدولة وهويتها التاريخية. منذ تلك اللحظة، بدأ يتبلور وعي جديد يعتبر أن النظام السياسي لم يعد فقط متواطئًا مع النخب الريعية، بل أيضًا منفصلًا عن الضمير الجمعي للأمة. لقد كان التطبيع بمثابة النقطة التي انكسر عندها الإيمان بقدرة النظام على تمثيل القيم التي نشأ عليها المغاربة — العدالة، الكرامة، والانتماء للقضية الفلسطينية كجزء من الذات الوطنية..
وهكذا، فإن حراك جيل زد لا يمكن قراءته كغضبٍ اجتماعي فقط، بل كارتدادٍ تاريخي متأخر على عقدٍ اجتماعي أُبرم ثم أُخلف، وعلى وعود إصلاحٍ صيغت بلغة المستقبل لكنها صُرفت بعملة الماضي.
2. السياق الخاص: من التطبيع إلى 27 سبتمبر
منذ توقيع اتفاقية التطبيع في ديسمبر 2020، دخل المغرب مرحلة جديدة من التوتر الهادئ بين الدولة الرسمية والمجتمع العميق. فبينما كانت السلطة ترى في الخطوة تحولًا استراتيجيًا نحو انفتاح إقليمي وتعاون اقتصادي، قرأها الشباب بوصفها خيانة رمزية للقيم الوطنية، وتحوّلًا جذريًا في هوية الدولة من فاعل متضامن إلى كيان براغماتي يبحث عن موقعه في خريطة المصالح..
في السنوات التالية، تزامن هذا التحول مع تفاقم الأزمات البنيوية: انكماش اقتصادي حاد بسبب تداعيات الجائحة، تضخم أسعار غير مسبوق، انهيار الثقة في الخدمات العامة، واستمرار شبكات الريع في احتكار الثروة والقرار. على السطح، كانت الدولة تروّج لصورة “المغرب الصاعد” مشاريع ضخمة، سباق نحو المونديال، طموحات تكنولوجية، واستثمارات عابرة للقارات. لكن تحت هذا اللمعان، كانت الهوة الاجتماعية تتسع: شباب عاطلون بلا أفق، طبقات وسطى تتآكل، ومناطق مهمّشة تعيش وكأنها خارج الزمن الرسمي..
لقد كان جيل زد يراقب هذا المشهد بعيون رقمية لا تخدعها اللغة الرسمية. جيل لا يتلقى الأخبار من القنوات العمومية بل من تيك توك وإنستغرام؛ يرى التناقض بين الاحتفاء بالبنية التحتية الحديثة وصور المستشفيات المتداعية، وبين الوعود بالعدالة الاجتماعية وقصص الفساد المتكررة التي تملأ الفضاء الرقمي. هذا التناقض ولّد شعورًا جماعيًا بالمهانة: أن الدولة تملك كل شيء إلا الحسّ بالمواطنة.
ثم جاء يوم حادثة وفاة ثماني نساء أثناء الولادة في مستشفى أغادير. لم تكن حدثًا صحيًا فحسب، بل كانت القشة التي عرّت هشاشة المنظومة كلها: منظومة الصح و الإدارة والمحاسبة.. بل والمنطق الذي تُدار به البلاد. من ذلك اليوم، لم يعد انفجار الاحتجاج إلا مسألة وقت، لحقق شباب جيل زد صرخته وجودية التي تعبّر عن جيل قرر أن يطالب ليس فقط بخدماته، بل بمعناه داخل الوطن.
تحت شعار بسيط وموحّد، GenZ 212، انطلقت الشرارة من العالم الرقمي إلى الشارع الواقعي، معلنة أن الزمن الذي كانت فيه الدولة تحتكر الخطاب قد انتهى، وأن السلطة الرمزية لم تعد في يد المخزن، بل في يد جيل يملك لغة جديدة، وإيقاعًا جديدًا، ومخيالًا جمعيًا يتجاوز الخوف.
ثانيا: جيل زد: التشكل والطبيعة والمطالب:
لم يكن جيل زد الذي فجّر الحراك المغربي جيلًا غاضبًا بالمعنى الكلاسيكي للثورات، بل جيلًا يبحث عن انسجامٍ بين ما يراه وما يعيشه. جيلٌ تربّى في فضاءٍ رقمي لا يعترف بالحدود، وتكوَّن وعيه في زمنٍ تراجع فيه دور المدرسة والأسرة والحزب، بينما تمدّدت المنصة لتصبح عالمًا موازيًا يُنتج القيم والمعنى والهوية.
هكذا نشأ جيلٌ لا ينتمي إلى الماضي ولا يتصالح مع الحاضر، بل يعيش في برزخٍ بين الواقعي والافتراضي، بين الوطني والعالمي، بين الفردي والجماعي. لكن ما يميّز هذا الجيل ليس فقط لغته الجديدة أو أدواته، بل طبيعته المركبة التي تجمع بين الحسّ الجمالي والوعي الأخلاقي، بين الانفتاح الشديد والقلق الوجودي العميق.
إنه جيلٌ يطالب بالدولة التي تُشبهه: شفافة كالإنترنت، سريعة كالخبر، ومسؤولة كالضمير. ومهما بدت مطالبه مشتّتة بين التعليم والعدالة والمناخ والحرية، فهي في جوهرها مطلبٌ واحد: أن يُعامَل الإنسان العربي ككائنٍ عاقلٍ في زمنٍ رقميٍّ لا يحتمل الزيف.
بهذا المعنى، لا يمكن فهم حراك جيل زد المغربي دون تفكيك هذا الجيل ذاته: كيف تشكّل؟ ما الذي يحرّكه؟ وما الذي يريده حقًّا حين يقول “كفى”؟ من هنا يبدأ السؤال الثاني في مسار التحليل: من هو جيل زد العربي، وكيف تحوّل من مستهلكٍ للتكنولوجيا إلى منتجٍ للوعي الجماعي الجديد؟
1. مراحل التشكّل التنظيمي والرمزي لـ GenZ 212:
لم يولد جيل زد من فراغ، بل من تصدّعٍ طويل في منظومة المعنى. لقد تشكّل وعيه في أربع دوائر متداخلة، لا تفصلها الأزمنة بل تتقاطع فيها التجارب الفردية والجماعية:
1.1. التكوين الرقمي: وهي اللحظة الأولى التي وُلد فيها الجيل داخل الشاشات لا حولها: فمنذ سنوات المراهقة، أصبح العالم بالنسبة له نافذة مضيئة أكثر منه فضاءً واقعيًا. تعلّم من الإنترنت أكثر مما تعلّم من المدرسة، وتكوّنت لغته من التفاعل قبل التلقين. هذه النشأة الرقمية منحته قدرةً استثنائية على الوصول، لكنها أيضًا جعلته يعيش انفصالًا داخليًا بين ما يراه ممكنًا في الشاشة وما يراه مستحيلًا في الواقع.
2.1. الانفتاح القيمي: لم يعد جيل زد يتلقّى قيمه من الأسرة أو المؤسسة الدينية فقط، بل من شبكةٍ كونية تتقاطع فيها المرجعيات. تفتّحت بصيرته على العدالة والمناخ والحرية والاختلاف، لا بوصفها شعاراتٍ سياسية، بل كقيمٍ إنسانيةٍ يعيشها يوميًا. وهذا ما جعله يملك حسًّا عالميًا من دون أن يفقد انتماءه المحلي، فهو جيلٌ مغربيٌّ بعمقٍ عربيٍّ، وإنسانيٌّ في الرؤية أكثر من أي جيلٍ سبقه.
3.1. الانكسار الاقتصادي: لقد كبر هذا الجيل في ظل أزماتٍ اقتصادية متكررة، تقلّصت فيها فرص الشغل وتراجعت الثقة في العدالة الاجتماعية. لكنه لم يتحوّل إلى جيلٍ يائس، بل إلى جيلٍ يبتكر مخرجًا رمزيًا من العجز المادي. من هنا ظهرت موجة المشاريع الصغيرة، والمبادرات الرقمية، والعمل الحرّ، كبدائل عن المنظومة الاقتصادية الرسمية التي لم تمنحه مكانه. لقد فهم أن الاقتصاد لم يعد مجرد وظيفة، بل قدرة على إنتاج القيمة.
4.1. التحفّز الأخلاقي: في هذه المرحلة، بدأ جيل زد يدرك أن مشكلته ليست مع السلطة فقط، بل مع الزيف الجمعي. من الإعلام إلى السياسة إلى الخطاب الديني، تكرّس لدى الشباب إحساسٌ بأن كل شيءٍ يُقال لا يُصدَّق. ومن هنا انبثقت الحاجة إلى الصدق كقيمةٍ مقاومة. فكانت الاحتجاجات الأخيرة تعبيرًا عن إرادةٍ أخلاقية أكثر منها سياسية، تسعى إلى إعادة المعنى لا إلى الاستيلاء على السلطة.
2. طبيعة جيل زد: الهوية المزدوجة والوعي المتحوّل:
من الصعب أن نُعرّف جيل زد المغربي بعبارةٍ واحدة، فهو جيلٌ يرفض التعريفات الجاهزة بقدر ما تبرأ من التصنيفات التقليدية. إنه لا يرى نفسه في مرآة الماضي، ولا يطمئنّ تمامًا لصورة الحاضر. جيلٌ يعيش في زمنين في آنٍ واحد: الزمن الواقعي الذي تَحدّه الدولة والمجتمع، والزمن الافتراضي الذي تَحدّه الخوارزميات والحرية المطلقة. هذه الازدواجية لم تُفقده توازنه، بل صاغت منه هويةً جديدة متحوّلة، هويةٌ لا تبحث عن الثبات بل عن المعنى في الحركة. إنه جيلٌ يتكلم لغة العالم ويشعر بوجع وطنه، يستهلك الثقافة الرقمية لكنه يصنع منها رموزه الخاصة، يعيش العولمة كأداة، لا كقدر.
بهذا المعنى، فهو أول جيلٍ عربي يعيد تعريف الوطنية خارج الإطار الترابي الضيق، فالوطن عنده ليس ما يسكنه فقط، بل ما يعبّر عنه ويستطيع الدفاع عنه رقميًا أو رمزيًا.
إن جيل زد ليس متمرّدًا بالمفهوم الثوري، بل ناقدٌ هادئٌ وعميق، يرفض السلطة حين تفقد معناها، لا حين تمارسها. يختبر الأفكار قبل أن يؤمن بها، ويعطي الأولوية للتجربة على الانتماء. فهو لا يتبع زعيمًا، ولا يثق في حزبٍ أو وسيلة إعلام، لكنه يؤمن بفكرة “الحقّ في السؤال” كأقدس أشكال الحرية. في بنيته النفسية، يجمع جيل زد بين الواقعية الباردة والرغبة الدافئة. واقعيٌّ في حساباته اليومية، لكنه مثاليٌّ في تصوراته عن العدالة والكرامة. لا يريد أن يعيش ليتكيّف، بل ليفهم، ولا يطلب الاعتراف من السلطة بقدر ما يطلب الاعتراف بالإنسان داخله.
من هنا تتكوّن طبيعة وعيه الجديد: وعيٌ لا يُدار بالعاطفة ولا يُستدرج بالشعارات، بل ينحاز إلى الحقيقة ولو صادمة، ويفهم الحرية لا كتمرّد بل كمسؤولية. إنه جيلٌ لا يبحث عن بطلٍ خارجي، بل عن معنىٍ داخليٍّ يبرّر وجوده. وهكذا، فإن جيل زد المغربي يمثّل في العمق تحوّلًا معرفيًا في بنية الوعي العربي: انتقالًا من وعي الجماعة إلى وعي الفرد، ومن ثقافة الطاعة إلى ثقافة الحوار، ومن طلب الإنقاذ إلى إرادة الفهم.
3. مطالب جيل زد: من الاحتجاج إلى التأسيس:
لم يخرج جيل زد المغربي إلى الشارع طلبًا للصدقات الاجتماعية، ولا ليكرّر لغة المطالب القديمة عن “العمل والسكن والخبز”، بل خرج لأنّه لم يعد يقبل العيش في فراغ المعنى. لقد ورث من الأجيال السابقة شعاراتٍ كبرى، لكنه لم يرَ لها ترجمة في الواقع، فقرّر أن يبدأ من نقطةٍ مختلفة: من الإنسان نفسه.
لقد أصدر شباب جيل زد المغربي وثيقته الوحيدة لحد الآن، ليوثق مطالبه بشكل مسؤول: هي نتأملها لا نجدها بيانًا احتجاجيًا، بل إعلان نوايا إصلاحية تعيد رسم حدود الثقة بين الدولة والمجتمع. فهي تعبّر في الواقع عن شرطٍ واحدٍ: المصداقية في الحكم والإصلاح. بهذه الوثيقة، يتحول الحراك من صرخةٍ في الشارع إلى مشروعٍ في الوعي، ومن ردّ فعلٍ على الأزمة، إلى مبادرةٍ لصياغة عقدٍ اجتماعيٍّ جديد. وبدون أي مبالغة، يمكن أن نقول: إنه إذا ما أحسن مسؤولو البلاد التقاط هذه اللحظة، فقد تمثل هذه الوثيقة بدايةُ زمنٍ جديدٍ في السياسة المغربية. لتترجم إلى ميثاق وطني شامل، يُعيد تعريف العقد الاجتماعي من داخل الشرعية الدستورية نفسها. خاصة وأن الوثيقة تتبنى الملكية والدستورية والإسلامية والوطنية الجامعة مرجعية للثوابت، والدستور وثيقة تأسيسية.
ترى الوثيقة أن المغرب يعيش أزمة ثقة عميقة، بين المواطن ومؤسسات الدولة، وأنّ هذه الأزمة ليست ناتجة عن نقص القوانين، بل عن فشل في التفعيل. فالفساد، وضعف الخدمات، والبطالة، وتدهور التعليم والصحة، جميعها مظاهر لفجوةٍ بين الخطاب الرسمي والواقع المعيش. ويستشهد النصّ بتقارير وطنية ودولية تثبت تراجع المؤشرات في التشغيل، والتعليم، والصحة، والتنمية البشرية، ليؤكد أن “النموذج التنموي الجديد” الذي أُعلن سنة 2021 لم يتحقق فعليًا بسبب غياب الإرادة والشفافية.
يمكن أن نقسم المطالب التي تتبناها الوثيقة إلى أربعة محاور رئيسية:
- محور مطلب الحقوق والحريات: وتضم المطالبة بتفعيل الحق في التظاهر السلمي، وحماية المحتجين من العنف الأمني. إضافة إلى فتح تحقيقات قضائية مستقلة في الانتهاكات، وإطلاق سراح معتقلي الرأي. ثم ضمان ممارسة الحريات الأساسية كحرية التنظيم، والتعبير، والاختيار الديمقراطي.
- محور الحق في الصحة: ويشمل إصلاح عاجل وشامل للمنظومة الصحية، وتحسين جودة العلاج والخدمات. ثم مراقبة تنفيذ البرامج الحكومية والشفافية في التمويل. إضافة إلى اعتماد تعريف وطني موحد لتغطية التأمين الصحي (TNR) وربط التكلفة الفعلية بقدرة المواطنين.
- محور الحق في التعليم والتكوين هو المطلب الثالث: ويعني بالنسبة لهم تفعيل قانون الإطار 51.17 في التعليم وفق آجال محددة وميزانيات ممولة. ومراجعة المناهج لتشجيع التفكير النقدي والمهارات الرقمية. و عقد ميثاق وطني للتعليم العالي بمشاركة الأساتذة والطلبة والفاعلين. ثم اعتبار التعليم أولوية استراتيجية لتحرير طاقات الشباب وتحقيق العدالة الاجتماعية.
- محور الاقتصاد والعمل والحوكمة: ويشمل إصلاح سوق الشغل لتقليص البطالة، خاصة بين الشباب (36.7% في الفئة 15–24 سنة). وتشجيع ريادة الأعمال، وتبسيط المساطر، وتحفيز الاستثمار المنتج. ثم ترسيخ الشفافية ومكافحة الفساد عبر استقلالية القضاء، وتفعيل المحاسبة، وتجريم الإثراء غير المشروع، وجعل الحكامة الرشيدة شرطًا لأي تنمية مستدامة.
وإذا ما تأملنا في منطق الوثيقة الداخلي، فنجده يعتمد على ثلاث دوائر مترابطة: دائرة الشرعية القانونية، وتستند إلى الدستور والفصول التي تضمن الحقوق (29،31،51،17…).. دائرة الشرعية الأخلاقية، وتربط الإصلاح بالمسؤولية والصدق لا بالمزايدة. ثم دائرة الشرعية التاريخية، وترى نفسها امتدادًا لروح 2011 ولكن بوعيٍ أكثر نضجًا وأقل عاطفية. كل ذلك يجعلها وثيقة جيلٍ إصلاحي لا ثوري، نقدي لا عدمي، واقعي لا استعراضي.
تبقى دلالات الوثيقة في ضوء التحولات الإقليمية، ويمكن رصدها في سياق ما تعيشه المنطقة العربية من أجواء “طوفان الأقصى” والتحولات العربية الكبرى، مما يكتسب الوثيقة بعدًا رمزيًا جديدًا: فهي تعبّر عن عودة القيم إلى صدارة الخطاب الشبابي، الكرامة والحرية والمحاسبة. وتؤكد أن الإصلاح الداخلي هو الوجه المدني للمقاومة الخارجية. بمعنى أن الشباب يعبرون، ولو بشكل غير صريح ومباشر، في إصلاح الدولة المغربية رافدًا من روافد قوة الأمة. ومن هنا يمكن القول إن هذه الوثيقة تشكل النسخة المغربية من الموجة الوعيّة العربية الجديدة التي أعادت فلسطين إلى قلب المعادلة الأخلاقية والسياسية في المنطقة.
وبكلمة واحدة، فالوثيقة، من الناحية السياسية، لا تسقط في خطاب القطيعة بل في خطاب التصحيح. ومن الناحية السوسيولوجية، تعبّر الوثيقة عن جيلٍ مثقّف رقمي، يملك أدوات التعبير الذكية ويخاطب الدولة بلغتها القانونية. ثم من الناحية الرمزية، فتمثل انتقال الوعي من “المطالبة بالحقوق” إلى “المطالبة بالصدق”. وإخيرا من الناحية الاستراتيجية، فهي من المحتمل أن تمثل نواة لتأسيس حركة شبابية جديدة تقوم على الإصلاح من داخل المؤسسات.
ثالثا: ردود الأفعال على الحراك:
ما إن خرج جيل زد إلى الساحات، حتى اهتزّ المشهد المغربي في عمقه، ليس لأنّ الحشود كانت ضخمة، بل لأنّ الخطاب، هذه المرة، جاء من خارج القاموس السياسي المعتاد: فقد كان الاحتجاج بلا وسطاء، والهتاف بلا زعيم، والمطالب بلا حزب. ولذلك وجدت الدولة والأحزاب والنخب والإعلام.. أنفسهم أمام ظاهرةٍ لا يمكن تصنيفها بسهولة، ولا احتواؤها بالأدوات القديمة.
في الأيام الأولى، ساد الارتباك أكثر من الصدام، وتباينت القراءات، بين من رأى في الحراك مجرّد “انفعال شبابي عابر”، وبين من قرأه كـ”جرس إنذارٍ مبكرٍ”، لتحوّلٍ عميقٍ في علاقة الدولة بالمجتمع. وبين هذين الموقفين، تفرّعت مواقف أخرى: ردودٌ رسمية حاولت استيعاب الموجة بلغة الطمأنة، وردودٌ حزبية سعت إلى ركوبها أو تبريرها، وردودٌ مدنية وحقوقية رأت فيها لحظة وعيٍ لا ينبغي خنقها.
لقد كشف الحراك المغربي أنّ الدولة لم تعُد الفاعل الأوحد في المشهد، بل أصبحت تواجه مجتمعًا متعدّد الأصوات والوسائط والمطالب، ما جعل ردود الأفعال عليه مرآةً حقيقيةً للانقسام العميق، بين من يخاف التغيير ومن يراه خلاصًا.
من هنا، يصبح تتبّع ردود الأفعال على هذا الحراك ليس مجرّد رصدٍ سياسي، بل قراءة في في الوعي المتحرك الآن عند المجتمع والسلطة كليهما: كيف فهم كل طرفٍ الرسالة، وكيف عبّر عن خوفه أو أمله فيها.
1. ردود الأفعال الرسمية:
خلال اليومين الأول والثاني من الحراك، اختارت السلطة ردًّا غريزيًا وسريعًا أقرب إلى المقاربة الأمنية الكلاسيكية: فنزلت قواتها بأعدادٍ كثيفة إلى الشوارع في محاولةٍ لاحتواء ما يجري، فجمعت بين مظهرين متوازيين: المنع المباشر لأي تجمهر أو حتى إبداء للرأي في الساحات العامة، ومستوى منخفض من العنف المادي واللفظي بهدف الردع السريع دون انفلاتٍ شامل. أسفرت حصيلة اليومين عن عشرات الاعتقالات، تمّ الاحتفاظ ببعضهم إلى اليوم، فيما وثّقت منظماتٌ مدنية حالات تدخلٍ عنيف رافق محاولات التجمهر الأولى.
وابتداءً من اليوم الثالث، تغيّر المشهد بشكلٍ دراماتيكي: فقد ظهر في الميدان عنصرٌ جديد: المحتجون الملثمون، في مقابل انحسار حضور الفئة الأولى من المتظاهرين كاشفي الوجوه الذين طبعوا البداية بالسلمية والهدوء. تبدّل المشهد بسرعة، وتحولت الاحتجاجات إلى مواجهاتٍ متفرقة، واستُخدمت فيها الحجارة وقنابل الغاز، لتنتهي الحصيلة بمئات الجرحى وثلاثة قتلى، تزامنًا مع أول تصريحٍ صارم للنيابة العامة جاء بلهجةٍ أمنيةٍ واضحة، تتحدث عن “أعمال شغبٍ مرفوضة” و”اعتداءاتٍ على الممتلكات العامة والخاصة”.
في تلك اللحظة، كان الفراغ السياسي للحكومة صارخًا، إذ لم يصدر أي موقف رسمي يُعبّر عن قراءةٍ سياسيةٍ لما يجري، باستثناء بيانٍ باهتٍ لأحزاب الأغلبية، لم يحمل أي مبادرةٍ أو لغةٍ تتجاوز التبرير البروتوكولي لسياسات الدولة. كان البيان حاضرا من حيث الشكل، غائبًا من حيث المضمون.
لكنّ التحول المفصلي جاء من داخل الحراك نفسه: فقد سارع شباب جيل زد إلى إعلان تبرّؤهم من كل أشكال العنف، مؤكدين في بياناتٍ ومنشوراتٍ رقميةٍ متفرقة تمسكهم بسلمية احتجاجهم ورفضهم لأي اختراقٍ أو انحرافٍ عن طبيعته المدنية. تلك المبادرة الأخلاقية قلبت المعادلة وأحرجت السلطة، التي سرعان ما تراجعت عن منطق المنع إلى منطق “التحكم والتأطير”، فتحوّل التعامل الرسمي إلى إدارةٍ محسوبةٍ لزخم الشارع بدل قمعه المباشر.
2. ردود الأفعال السياسية: (الحزبية والبرلمانية)
إذا كان الموقف الرسمي قد غلّب في الأخير لغة التهدئة والانصات، فإنّ المشهد الحزبي المغربي بدا أكثر ارتباكًا من أي وقتٍ مضى: فالأحزاب، على اختلاف توجهاتها، وجدت نفسها أمام حراكٍ لا تعرف كيف تخاطبه، ولا تملك الأدوات اللازمة لاختراق فضائه الرمزي أو الرقمي. فالجيل الذي فجّر الحراك لا يصوّت، ولا ينتمي تنظيميًا، ولا يثق في الخطاب الحزبي الذي فقد عنده منذ سنواتٍ طويلة قدرته على الإقناع.
لقد تباينت ردود الأحزاب التقليدية، سواء التي في الحكومة أو المعارضة، بين محاولات احتواءٍ حذرة وتأويلاتٍ دفاعية. فمنها من سارع إلى تبنّي خطابٍ “تفهميٍّ” للغضب الشبابي، ومنها من اتهم الحراك بـ”الانفعال غير المؤطر” و”التأثر بخطاب المنصات”. لكنّ ما جمعها جميعًا هو العجز عن قراءة التحوّل الحقيقي في وعي الشباب. لقد ظلّت أسيرةَ منطق الشعارات القديمة: “الإصلاح من الداخل”، و”الثقة في المؤسسات”، و”الانخراط الواعي”.. في حين أن جيل زد يتحدث بلغةٍ أخرى تمامًا: لغة المصداقية الفعلية لا التنظير الأيديولوجي، والمشاركة الفعالة لا التمثيل الوهمي.
وحتى في البرلمان، جاءت المداخلات الرسمية أقرب إلى ردود فعلٍ شكلية منها إلى تحليلٍ عميقٍ لما يجري في الشارع. فقد تحوّل النقاش، بين وزير الصحة والبرلمانيين إلى تبادلٍ للاتهامات بين الأغلبية والمعارضة، كلٌّ يسعى لاستثمار اللحظة لمصلحته، بينما كان الشارع يتحدث عن شيءٍ آخر تمامًا: عن المعنى والكرامة والحقّ في الكلمة الصادقة. بعض الأحزاب الشابة والناشئة حاولت أن تركب الموجة الرمزية للحراك، بخطابٍ قريب من لغة المنصات، لكنّها اصطدمت سريعًا بأنّ الجيل الجديد لا يبحث عن تمثيلٍ سياسي، بل عن فضاءٍ أخلاقيٍّ يصدّق فيه ما يُقال.
إنّه جيلٌ يرى السياسة من خارج بنياتها التقليدية، ويتعامل مع الحزب كما يتعامل مع التطبيق الرقمي: إن لم يلبِّ حاجته، يلغيه بضغطة زر. هذا الانفصال بين المنظومة الحزبية والجيل الجديد يطرح تساؤلا جديا حول مستقبل الوساطة السياسية في المغرب: فالأحزاب التي كانت تُعرّف نفسها كجسرٍ بين الدولة والمجتمع، قد تحوّلت اليوم إلى جزرٍ معزولةٍ بينهما، تتكلم لغةً فقدت بريقها، وتُخاطب جمهورًا لم يعد موجودًا.
وهكذا، لم يكن الحراك صدامًا مع السلطة بقدر ما كان انكشافا للنظام الحزبي العتيق، والذي اكتشف فجأةً أن المشهد الحزبي الذي دأب على التحكم فيه بشتى الطرق، ها هو بات مسلوبا من مهمته الدستورية والسياسية، فلم يعد المرجع ولا الوسيط.. وأنّ الشارع يسجل هذه المرة أيضا، تجاوزه للبرلمان في إنتاج الخطاب السياسي الجديد، ولكن هذه المرة بلغة أكثر جدة وحنكة وتوازنا.
فجيل زد لم يأتِ ليقلب الطاولة، بل ليكشف أن الطاولة فارغة أصلًا، وأنّ السياسة التي لا تستمع إلى الإنسان، تتحوّل، مع الوقت، إلى مشهدٍ كاريكاتوري، لا معنى له في زمن الحقيقة الفورية.
3. وقفة مع الخطاب الملكي أمام البرلمان يوم 10 أكتوبر 2025:
لرصد مدى تجاوب الخطاب الملكي أمام البرلمان، يوم 10 أكتوبر 2025، مع مطالب حراك جيل زد، سنضع مضمونه وشكله في مواجهة الوثيقة المطلبية التي صاغها الشباب أنفسهم. ومن خلال هذه المقارنة، يمكن تصنيف استجابة المؤسسة الملكية إلى ثلاثة مستويات متمايزة، تكشف طبيعة المقاربة التي اختارها القصر في تعامله مع الحراك، وهي: استجابة عالية تستوعب المبدأ دون كسر النسق، واستجابة متوسطة تكتفي بالانتقاء الخطابي، واستجابة متدنية أو منعدمة تؤجّل المطلب أو تقصيه.
هذا التصنيف لا يروم قياس “النوايا السياسية” كما تفعل العلوم السياسية، بل يقيس “الفعل الخطابي”، بوصفه ممارسة تداولية تكشف، عبر ما يُقال وما يُسكَت عنه، كيف يحدّد الفاعل السياسي الأول في البلاد حدوده الرمزية في التفاعل مع المطالب، بين الاستيعاب والانتقاء والإرجاء، في إطار توازنٍ دقيقٍ بين اللغة والسلطة.
1.3. “استيعاب المبدأ دون كسر النسق” كاستجابة عالية:
يشمل هذا المستوى المطالبَ التي حظيت بأعلى درجاتٍ من التجاوب في الخطاب الملكي، حيث يرتبط معظمها بالمجالين الاجتماعي والمؤسسي، ذوَي الطابع التنموي:
فقد حلّ في مقدمتها مطلب العدالة الاجتماعية والمجالية، والذي اعتُبر في الخطاب “توجّهًا استراتيجيًا” و”رهانًا مصيريًا”، بما يوحي برغبةٍ في إعادة تعريف النموذج التنموي المغربي، على أسس تصحيحية، تتجاوز البعد الاقتصادي، إلى أفقٍ قيمي وأخلاقي.
هذه الإشارة ليست مجرد إعلان نوايا تنموية، بل يمكن أن نلتقطها كتحول نوعي في الخطاب الرسمي، نحو إعادة تموضعه في فضاء العدالة الرمزية، بما ينسجم مع روح مطالب جيل زد، الساعية إلى إنصافٍ اجتماعي ومجالي، يعيد الاعتبار للمواطن، بوصفه محور التنمية لا مجرد مستفيد منها.
وقد برز في الإطار نفسه، مطلب الشفافية والتواصل مع المواطنين، كأوضح صور التجاوب وأكثرها مباشرة. فقد دعا الملك بوضوح البرلمانَ والأحزاب والإعلام والمجتمع المدني إلى تأطير المواطنين، والتعريف بالمبادرات العمومية. وهي دعوة تحمل دلالة مزدوجة: اعترافًا ضمنيًا بوجود فجوة تواصل (وثقة) بين الدولة والمجتمع، ومحاولةً لردمها عبر انفتاحٍ مؤسسي محسوب.
بهذا المعنى، يمكن القول إن الخطاب الملكي قد تبنّى جوهر مطالب الحراك دون أن يشير إليه، وعبّر عن إرادةٍ في الاستيعاب لا في الاعتراف، في ما يمكن تسميته بـ استراتيجية “الاحتواء الأخلاقي”: أي الاستجابة من حيث المبدأ، دون ترجمتها إلى التزاماتٍ عملية محددة.
إنها استجابة تُهدئ من روع المزاج الوطني العام، وتعيد ضبط إيقاع التفاعل الداخلي، لكنها لا تصل إلى مستوى تغيير القواعد العميقة لعلاقة المواطن بالدولة.
2.3. استيعاب الانتقاء في حدود النسق كاستجابة متوسطة:
يشمل هذا المستوى المطالب التي تناولها الخطاب الملكي بلغةٍ إصلاحية عامة، دون أن يترجمها إلى التزاماتٍ مؤسسية واضحة. وهي تمثل ما يمكن تسميته بـ “المنطقة البينية” التي تجيد المؤسسة الملكية التحرك داخلها: مساحة الاعتراف بالخلل دون المساس بجذره البنيوي.
فقد تطرّق الخطاب، ضمنيا، إلى ضرورة محاربة الفساد الإداري والريع، عبر التأكيد على “ضرورة محاربة الممارسات التي تُعيق النجاعة وتُبدّد الجهد والاستثمار العمومي”. غير أن هذا التناول ظل في حدود البلاغة الإصلاحية، دون أن يُرفَق بآلياتٍ أو مساطر محاسبة واضحة. إنه الأسلوب الذي يجمع بين “تطهيرية اللغة” و”بيروقراطية الأداة”: خطابٌ يُدين الفساد من حيث المبدأ، لكنه لا يفتح الباب لمساءلته من حيث الفعل.
وفي السياق ذاته، ورد مطلب إصلاح التعليم والتكوين والتشغيل من زاويةٍ ديناميكية تنموية، لا من واجهة إصلاحية هيكلية. فاكتفى الخطاب بتكرار العناوين الكبرى: “فرص الشغل والتعليم والصحة”، وهي مفردات مألوفة في القاموس الرسمي، مع أنها تكتسب، هذه المرة، حمولة رمزية جديدة، حين تُستحضر في سياق أزمة اجتماعية مفتوحة.
أما الحديث عن “الحق في الصحة والرعاية الاجتماعية”، فقد أُدرج ضمن أولويات التنمية، دون أن يُعالَج بوصفه أزمة ثقة مواطِنية، أو حقًا مُلحًا من حقوق المواطن. فتم التعامل مع القطاع الصحي كـ “مجالٍ من مجالات الاستثمار العمومي”، لا كأحد أعمدة العقد الاجتماعي الجديد، مما يجعل تلك الاستجابة أقرب إلى النهج التقني منها إلى المقاربة الأخلاقية.
وفي محور محاسبة النخب السياسية والإدارية، جاءت الدعوة إلى النزاهة مقرونةً بالخاتمة القرآنية: “فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره…”. وهي إشارة رمزية قوية في بعدها الأخلاقي، لكنها تفتقر إلى مضمونٍ مؤسساتي أو آليةٍ تنفيذية، فتحولت بذلك من استجابة رقابية إلى نبرة وعظية، تُذكّر ولا تُلزم.
أما بخصوص دمقرطة القرار التنموي وإشراك المجتمع المدني، فقد تحدث الخطاب عن “تعبئة الجميع” و”تكامل الفاعلين”، وهي عبارات توحي بانفتاحٍ مبدئي، لكنها لا تتجاوز حدود الخطاب. فلا وجود لآليات إشراك جديدة، ولا اعترافٍ بأن ضعف المشاركة المجتمعية هو أحد جذور الأزمة البنيوية.
وبناءً على ذلك، يمكن القول إن هذه المطالب جميعها تشترك في سمةٍ واحدة: تم استيعابها جزئيًا داخل الخطاب، لكن بعد تفريغها من طابعها الاحتجاجي، وتحويلها إلى عناوين إدارية.
وهكذا، جرى تحويل الزخم الشعبي إلى نوايا تنموية مضبوطة، ضمن آليات تدبير كلاسيكية.. أي أن الدولة، تكون بذلك قد استجابت بلغة التغيير، لكنها أبقت على منطق الثبات.
3.3. “إيثار الإرجاء السياسي” كاستجابة متدنية أو منعدمة:
في هذا المستوى تتراكم المطالب ذات الطبيعة السياسية المباشرة، أي تلك التي تلامس بنية السلطة نفسها وتمتح من سؤال الشرعية الرمزية للدولة. وهنا، اختار الخطاب الملكي لغة الصمت المحسوب، متفاديًا الخوض في هذه المنطقة الحساسة، أو التورط في أي إقرارٍ قد يُفهم باعتباره اعترافًا بخللٍ في التوازنات الكبرى.
ففي الوقت الذي كان يأمل فيه حراك جيل زد أن يُعترف به، كمكوّنٍ شرعي جديد في المشهد الوطني، تجاهل الخطاب ذكره تمامًا. لم يسقط اسمه من نص الخطاب سهوًا، بل تم إقصاؤه وعيا وقصدًا، حفاظا على احتكار الدولة لتعريف ما يُعتبر “حراكًا شرعيًا”، كما كان الشأن في حالة 20 فبراير، وما يُصنَّف في خانة “الاحتجاجات العابرة”، كما يجرى التعاطي الآن مع جيل زد رسميًا.
إنه “صمت سيادي” بامتياز، يهدف إلى ضبط حدود المشروعية الاجتماعية، قبل أن تتحوّل إلى شرعية سياسية.
أما مطلب الاعتراف بالأزمة السياسية والأخلاقية التي يعيشها التدبير العمومي، فقد ووجه بتبنٍّ مغايرٍ تمامًا: إذ اختار الخطاب أن يتحدث عن “المغرب الصاعد”، مقدّمًا منطق الاستمرارية على القطيعة، والتحفيز على النقد، والدينامية على الأزمة. كانت تلك محاولة واعية لإعادة تأويل الواقع، بدل مساءلته في أفق تجاوزه.. أي تحويل التحدي إلى سردية نجاحٍ مستمرة، لا إلى أزمةٍ تستدعي القطيعة.
وفي السياق ذاته، جاء مطلب الإصلاح السياسي والمؤسساتي الشامل، كأبرز ما تم تجاوزه في الخطاب: إذ لم يُشر الخطاب بتاتا، لا إلى مراجعةٍ دستورية، ولا إلى إصلاحٍ في بنية التمثيل، أو منظومة السلطة.
يُقرأ هذا الصمت، في السياق المغربي، باعتباره رسالةٍ دقيقة المضمون: “اللحظة السياسية الراهنة ليست لحظة مساءلة المؤسسات، بل لحظة تثبيت الاستقرار وإعادة ترتيب الثقة.” إنها إشارة إلى أن الأولوية اليوم، للفعالية قبل الشرعية، وللتنمية قبل السياسة.
من هذا المنظور، يظهر الخطاب الملكي كجزءٍ من مقاربةٍ استيعابية ثلاثية المستويات: فهو يستجيب بقوة لما لا يهدد بنية السلطة، كالعدالة والشفافية والتنمية. ويستجيب جزئيًا لما يتطلب إصلاحًا إداريًا أو مؤسساتيًا متوسط المدى. ثم يتجاهل تمامًا ما يمس جوهر التمثيل السياسي أو شرعية الحراك ذاته.
بهذا الأسلوب، حافظ الخطاب على منطق الدولة المغربية كما تشكّل تاريخيًا: تهدئة بلا تغيير جذري، واحتواء بلا اعتراف كامل، وإصلاح دون تحوّل نوعي.
ومع كل ذلك، فإن تضمين الخطاب لغةً أكثر قربًا من وعي الشارع، ولو بقدرٍ محسوب، يمثل اعترافًا ضمنيًا بأن جيل زد المغربي هذا، قد نجح في إثبات أن الإصلاح الحقيقي في المغرب، قد أصبح ممكنا، في ظل تحقيق الاستقرار.
4. الردود المدنية والحقوقية والإعلامية:
لم يكن المجتمع المدني أقلّ ارتباكًا من الطبقة السياسية، لكنه بدا أكثر “تفهما” للحظة: فمنذ الأيام الأولى للحراك، صدرت مواقف متباينة من الجمعيات والمنظمات الحقوقية، بعضها رأى في ما يحدث ولادة وعيٍ جماعيٍّ جديد يستحق الدعم والمواكبة، فيما فضّل البعض الآخر الاكتفاء بالمراقبة، خشية أن تُحسب مواقفه على أي جهةٍ أو أن تُستغل سياسيًا:
فالمنظمات الحقوقية المستقلة، مثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنتديات الدفاع عن حرية التعبير، أصدرت بياناتٍ واضحة دعت فيها إلى ضمان الحق في الاحتجاج السلمي، ورفض أي مقاربةٍ أمنيةٍ يمكن أن تُفرغ الحراك من طابعه المدني.
بينما لجأت النقابات الكبرى إلى لغةٍ مزدوجة، تجمع بين التضامن الرمزي والحيطة الواقعية، إذ تخوّفت من أن يؤدي أي تصعيدٍ إلى تعطيل الحوار الاجتماعي أو المساس بمكتسباتها القطاعية.
أما الجمعيات الشبابية والمبادرات التطوعية فقد كانت الأقرب إلى نبض الشارع، فهي التي فهمت الحراك لا كحالةٍ سياسية، بل كـ”حدثٍ أخلاقيٍّ” في وعي الشباب المغربي. فنظّم بعضها حلقات نقاشٍ وورشاتٍ رقمية لتحليل أسباب الغضب، وبعضها الآخر حاول تحويل الزخم الشعبي إلى حوارٍ مجتمعي حول القيم والمواطنة والمسؤولية. بهذا المعنى، كان الحراك فرصةً لإعادة إحياء المجتمع المدني الذي فقد في السنوات الأخيرة كثيرًا من زخمه وفاعليته.
أما الإعلام المغربي، فكان بين المطرقة والسندان: التزمت القنوات الرسمية الخطاب المهدّئ الذي يركّز على “حقّ التظاهر” و”ضرورة ضبط النفس”. ولكن ما يسجل له أنه بعد اليومين الأولين شرع في فسح المجال لبعض الأصوات الشابة للتعبير عن مطالب جيل زد، بغض النظر عن مصداقية تمثيليتهم لذلك الحراك. بينما انقسم الإعلام الخاص بين تغطيةٍ ميدانيةٍ متحفظة، وتحليلاتٍ تحاول تأطير الحراك في قوالب سياسية جاهزة.
كما كان المشهد المدني مضطربا ومنقسما، فقد نال مجال الاشتغال بالحقل الديني قدر من ذلك: فاختلف بعض العلماء والدعاة والخطباء في شأن شرعية ذلك الحراك.
لكن الفضاء الحقيقي الذي كان أكثر احتضان للحراك فقد كان هو الإعلام الرقمي المستقل: صفحات شبابية، ومنصات تفاعلية، وصحفيون مواطنون، نجحوا في خلق سردية موازية لما تبثه المؤسسات، أعادت الاعتبار لفكرة أن “الإعلام ليس فقط من يُبلّغ، بل من يُنصت”.
في المقابل، حاولت بعض المنصات الموالية للجهات الرسمية التقليل من شأن الحراك عبر ربطه بـ”تأثيرات خارجية” أو “تحريض إلكتروني”، لكنّ هذا الخطاب كان قد فقد صدقيته بسرعة أمام وعي الجمهور الجديد، الذي بات يفرّق بين الرأي والمعلومة، وبين الدعاية والحقيقة.
ما يمكن استنتاجه من هذا المشهد أن الحراك المغربي كشف عن هشاشة البنية التقليدية للمجتمع المدني والإعلام الرسمي، وفي الوقت ذاته عن ولادة فضاءٍ مدنيٍّ رقميٍّ جديد، يتمتّع بقدرةٍ على التعبئة والتحشيد والتنظيم الذاتي والتأثير الهادئ، بعيدًا عن التأثيرات الخارجية والمظلات الحزبية.
وهنا تتجلّى المفارقة الكبرى: بين مجتمعٍ مدنيٍّ مؤسسيٍّ يختنق بالبيروقراطية، ومجتمعٍ مدنيٍّ شبابيٍّ يولد في العالم الافتراضي ليطالب بإنسانٍ واقعيٍّ أكثر كرامة.
5. قراءة تركيبية في دلالات ردود الأفعال:
تكشف مجمل ردود الأفعال، الرسمية والسياسية والمدنية والإعلامية، عن منعطفٍ حقيقي في علاقة الدولة بالمجتمع المغربي:
فالحراك لم يكن مواجهةً بين السلطة والشباب، بل كان امتحانًا وطنيًا للثقة: هل ما زالت المؤسسات قادرة على الإصغاء؟ وهل لا يزال المواطن يؤمن بجدوى الكلمة؟
لقد أظهر هذا الحراك أن المغرب يعيش انتقالًا بطيئًا من زمن التحكم إلى زمن التفاعل. فلم تعد القوة وحدها كافية لضبط المجال العام، ولا الخطابات القديمة قادرة على احتواء وعيٍ جديدٍ يتشكّل خارج الإطار الرسمي.
جيل زد، بما حمله من لغاتٍ رقميةٍ وقيمٍ كونيةٍ، فرض على الجميع، سلطةً وأحزابًا ونخبًا، أن يعيدوا النظر في طرائق التفكير، لا في أساليب التسيير فحسب.
المفارقة أن الحراك لم يُنتج أزمةً سياسية، بقدر ما كشف الأزمة المزمنة التي كانت كامنة: فما بدا انفجارًا في الشارع، كان في العمق تعبيرًا عن تراكمٍ طويلٍ من الصمت والخذلان. وما بدا غضبًا عابرًا، كان في جوهره بحثًا جماعيًا عن معنى جديدٍ للعيش المشترك.
على المستوى البنيوي، أعاد الحراك ترتيب سلم الشرعية: من شرعية القوة إلى شرعية المصداقية، ومن سلطة القرار إلى سلطة الإصغاء: فمنذ زمنٍ طويل، كانت الدولة هي التي تتحدث والمجتمع يستمع، أما اليوم، فقد تغيّر المشهد: المجتمع يتكلم والدولة تُنصت، ولو على مضض.
وهذا التحوّل الرمزي هو أخطر ما في الحراك وأجمل ما فيه في آنٍ واحد، لأنه يعني أن المغرب دخل منطقة الوعي الجديد التي لا يمكن التراجع عنها.
أما من حيث المستقبل، فإنّ دلالات هذه الردود تؤشر على ثلاثة مسارات محتملة:
مسار استيعاب إيجابي: تعيد فيه الدولة بناء جسور الثقة عبر إصلاحاتٍ حقيقيةٍ تمس التعليم، والعدالة، والإعلام، وتمنح الشباب موقع الفاعل لا المفعول به.
مسار ممانعة تقليدي: تسعى فيه السلطة إلى إعادة ضبط المشهد بالوسائل القديمة، مما قد يؤدي إلى موجاتٍ متكرّرةٍ من الاحتجاج وفقدان المصداقية.
مسار تفاعلٍ متدرّج: وهو الأرجح، يتم فيه التكيّف البطيء بين بنية الدولة التقليدية وبنية الوعي الجديد،حيث لا يسقط أحد، بل يتحوّل الجميع تدريجيًا نحو صيغةٍ أكثر توازناً وصدقًا في العقد الاجتماعي القادم. وهو ما سنراه فيما بعد.
رابعا: احتمالات المآل الداخلي للحرك:
بعد أن خمدت الهتافات في الشوارع وتراجعت الحشود إلى فضائها الافتراضي، بدأ سؤال المستقبل يفرض نفسه بقوة: إلى أين يمكن أن يمضي حراك جيل زد؟ هل كانت تلك الأسابيع القليلة من الغضب مجرد ومضة عاطفية ستذوب في الذاكرة، أم أنها لحظة مفصلية دشّنت عهدًا جديدًا من الوعي الشعبي؟ فالحراك حدثٌ بنيوي أعاد طرح أسئلة الدولة والمجتمع والشرعية بلغة الجيل الجديد. ومع ذلك، فإن مآله لا يُقاس بشدة الانفجار، بل بقدرته على الاستمرار والتحوّل من لحظة احتجاج إلى قوة اقتراح وتغيير. وهنا تتعدّد السيناريوهات الممكنة.
- السيناريو الأول: مسار الاستيعاب الإيجابي:
في هذا السيناريو، تتعامل الدولة مع الحراك بوصفه فرصةً لا تهديدًا: فتقرأ ما حدث لا كاحتجاجٍ ضدها، بل كإشارةٍ إلى حاجةٍ داخليةٍ للإصلاح. حينها ستتحوّل الأزمة إلى نقطة انطلاقٍ جديدة، ويغدو الشارع ليس خصمًا، بل مرآةً تكشف مكامن الخلل في البنية السياسية والاجتماعية.
يتمثّل المدخل الأساس لهذا المسار في إعادة بناء الثقة: ذلك أن الشرخ الحقيقي أساسا، لم يكن بين الشباب والدولة، بل بين المواطن ومعنى المواطنة ذاته، وذلك بعدما فقدت المؤسسات الرسمية جزءًا كبيرًا من صدقيتها، حين تحوّلت اللغة الإصلاحية إلى طقسٍ بيروقراطيٍّ بلا مضمون. ولذلك، لا يمكن ترميم الشرخ إلا بإصلاحاتٍ حقيقية تمسّ جذور العطب لا سطحه:
يبدأ هذا المسار بإصلاحٍ تعليميٍّ جذريٍّ يعيد للمدرسة دورها في إنتاج التفكير لا التدجين، ويجعل الجامعة مختبرًا للحوار الاجتماعي، لا مصنعا للشهادات غير القابلة للصرف. يتزامن ذلك مع مراجعةٍ شجاعةٍ للعدالة، تضمن استقلال القضاء وكرامة المواطن، وتعيد الثقة في القانون، كدرعٍ لا كعقوبة. ثم يأتي الإعلام ليكون مكوِّنًا إصلاحيًا لا دعائيًا، ينقل صوت المجتمع إلى الدولة، لا العكس، ويُستعاد به المعنى الأخلاقي للخبر كمسؤوليةٍ لا كسلعة.
أما سياسياً، يقتضي هذا السيناريو أن تتبنّى الدولة نموذج الحكم التشاركي، الذي يُعيد للشباب موقع الفاعل لا المفعول به. فالمطلوب ليس “إدماجهم في المؤسسات”، بل إعادة تعريف المؤسسات نفسها لتكون قابلةً لحضورهم. فجيل زد هذا لا ينتظر التفويض، بل يسعى إلى المشاركة، ولا يطلب من السلطة بالضرورة أن تتنازل له، بل فقط أن تصغي حقيقة إليه.
هذا هو السيناريو الأصعب من حيث التنفيذ، لكنه الأكثر حكمةً واستدامةً، لأنه يحوّل التوتر إلى طاقةٍ إصلاحية، ويجعل الدولة والمجتمع شريكين في صناعة المستقبل.
عندها فقط يمكن أن تتحوّل “أزمة الشارع” إلى ورشةٍ وطنيةٍ للتجديد السياسي والأخلاقي، ويُكتب للمغرب أن يعبُر من زمن الخوف إلى زمن الثقة، ومن منطق التهدئة إلى منطق التأسيس.
- السيناريو الثاني: مسار المعاندة التقليدي:
في هذا المسار، تختار الدولة أن تقرأ الحراك بعيون الماضي، لا بعقل المستقبل. فتراه تهديدًا لبنيتها الرمزية، لا فرصةً لتجديدها. حينها يتحرك النظام بدافع الغريزة التاريخية للحفاظ على الاستقرار بأي ثمن، فيستعيد آلياته القديمة: الأمن بدل الحوار، والضبط بدل المشاركة، والخطاب الموجَّه بدل التواصل الحقيقي.
تبدأ ملامح هذا السيناريو عادةً من العودة إلى قاموس “هيبة الدولة”، وتكثيف الخطاب الرسمي حول “ضرورة الحفاظ على النظام العام” و”التصدي للمندسّين”.. وهي عباراتٌ يعرفها الشارع جيدًا، ويقرأها كرسالةٍ مبطّنةٍ تقول: “الاستماع لكم لا يعني الانصات لكم”.
بهذه اللغة، تُدار الأزمات من فوق لا من داخلها، ويُعاد إنتاج الأزمة ذاتها، تحت أسماء جديدة. في هذا المسار، تُستعمل أدوات الاحتواء لا الإصلاح. تُفعَّل شبكات الزبونية والولاءات المحلية، ويُستدعى الإعلام الرسمي لترويج صورةٍ مهدّئةٍ باهتة، تُخفي التوتر أكثر مما تُعالجه. كما يُعاد تفعيل آليات الضبط الإداري، من المراقبة الرقمية إلى التضييق الرمزي، لمنع الحراك من إعادة التشكّل. غير أن هذه الأساليب، مهما كانت فعّالة في المدى القصير، فإنها تستهلك ما تبقّى من رصيد الثقة، وتحوّل كل خطوةٍ إجرائية إلى دليلٍ جديدٍ، على غياب الإرادة في التغيير.
في ظل هذا السيناريو، تتراكم الاحتجاجات الصغيرة الصامتة، تُعبّر عنها حملات المقاطعات، ونوبات الهجرات السرية والجهرية والرمزية، والعزوف الانتخابي.. فتتحول اللامبالاة إلى شكلٍ جديدٍ من العصيان المدني البارد، والعناد السلبي المزمن. ذلك أن المجتمع الذي لا يُسمع صوته في الساحات، يعبّر في النهاية بوسائل أكثر هدوءًا ولكن أكثر جذرية.
سياسيًا، يقود هذا المسار إلى تآكل شرعية النخب، وإلى مزيدٍ من الانفصال بين الفعل الرسمي والوجدان الشعبي. فلا يعود المواطن يثق في المؤسسات، ولا يجد الحزب أو النقابة ما يبرر وجوده، سوى الخطاب المكرر عن “الخصوصية المغربية” و”الاستثناء المغربي”.. في وقتٍ تتقلص فيه فعالية النموذج داخليا، وتتماهى التجارب عالميا.
ومع مرور الوقت، لا ينتج هذا السيناريو غير استقرار مزيف، وجمود خطير، يشبه الصمت القاتل الذي يسبق العاصفة الهادرة. فكلما أُغلقت منافذ التعبير، ازداد ضغط الأسئلة المكبوتة؛ وكلما أُخمد صوت الشارع، تزايد الصدى داخل النفوس.
إنه استقرار ظاهريٌّ فوق أرضٍ رخوة، قد يبدو آمنًا اليوم، لكنه هشٌّ غدًا، أمام أي شرارةٍ جديدة، أو هزة مقبلة.
بهذا المعنى، فإن مسار المعاندة التقليدي ليس مجرد استمرارٍ للنهج القديم، بل هو إصرار على إنكار التحوّل البنيوي في الوعي المغربي. وحين تُصرّ الدولة على إدارة المستقبل بالأدوات نفسها التي استخدمتها في الماضي، فإنها تُعيد إنتاج أزمتها لا تجاوزها، وتؤكد، دون أن تقصد، أن التغيير لم يعد خيارًا ترفيهيًا، بل شرطًا للبقاء.
- السيناريو الثالث: مسار التفاعل المتدرّج:
بين الحلم بالإصلاح الشامل، والخوف من انهيار النسق، يبدو هذا السيناريو هو الأقرب إلى الواقع المغربي وإلى مزاجه التاريخي. فالمغرب، كما علّمنا تاريخه الطويل، لا يتحرّك عبرالقطيعة بل بالتوسل بالتدرّج، ولا يثور بانفجارٍ شامل، بل يتحوّل في صمتٍ متواترٍ، يشبه النبض الداخلي للجسد السليم.
في هذا المسار، لا تنكر الدولة الحاجة إلى الإصلاح، لكنها تتعامل معه كمسارٍ طويلٍ من التكيّف لا كقفزةٍ مفاجئة، ولكن في الاتجاه الصحيح. فتستوعب المطالب الشعبية، ضمن جدولٍ زمنيٍّ مرن، وتعيد توجيه سياساتها الاقتصادية والتعليمية والإعلامية، على نحوٍ يخفّف التوتر، بدل أن يلغيه.
وفي المقابل، يتراجع الشارع عن منطق الصدام، ليتبنّى ثقافة المراقبة والمساءلة الهادئة بدل الاحتجاج الدائم، فتنشأ بين الطرفين حالة من “التحفّظ المتبادل” إلى حين الوفاء بالوعود المضروبة، فتُبقي التوازن دون أن تُخمد التفاعل.
ما يميّز هذا السيناريو أنه يحوّل الأزمة إلى حوارٍ مستمرٍّ، يتعلّم فيه كل طرفٍ من الآخر: الدولة تتعلّم الإنصات، والمجتمع يتعلّم التنظيم، والنخب تكتشف أن دورها لم يعُد هو مجرد الوساطة التقليدية، بل الاستيعاب المتبادل بين لغتين مختلفتين، لغة السلطة المحافظة ولغة الوعي المتجدد.
بهذه الدينامية، لا يسقط أحد، ولا ينتصر أحد، بل يتحوّل الجميع تدريجيًا نحو توازنٍ جديدٍ، أكثر مصداقية ومرونة.
على المدى القصير، قد يبدو هذا المسار بطيئًا ومضنيًا، لكنّه بالتأكيد يخلق ثقافة سياسية جديدة: تقبُّل الخلاف دون تخوين، واعتبار الاحتجاج حقًا لا تهديدًا، والاعتراف بأن الدولة ليست مركزًا ثابتًا، بل فضاءً للتفاوض المستمر.
هذا السيناريو لا ينفي التوتر، بل يديره بعقلٍ باردٍ وأفقٍ مفتوح. ويُبقي المغرب في موقعٍ فريدٍ بين التجارب العربية: لا في حالة الانفجار كما سبق أن حدث في كذا تجربة عربية مؤسفة. كما لا يبقي الوضع في حالة انغلاق كما في أنظمةٍ كابتة قامعة، بل يظل في منطقة رمادية خلّاقة، تُنتج فيها المجتمعات نضجها البطيء.
إنه المسار الذي يرى في الزمن حليفًا لا خصمًا، وفي الحوار وسيلةً لا ضعفًا، وفي الإصلاح المتدرّج طريقًا لتجديد الشرعية لا لترميمها.
وإذا نجح المغرب في الحفاظ على هذا الإيقاع، فقد يكتب تجربةً عربيةً فريدةً في الانتقال الهادئ، تُثبت أن التحوّل لا يحتاج دائمًا إلى ثورة، بل إلى وعيٍ يغيّر اللغة قبل أن يغيّر السلطة.
هكذا تتوزع احتمالات المآل الداخلي لحراك جيل زد المغربي، بين ثلاثة مساراتٍ متقابلةٍ في الظاهر، لكنها في العمق تعبّر عن جدليةٍ واحدةٍ، بين الخوف من الفوضى والرغبة في الإصلاح. فمسار الاستيعاب الإيجابي هو طريق الأمل والتغيير العميق، يحوّل الأزمة إلى فرصةٍ لإعادة التأسيس، لكنه يحتاج إلى شجاعةٍ سياسيةٍ واستشرافٍ أخلاقيٍّ نادرين.
أما مسار المعاندة التقليدي، فهو طريق إلى انكماش الذات، يحافظ على استقرارٍ وهمي هشٍّ، لكنه يراكم غضبًا صامتًا، قد ينفجر لاحقًا، فهو أشبه بمسكنٍ سياسيٍّ يعالج الألم ولا يداوي سببه. بينما مسار التفاعل المتدرّج يمثل حلًّا وسطًا، بين الحذر والطموح، يجعل الزمن أداةً للإصلاح لا ذريعةً لتأجيله، ويمنح البلاد فرصةً لبناء توازنٍ جديدٍ بين شرعية الدولة وشرعية الوعي.
ما بين الممكن والمأمول، يبقى المستقبل رهين قدرة الفاعلين، الرسميين والمجتمعيين، على التعلّم من الحراك لا الهروب منه. فجيل زد على ما يبدو من طبيعته، لم يأتِ ليهدم، بل ليُذكّر أن المجتمع الحيّ لا يصمت طويلاً، وأن الصدقية حين تعود إلى المجال العام، تعيد السياسة إلى معناها الإنساني الأول: فنّ الإصغاء قبل فنّ الحكم.
وبذلك، يمكن القول إنّ ما يجري في المغرب ليس مجرد أزمةٍ داخلية، بل مختبرٌ عربيٌّ مبكر، لأسئلة الجيل الجديد: كيف نحيا بكرامة؟ كيف نحكم بالثقة؟ وكيف نختلف دون أن نتحطّم؟
أسئلة لا تخص المغرب وحده، بل تُمهّد لمرحلةٍ أوسع من الوعي العربي المقبل، الذي لم تعد شرارته تُشعلها الشعارات، بل توق الإنسان إلى المعنى.
من خلال كل ذلك، يمكن أن يستخلص المستخلص، إذا أراد، أن جيل زد المغربي، لن يكون هبة عابرة، ولا عاصفة هادرة، ولكنه مرشح أن يمثل نقطة التحول الهادئة التي تُعيد رسم الوعي الجمعي للمغاربة.. وربما أن يكون ضميرا جديدا، يتخلق في ضمير الوطن، يسعى إلى ولادةٍ ثانية لعقدٍ اجتماعيّ أكثر صدقًا وعدلًا، يفتح أمام الدولة والمجتمع، كليهما، سؤال الخيارات، قبل أن توجبها الإكراهات، ويتبنى المشاريع بالأهداف قبل أن تفرضها الكوارث.