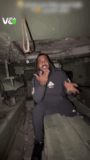جولة ترامب.. شرق أوسط جديد؟

عرفت منطقة الشرق الأوسط تطورات كبرى وغير مسبوقة عشية وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الخليج العربي، بداية الأسبوع المنصرم، في أول زيارة خارجية له منذ إعادة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية قبل بضعة أشهر.
هذه التطورات التي جرت لم تكن متوقعة من قبل، ويُرتقب أن تكون لها تداعيات مهيكلة على توازنات القوة في المنطقة وبنية النفوذ فيها.
فمن جهة، واصلت دول الخليج تعميق تحالفاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أبدت استعداداها لتقديم المال الوفير (4 تريليونات دولار) مقابل السلاح والتكنولوجيا المتقدمة والنفوذ الإقليمي، وهي معادلة تعكس تقاطعا عميقا للمصالح بين أمريكا ودول الخليج، كما تؤكد مجددا محورية المملكة العربية السعودية ثم الإمارات وقطر.
ومن جهة ثانية، أقدم ترامب على خطوات مفاجئة، منها إبرام صفقة مع جماعة الحوثي في اليمن دون إخبار إسرائيل أو حتى أخذ مصالحها بعين الاعتبار، بحيث استمرت الجماعة، بعد الاتفاق، في قصف البنيات التحتية لإسرائيل بصواريخ بالستية، وكذا العودة إلى الحوار المباشر مع حركة حماس من أجل صفقة جديدة، يبدو أن أول خطوة فيها حتى الآن إطلاق سراح الجندي عيدان ألكسندر، ذو الجنسية المزدوجة.
أما التطور الأكثر إثارة فهو إعلان ترامب وسط حشد من رجال المال والأعمال في العاصمة السعودية الرياض عن إلغاء العقوبات القاسية على سوريا، ثم استقبال رئيسها أحمد الشرع في اليوم الموالي برعاية سعودية تركية، ودون الالتفات مرة أخرى إلى مواقف إسرائيل ومخاوفها.
علاوة على كل ذلك، تزامنت زيارة الرئيس ترامب إلى منطقة الخليج العربي، مع تصريحات لمسؤولين أمريكيين وإيرانيين عن تقدم مطرد في المفاوضات بين البلدين، يُرتقب أن تفضي إلى صفقة جديدة حول البرنامج النووي الإيراني مقابل إدماج إيران في النظام الاقتصادي الليبرالي الغربي.
ولا يمكن أن نغفل عن تطور هام كذلك، يتعلق بإعلان حزب العمال الكردستاني عن حل نفسه في تركيا استجابة لدعوة سابقة من زعيمه عبد الله أوجلان، والتي مكنت تركيا والعراق من الوصول إلى اتفاق مشترك وشامل حول الورقة الكردية أبرم في 13 مارس 2025.
أخذا بعين الاعتبار كل التطورات الكبرى المشار إليها، والتي تعكس تقاطعا في المصالح المشتركة للقوى الفاعلة في المنطقة والولايات المتحدة الأمريكية، يمكن القول إن زيارة ترامب قد وضعت اللبنات الرئيسة لشرق أوسط جديد، قوامه الاعتراف بالنفوذ للقوى الإقليمية الرئيسة فيه، وهي السعودية وتركيا وإسرائيل وإيران، لكن الملاحظ أن تلك الترتيبات لا تشمل جميع القوى الفاعلة في المنطقة، إذ تبدو مصر خارج الطاولة حتى الآن في حين يصعب تجاوزها أو إهمال دورها المحوري في المنطقة، كما أن تلك الترتيبات لا يبدو أنها ترضي قوى أخرى مثل إسرائيل وإيران. وعليه، بقدر ما تبدو التطورات المرتبطة بزيارة ترامب كبيرة ومهيكلة للمنطقة، إلا أن عدم شموليتها قد يدفع القوى المتضررة منها إلى مقاومتها وربما إسقاطها في المدى المنظور.
محورية الخليج
أظهرت زيارة ترامب إلى السعودية ثم الإمارات وقطر محورية دول الخليج العربي في المنطقة، أولا بفضل الموارد النفطية الهائلة التي يتوفرون عليها، كون النفط والغاز موارد استراتيجية للاقتصاد العالمي. وثانيا، بالنظر إلى إمكاناتهم المالية الكبيرة، التي تجعل منهم قوة استثمارية هائلة. وثالثا، حاجتهم إلى حلفاء للحماية والإسناد، خصوصا من الغرب، بالنظر إلى محدودية موارد القوة الأخرى لديهم، ولعل القواعد العسكرية الغربية المنتشرة في الخليج دليل قوي على ذلك. ورابعا، غياب منافس عربي صلب وقوي بعد تحييد مصر بعد اتفاقية كامب ديفيد سنة 1978، ثم العراق باحتلالها سنة 2003، ثم سوريا بعد 2011. وأخيرا، لكون دول الخليج باتت تملك الرؤية والإرادة في لعب دور إقليمي، خصوصا بعد وصول قيادات جديدة إلى الحكم في بعض تلك الدول، ممن لديهم طموح في توظيف موارد الخليج النفطية والمالية، وعلاقاتهم السياسية والاستراتيجية، من أجل ممارسة النفوذ وإدارة المنطقة.
لا تنطبق تلك الاعتبارات على معظم دول الخليج، بل على بعضها فقط. يتعلق الأمر تحديدا بالدول التي زارها ترامب أخيرا، أي السعودية وقطر والإمارات. وهي دول تملك استراتيجيات متباينة بل متناقضة. فالسعودية، مثلا، ظلت باستمرار قوة أساسية في المنطقة، ربما عانت من ضغوط قوى إقليمية أخرى في العقود الماضية، خصوصا من النظام الناصري في مصر ثم البعثي في العراق وسوريا، إلا أنها لم تتنازل عن دور القوة الإقليمية وظلت توظف مركزيتها الدينية، وقوتها النفطية والمالية، وتحالفاتها الاستراتيجية مع أمريكا، لفرض رؤيتها الإقليمية منذ السبعينيات من القرن الماضي على الأقل. اليوم يبدو أنها تملك رؤية أوسع لدورها، خصوصا منذ وصول الملك سلمان إلى الحكم في يناير 2015 مرفوقا بابنه الأمير محمد الذي عينه وزيرا للدفاع ثم وليا للعهد ابتداء من يونيو 2017. والذي صار خلال أقل من عشر سنوات مركز القوة الرئيسي في النظام السعودي، ويبدو أنه يسعى إلى المركز نفسه في النظام الإقليمي.
يستمد محمد ابن سلمان قوته من تماسك النظام السعودي واستقراره، ومن شرعية النظام الدينية والسياسية، كما يستمدها من مركزية السعودية في المنطقة كقوة مالية وسياسية ودينية، وأيضا من حلفائه خارج المنطقة ومنهم ترامب نفسه. وهي الموارد الذي يوظفها من أجل تغيير الداخل السعودي، سواء بالتحالف مع قوى جديدة مثل النساء والشباب، أو عبر تحجيم نفوذ المؤسسة الدينية، وتعبئة النخب الليبرالية في الدولة والمجتمع لصالحه، وفق تصور تحديثي قسري وصارم، لا مكان فيه للحريات السياسية مثلا. كما يسعى إلى الإمساك بخيوط اللعبة الإقليمية بين يديه، سواء عبر وسائل الردع العسكري والأمني كما فعل مع جماعة الحوثي في اليمن أو في حصاره لقطر ومع إيران وكل القوى المجتمعية المناوئة لرؤيته، أو عبر وسائل اقتصادية ومالية كما هو نهجه مع مصر وتركيا والأردن. وهي المساعي التي تتم تحت شعارات الأمن والاستقرار والتنمية، وإنهاء الحروب التي تعاني منها المنطقة، وتعزيز فرص الاستثمار والازدهار، كما عبّرت عن ذلك قمة جدة لسنة 2022 بحضور الرئيس الأمريكي السابق بايدن.
ويبدو أن هذه الرؤية حظيت بدعم ومباركة ترامب، كما تدل على ذلك تصريحاته في زيارته الأخيرة، إذ كال الكثير من المديح للأمير محمد بن سلمان ولإنجازاته، التي جعلت السعودية كما شادها في 2017 تختلف تماما عن السعودية كما شاهدها في 2025 على حد قوله. في العمق، تنطوي زيارة ترامب إلى السعودية، كمحطة أولى في جولته الخليجية، دعما غير محدود لسياسات ولي العهد محمد بن سلمان في الداخل تعزز طريقه نحو التتويج ملكا، ودعما أقوى للدور الإقليمي للمملكة العربية السعودية في المنطقة.
فالاتفاقات المعلنة بين السعودية وأمريكا حول الطاقة النووية والسلاح والتكنولوجيا المتقدمة، والتي قد تصل كلفتها إلى 600 مليار درهم، وربما تريليون دولار، تجعل من السعودية القوة الإقليمية الرئيسية في المنطقة، ربما تتفوق على معظم جيرانها، ويمنحها نفوذا غير مسبوق، خصوصا أنها انتزعت كل تلك الوعود بدون التطبيع مع إسرائيل. أما التوافقات التي تمت بين ترامب والأمير بن سلمان حول ملفات المنطقة، وخصوصا حول سوريا وفلسطين وإيران، فهي تؤكد هذا الدور الإقليمي للسعودية بل تعظمه.
لكن منح السعودية دور القوة الإقليمية في المنطقة من لدن ترامب، لا يعني الهيمنة المطلقة على الشرق الأوسط، بل يتعلق الأمر بتوازنات جديدة، كما سبقت الإشارة. في هذا الإطار مثلا تأتي زيارته إلى قطر والإمارات، اللذان يمثلان قوى صغيرة متنافسة في المنطقة. زيارة ترامب إلى قطر هي الأولى من نوعها لأول رئيس أمريكي، أولا، لكونها تحتضن أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، وثانيا لكونها موردا رئيسيا للغاز الطبيعي في العالم، وثالثا باعتبارها قوة مالية لا يُستهان بها، كما أن الزيارة، رابعا، تنطوي على اعتراف أمريكي بدورها الإقليمي، سواء كوسيط فعال في أزمات المنطقة من ملف (غزة، أفغانستان…)، أو بوصفها نقطة توازن بين القوى الأساسية فيها، أي السعودية وتركيا وإيران وإسرائيل. وقد يكون هناك عامل خامس يتعلق برغبة ذاتية من ترامب في المصالحة مع قطر، فهو من أعلن دعم حصارها في سنة 2017، قبل أن يتراجع عنه تحت ضغط وزارتي الدفاع والخارجية في بلاده.
قطر والإمارات
تعكس الاتفاقات المبرمة بين ترامب وقطر هذه المضامين، بحيث انتزع منها 10 ملايير دولار لدعم القاعدة العسكرية الأمريكية في “العديد”، على أساس أن تتحمل الدول الحليفة كلفة الحماية والأمن، وهي الرؤية التي سبق له تفعيلها في العلاقة مع اليابان وكوريا الجنوبية في مارس الماضي. ويبدو أن الاتفاقات العسكرية والأمنية مع باقي دول الخليج تقوم على الفكرة ذاتها، أي تمويل الحلفاء الصغار للقواعد العسكرية الأمريكية فوق أراضيها. كما انتزع من قطر اتفاقية مع شركة “بوينغ” للطيران، بكلفة تناهز 200 مليار دولار، وهي أضخم اتفاقية تجريها الشركة مع أي زبون أجنبي. ناهيك عن التزام قطر باستثمارات تناهز 1,2 تريليون دولار في قطاعات الدفاع والطاقة والتكنولوجيا المتقدمة.
من دون شك لن تكون تلك الأموال بدون مقابل، فقطر، مثل غيرها من الدول، لا توزع الهدايا والصدقات، بل لديها مصالح استراتيجية في المنطقة، لعل أبرزها تعزيز دورها الإقليمي في مواجهة خصومها ومنافسيها على رأسهم الإمارات، وتمتين تحالفاتها مع تركيا وسوريا وفي السودان وليبيا، وربما إيران أيضا، ومع القوى المدنية والإسلامية في المنطقة، وهو الدور الذي يلقى تأييدا من قبل بعض الدول، ويرفضه البعض الآخر.
ويبدو أن زيارة ترامب لقطر اقتضت زيارة الإمارات، وربما العكس. كون الأخيرة تشكل فاعلا إقليميا كذلك، بل حاملة لمشروع إقليمي مناقض للأولى. تشكل الإمارات قوة مالية ونفطية، وظفتها في بناء قوة اقتصادية قائمة على التجارة الحرة، وعلى شبكة من الموانئ العالمية، وعلى القوة الصلبة كذلك، بحيث توظف القوة العسكرية للتدخل من أجل تحقيق ما تعتبره مصالح لها، كما حصل في السودان واليمن وفي الصومال. وتعتقد القيادة الإماراتية أن بإمكان فعالية الأدوات التي تتوفر عليها أن تؤثر بها في القوى العالمية والإقليمية، بل توجيه سياساتها في الشرق الأوسط لتكون في صالح الإمارات والمنطقة. وتحاول منذ سنوات التأثير في سياسات إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية تحديدا، عبر ضخ الاستثمارات وبناء مصالح اقتصادية استراتيجية.
في هذا الإطار عبّرت الإمارات عن استعدادها لاستثمارات بقيمة 1,4 تريليون دولار في الولايات المتحدة الأمريكية على مدى العشر سنوات المقبلة، فضلا عن تشبيك مصالح معتبرة مع شركات ترامب وعائلته. وفي حال نجح البلدان في تحقيق هذا الهدف، قد تصبح الإمارات المستثمر الأول عالميا في أمريكا، أي قبل اليابان التي تصل حجم استثماراتها إلى 1,3 تريليون دولار، والصين بـ764 مليار دولار. لذلك، تبدو زيارة ترامب إلى الإمارات ليسا مجرد خطوة تقتضيها سياسات توازن القوى والنفوذ في الخليج والمنطقة بين الإمارات وقطر والسعودية. بل تنطوي على دعم وتأييد للمشروع الإماراتي كذلك، الذي بات النموذج المغري لدى جزء من قوى الرأسمال العالمي، ولدى اللوبي الصهيوني وإسرائيل كذلك، فضلا عن أنه يشكل قوة توازن في المنطقة.
لنلاحظ، انطلاقا مما سبق، أن سياسات ترامب اتجاه القوى الخليجية الثلاث تستوعبها جميعا، ما دامت تتكلم لغة المال و”البزنس”، علما أن مشاريعها الإقليمية متناقضة، خصوصا ما بين قطر والإمارات، رغم المكانة الأسمى للمملكة العربية السعودية. ولنلاحظ ثانيا أن خطابات ترامب في جولته إلى الدول الثلاث لم تتحدث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، بل دعا إلى استبعاد البعد الحقوقي صراحة في خطابه الرئيسي في السعودية، لأنه يدرك أن التناقضات قائمة والديمقراطية في الخليج ليست خارج التفكير والخيال. والملاحظة الثالثة تتعلق بتوزيع للنفوذ والملفات، فسوريا باتت في يد السعودية وتركيا، أما ملف غزة وحركة حماس فقد احتفظت بها قطر، وفي الإمارات أعلن دعم المقاربة التي يفضلها الشيخ محمد بن زايد، وترمي إلى تحويل غزة إلى مركز تجاري واقتصادي عالمي. كما احتفظت السعودية بموقفها الرافض للتطبيع دون اعتراف إسرائيل بالدولة الفلسطينية على ضوء مبادرة السلام العربية.
لكن لا يبدو أن هذه المقاربة الترامبية الجديدة ستصمد طويلا، أولا لأنها مغرقة في الاقتصادوية، بحيث ظهر ترامب كأكبر صياد للأموال في العالم، إذ جمع في خمسة أيام نحو 4 تريليونات دولار، وهو رقم ضخم يعكس هواجسه بشأن الوضع الاقتصادي والمشاكل الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية ناتجة عن تراكم الديون والتضخم وبطء النمو الاقتصادي. وثانيا لأنها تهمش بعض القوى الأساسية في المنطقة مثل مصر، علما أنها مقاربة لم ترض قوى أخرى مثل إيران وإسرائيل، والتي قد تضطر إلى القبول بها لكن مؤقتا فقط، ويجعل من الهندسة الترامبية للمنطقة قائمة على توازنات هشة.
توازنات هشة
لقد أكدت زيارة ترامب محورية الخليج في المنطقة العربية، لكن وفق رؤية غير مكتملة وهشة. في سنة 2017، استضافت السعودية ترامب في ثلاث قمم: قمة أمريكية سعودية، وقمة خليجية أمريكية، وقمة عربية أمريكية. ووعدت باستثمارات تفوق 450 مليار دولار. بين تلك الزيارة وزيارة ماي 2025، تغيّرت الكثير من الأوضاع في المنطقة، فالأمير محمد بن سلمان أعاد النظر في الكثير من خياراته الإقليمية (المصالحة مع إيران، تجميد الحرب في اليمن، رفع الحصار عن قطر، المصالحة مع تركيا..)، وهي مراجعة حصلت بعدما استتب له الأمر في الداخل السعودي كذلك. في النهاية، كل تلك الوعود الضخمة لترامب لم ينجز منها عمليا سوى 14,6 مليار دولار، وهو رقم هزيل مقارنة بالمبالغ الموعودة. هل يتكرر السيناريو نفسه؟ من المرجح أن يحدث ذلك، فالتطورات الدولية والإقليمية متسارعة، والتنافس بين أمريكا والصين يتحول تدريجيا إلى صراع مفتوح، كما أن الالتزامات السعودية في الداخل والإقليم تتعاظم أكثر. وهي عوامل ستضغط من أجل التأثير في تلك الالتزامات والنوايا المعلنة، مهما بدت الآن مغرية وجذابة.
أضف إلى ذلك، تهميش قوى أساسية مثل مصر، وهي ملاحظة لا ينبغي إهمالها، ففي سنة 2017 كان الرئيس السيسي من أبرز من جلسوا حول الطاولة مع ترامب في العاصمة السعودية الرياض، بينما حضر هذه المرة الرئيس السوري أحمد الشرع. غياب السيسي حدث لافت. لكن ليست المرة الأولى التي تضع فيها أمريكا مشروعا مهيكلا للمنطقة وتستبعد منه مصر، ففي شتنبر 2023 أعلنت عن مشروع الربط الاقتصادي بين الهند وإسرائيل مرورا بدول الخليج والأردن، وهو مشروع للتجارة الحرة، سيكون في حال إنجازه ضربة قاصمة لقناة السويس، بينما المستفيد الرئيس منه هي الإمارات والهند وإسرائيل. وقد أغضب ذلك المشروع مصر قيادة وشعبا، كما أغضب تركيا، وفي النهاية أسقطته حركة حماس بهجوم السابع من أكتوبر. وإذا كانت سياسة ترامب في 2025 تريد إعادة توزيع للنفوذ في المنطقة بين قوى الخليج وتركيا وإسرائيل، فإن مصر لن تقبل بتهميشها بكل تأكيد، وقد تقاوم أي محاولة لجعلها تابعة لهذه القوة أو تلك، سواء كانت السعودية أو الإمارات أو غيرهما.
مما يساعد مصر على التحرك في هذا الاتجاه أن قوى أخرى أبدت رفضها لسياسات النفوذ الجديدة في الشرق الأوسط، خصوصا إسرائيل وإيران، وكذا قوى المقاومة الفلسطينية. فإسرائيل تبدو غاضبة من الاتفاقات التي أبرمها ترامب مع جماعة الحوثي في اليمن، كما عبّرت عن غضبها من التوافقات التي تمت حول سوريا بين السعودية وتركيا بإشراف أمريكي، ويبدو أنها غاضبة أكثر بسبب الحوار المباشر بين الإدارة الأمريكية وحركة حماس. في الملفات الثلاث، تبدو رغبة ترامب واضحة في تحجيم نتنياهو وربما إسرائيل، وهي مصلحة تسعى إليها قوى أخرى مثل السعودية وتركيا وقطر. لكن لا يعني ذلك أن إسرائيل ستقبل وتستسلم لخطط ترامب وتصوراته، بل المتوقع أن تقاوم وترفض وتعاند من أجل إعادة رسم اللعبة مجددا.
وتعد إيران أيضا من القوى الخاسرة مما يجري، إذ خسرت نفوذها في سوريا ولبنان، وهي مضطرة للتفاوض حول برنامجها النووي تحت تهديدات بالحرب. وفي انتظار الصفقة المتوقعة بينها وبين ترامب، يصعب القول إن إيران ستوافق على تحجيم نفوذها في المنطقة، وخصوصا الخروج من العراق وسوريا واليمن نهائيا. ومن المرجح أنها ستقاوم بدورها مخططات ترامب، من أجل الحفاظ على نفوذها الإقليمي خصوصا في العراق على الأقل. وهو الموقف نفسه الذي قد تنحاز إليه قوى المقاومة الفلسطينية، خصوصا وأن مواقف ترامب إزاء حل الدولتين غامض لحد الآن.
خلاصة القول أن جولة ترامب بقدر ما حصدت من أموال موعودة، قد تجعل دول الخليج الثلاث فاعلا مؤثرا في السياسة الخارجية الأمريكية اتجاه الشرق الأوسط، وتمنحها تفوقا جيوسياسيا غير مسبوق على قوى أخرى في المنطقة مثل إسرائيل، إلا أن التركيز على الصفقات التجارية والاقتصادية وحدها لإعادة تشكيل منطقة الشرق الأوسط، سيظل خيارا محدود النتائج، بالنظر إلى تعقيدات ملفات المنطقة ذات الطابع السياسي والجيوسياسي. كما أن تهميش قوى تقليدية ورئيسية في المنطقة مثل مصر وإيران سيجعل كل التسويات مؤقتة، مرتبطة بالأشخاص والمقاربة القصيرة المدى، أكثر مما هي مرتبطة بالمؤسسات والتوجهات البعيدة المدى.