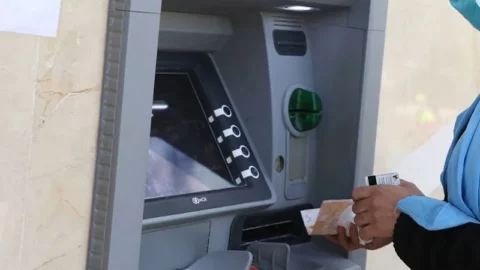تعود لما قبل التاريخ.. ظهور فنون صخرية وأول مقبرة كِست مؤرخة بالكربون في طنجة

في اكتشاف بارز، كشف علماء آثار النقاب عن مقابر قديمة، وأحجار منتصبة، وعناصر من الفن الصخري في طنجة، تعود إلى ما بين عامي 3000 و500 قبل الميلاد.
وتشمل الاكتشافات، وفقاً لمقال نُشِر على مجلة “سبرينغر نيتشر“، مقبرة من نوع “كِست” يتم تأريخها بالكربون المشع في شمال غرب إفريقيا، بالإضافة إلى نقوش فريدة توحي بوجود تقاليد جنائزية وطقوسية معقدة.
ويسعى البحث، الذي أعده كل من حمزة بناتية من جامعة برشلونة، وخورخي أونروبيا-بينتادو من جامعة قشتالة لا مانتشا، ويوسف بوكبوط من المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث، إلى فهم الديناميكيات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية لأواخر عصور ما قبل التاريخ في المنطقة، وعلاقاتها بشبكات أخرى متوسطية وأطلسية، وذلك من خلال المسح والتنقيب، بناء على العمل الميداني المنجز في إطار مشروعي “تحضارت” و”كاش كوش” الأثريين.
وبحسب المصدر ذاته، فإن هذا الاكتشاف يجسد الاتصال بين أوروبا وإفريقيا، في طنجة كمعبر بين القارتين، بين حوالي 3000 و500 قبل الميلاد، من خلال وجود فسيفساء غنية من التقاليد الجنائزية، والمواقع الرمزية، وفنون الصخور، والنُصُب الصخرية الفريدة التي تتجاوز التقسيمات القارية الحديثة المفروضة.
وتستنتج الدراسة، بواسطة العمل الميداني، والتأريخ بالكربون المشع، والتحليل المعتمد على نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، أن المشاهد الطقسية في شبه جزيرة طنجة أكثر تعقيداً وانتشاراً مما كان يُعتقد سابقاً، مع وجود أوجه شبه وثيقة مع جنوب إيبيريا في أواخر عصور ما قبل التاريخ، وكذلك مع الصحراء الكبرى.
ومن أبرز ما تضمنه الاكتشاف الجديد، اكتشاف قبر من نوع “كست” على شكل شبه منحرف، مبني بأربعة ألواح حجرية رملية موضوعة بشكل عمودي ولوح كبير للتغطية، كما تبرز حفرة على شكل هلال مليئة بالحجارة إلى الشرق من البناء، يحتمل أنه قد تكون استُخدمت كنقطة وصول إلى القبر.
وتعد هذه العملية أول تأريخ بالكربون المشع لقبر كيست في شمال غرب إفريقيا، وتحديداً في موقع داروة زيدان. ويعرف هذا البحث ببداية استخدام هذه التقاليد الجنائزية منذ العصر البرونزي المبكر. إذ نجح الباحثون في تأريخ إحدى العظام المستخرجة بالكربون المشع، ما مكن من وضعها في الفترة بين عامي 2119 و1890 قبل الميلاد، ما يجعل الدفن يعود إلى العصر البرونزي المبكر.
وقد أظهرت التحاليل النظيرية أن النظام الغذائي للفرد كان يعتمد أساساً على الموارد الأرضية، بما في ذلك البروتينات الحيوانية والنباتات من نوع C3، مع اعتماد محدود جداً على الموارد البحرية.
وتُعد هذه الأدلة الجديدة، وفقاً للباحثين، تحدياً للسرديات السائدة، مسلطين الضوء على الحاجة إلى إعادة تقييم التحيزات الاستعمارية التي شكّلت الخطاب الأكاديمي في علم آثار شمال إفريقيا.
ويبرز البحث أيضاً، من خلال تسليط الضوء على الديناميكيات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية في شمال غرب إفريقيا، الدور المهم للمنطقة في الشبكات العابرة للأقاليم، ويقدم رؤى جديدة لفهم ديناميكيات أواخر عصور ما قبل التاريخ في غرب البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي الداخلي.
وبحسب الأدلة والبيانات التي وصل إليها البحث، يخلص هذا الأخير ما يشير إلى أن المنظومة الطقسية المعقدة والمتطورة في نفس الوقت بين نحو 3000 و500 قبل الميلاد في شبه جزيرة طنجة، شملت تنوعاً كبيراً في المواقع الطقسية والفنون الصخرية وأنماط الدفن، بما في ذلك الدفن في الحفر، والكهوف، والسراديب، والصناديق الحجرية، والمقابر التلية.
وتجد هذه الممارسات الجنائزية المتنوعة نظائرها الأقرب على الجانب الآخر من المضيق، في جنوب أيبيريا، ما يثير تساؤلات “حول ما إذا كانت هذه التشابهات تعكس ديناميات اجتماعية وثقافية مشتركة بين المنطقتين”.
وأشار الباحثون إلى أن استعمال الصناديق الحجرية استمر في شبه جزيرة طنجة منذ 2100 قبل الميلاد على الأقل وحتى حوالي 400 قبل الميلاد، في الوقت الذي اختفت فيه بجنوب أيبيريا منذ أواخر الألفية الثانية قبل الميلاد، لتحل محلها الطقوس الجنائزية التي تعتمد الحرق في الألفية التالية.
وأوضحوا أن اكتشاف مقابر جديدة للصناديق الحجرية، غالبًا عند تقاطعات طرق رئيسية، يشير إلى أن هذه المقابر كانت تعمل كعلامات إقليمية لمجتمعات تتنافس على الأرض في سياق من تزايد النزعة الإقليمية.
ورغم وجود أدلة على مستوطنات ما قبل التاريخ المتأخر في شبه جزيرة طنجة، فإن الربط بين مواقع الاستيطان المفتوحة والمقابر “لا يزال هدفاً لم يتحقق بعد في أبحاث ما قبل التاريخ المتأخر في شمال إفريقيا، بخلاف الوضع عبر المضيق، حيث تعتبر العلاقة بين المستوطنات والمقابر أمراً شائعاً.
وتساءل الباحثون على ضوء وجود صناديق حجرية داخل بعض التلال في كل من شمال إفريقيا وجنوب أيبيريا، بشأن ما إذا كانت هذه التلال قد تطورت من التقاليد الجنائزية السابقة للصناديق الحجرية أم أنها نشأت بشكل مستقل.
ورجحوا أن تكون هذه التلال قد بنيت كمدافن ضخمة أو كمدافن خضعت للتضخيم الرمزي، مشيرين إلى أنها قد تكون “انعكاساً لتحولات اجتماعية واقتصادية مرتبطة بظهور أشكال جديدة من التنظيم السياسي في المنطقة”.
ومع أن ندرة البيانات المتعلقة بمجتمعات شمال غرب إفريقيا خلال ما قبل التاريخ المتأخر “تعيق فهماَ أعمق لدينامياتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية طويلة الأمد”، فإن فهم ديناميات الألفية الثانية قبل الميلاد، وفقاً للباحثين “يظل أمراً حاسماً لتقييم التطورات الإقليمية اللاحقة خلال الفترة الموريتانية، التي اتسمت بتبلور أنظمة ملكية ذات طابع هلنستي في جنوب غرب المتوسط”.
أما بخصوص الحجارة القائمة، والفنون الصخرية، والممارسات الطقسية التي تم اكتشفاها إلى جانب المقابر في الأنهار والكهوف، فتشير وفقاً للبحث إلى منظومة رمزية واجتماعية أوسع لم تُستكشف بعد بشكل كافٍ.
وتمت دراسة هذه العناصر بشكل تقليدي منفصل، “غير أن علاقاتها المكانية تشير إلى احتمالات وجود ترابطات فيما بينها”، خاصة من حيث توزعها على طرق المواصلات الرئيسية وعند نقاط التقاطع، كما أظهرت تحليلات نظم المعلومات الجغرافية (GIS).
وبينما تسلط هذه الأنماط المكانية الضوء على إمكانياتها الرمزية والإقليمية، فإن محدودية الأدلة المتاحة “لا تسمح باستخلاص استنتاجات قاطعة”، إذا أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث.
هذا وتؤكد مواقع الفن الصخري المكتشفة حديثاً أهمية هذه المنطقة في دراسة الرمزية ما قبل التاريخ، وتشير وفقاً للبحث إلى أن جبال الريف قد تضم مئات الملاجئ المزينة التي لم تُوثق بعد.
ويكتسب الفن الصخري في شبه جزيرة طنجة “أهمية خاصة نظراً لما يُظهره من تشابهات واضحة مع فنون شمال المغرب الصخرية وكذلك مع مواقع في أوروبا الأطلسية، وخصوصاً جنوب أيبيريا، مما قد يدل على وجود اتصالات طويلة الأمد بين هذه المناطق”.
وفي سياق متصل، حذر الباحثون من الأضرار الجسيمة التي تلحق بالمواقع المعروفة والجديدة في شبه جزيرة طنجة، نتيجة للنهب والتوسع العمراني والممارسات الزراعية، مشيرين إلى أنها “تسلط الضوء على الحاجة المُلِحّة إلى جهود حفظ لحماية التراث الثقافي الغني لهذه المنطقة”.
ويعتبرون أن فقدان هذه المواقع “لن يمحو فقط أمثلة لا تُقدّر بثمن من تراث شمال غرب إفريقيا الثقافي، بل سيعوق أيضاً قدرة الباحثين على فهم الديناميات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المعقدة لهذه المنطقة”.