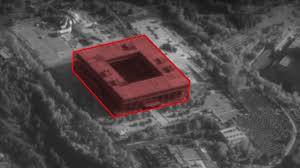بأي ذنب انتحرت؟
حين تصبح صخور الشاطئ القاتلة أرحم، في نظر بضعنا، من بني جلدتنا. من قاعة إحدى المؤسسات التعليمية حيث تجرى امتحانات البكالوريا، إلى جرف مطل على منحدر صخري في كورنيش مدينة آسفي. هناك ألقت بنفسها مخلّفة صدمة نفسية لأسرتها ولمحيطها، وصفعة وقوية في وجه مجتمع ينتظر منك كل شيء دون أن يمنحك، في الغالب، أي شيء.
الفتاة التي تركت رسالة صوتية تطلب فيه “المسامحة”، ألقت بنفسها يوم الاثنين 10 يونيو 2024 من أعلى جرف “أموني” الواقع في كورنيش مدينة آسفي، ليست “المنتحرة” الوحيدة في القصة. بل هي تجسيد لانتحار جماعيا نشارك فيه منذ سنوات، كل من موقعه.
هذه الفتاة لم تنتحر بسبب الضغط النفسي فقط، ولا بفعل الخوف من أسرتها أو محيطها وحده… بل انتحرت بسبب اختيارات متجاوزة وخاطئة نصرّ عليها في مناهج التعليم التي لا تمكّن أبناءنا من الوصول إلى يوم الامتحان مطمئنين إلى مكتسباهم، وطريقة التقييم ومعايير النجاح والرسوب، التي تجعل الغش ممكنا، وباستعمال هاتف محمول في اختبار متعلق بالغلة العربية.
هي أولا وقبل كل ذلك ضحية جريمة نرتكبها في حق الجيل الصاعد، حين نٌشهر في وجوههم صنوف العقاب والشرطة والقضاء والسجن… عندما يصدر عنهم ما لا نريد رؤيته، ولا تحمّل مسؤولياتنا فيه، من غش أو انحراف أو… مجرد غناء.
يتعلق الأمر حسب تصريحات المسؤولين المحليين، بفتاة كانت تتابع دراستها في إحدى ثانويات المدينة، في شعبة العلوم الإنسانية. توجهت التلميذة على غرار قرابة نصف مليون مترشح لاجتياز امتحان البكالوريا هذه السنة، إلى مركز الامتحان، وأثناء اجتيازها الاختبار الخاص باللغة العربية، جرى الاشتباه في ضبطها متلبسة باستعمال هاتف محمول، في ما يفترض أن يكون، محاولة للغش.
لا تفاصيل دقيقة وموثوقة يمكن اعتمادها هنا للجزم بمسؤولية هذا الطرف أو ذاك، لكن ما توفّر من تصريحات مسؤولين محليين، في المديرية الإقليمية والأكاديمية الجهوية، إلى جانب التسجيل الصوتي المنسوب للفتاة نفسها، وتصريحات والدتها… كل هذا يجعلنا أمام مشهد يكاد يلخص مأساتنا التعليمية والتربوية ويسائل أطرافها جميعا: دولة ومجتمعا.
أول ما يسائله هذا المشهد هو الإجراءات و”البروتوكول” المتّبع في مثل هذه الحالات، وهنا تصبح صرخات الأم متمتعة بكامل الشرعية، حين استنكرت إخراج ابنتها من مركز الامتحان وتركها في مواجهة “الخلا”.
هل يعقل أننا نتعامل بهذا المنطق الأمني المفتقد لأدنى حس إنساني أو ضمير أو حرص على سلامة ومصلحة المقبلين على الامتحان؟
التلميذ الذي يوجد داخل المؤسسة التعليمية، سواء للدراسة أو لاجتياز امتحان، هو “أمانة” من الأسرة والمجتمع في يد الدولة، سواء تعلّق الأمر بمؤسسة تعليمية عمومية أو خصوصية.
وبالرغم من كل ما بدا على الأم في تصريحاتها التي أعقبت الفاجعة من وقع للصدمة وتعبير تلقائي، إلا أنها نطقت بما يفترض أن يقوله العقل: “شدوها ولا ديوها للحبس لكن ما تخرجوهاش للخلا”!
يفترض أن هناك علاقة مباشرة بين المؤسسة التعليمية والأسرة، وعلينا أن نوفر جميع الإمكانيات حتى تقوم هذه العلاقة. ولا حجة لدينا في تبرير غياب هذه القنوات في عصر الانترنت والهواتف الذكية والواتساب… ولا ينبغي أن يقتصر الأمر على المؤسسات التعليمية الخاصة، التي تتوفر على قواعد بيانات بأرقام هواتف أولياء أمور التلاميذ وتتواصل معهم كلما كانت هناك حاجة إلى ذلك.
الطفل المغربي المسجل في المدرسة العمومي ليس كائنا “شايط”!
مهما كانت ردة الفعل التي يقدم عليها التلميذ الموقوف، تظل هذه المسؤولية قائمة ويفترض التواصل مع الأسرة وإشراكها، أو على الأقل توفير فضاء خاص باستقبال من يمكن أن يتحول إلى مصدر تشويش أو تأثير على السير العادي للامتحانات، مع إشعار التلميذ الموقوف بالأمان وبأنها ليست نهاية العالم، لا تخويفه كما يِفهم من التسجيل الصوتي للتلميذة المنتحرة، والتي تقول إن هناك منا قال لها “لم يعد بإمكانك اجتياز امتحان البكالوريا من جديد”.
في المقابل، من السهل للغاية تقمّص دور “الفاهيم” الذي يعطي الدروس للجميع ويؤنب الجميع بدعوى أن هناك ضغط تمارسه الأسر على أبنائها، وتضخيم لأهمية اجتياز البكالوريا…
هناك سياسات عمومية وواقع جماعي مفاده أن الأسر تبحث عن منافذ للنجاة بأبنائها من جحيم التيه والضياع الذي تخبرنا الأرقام الرسمية إن أكثر من أربعة ملايين من أبنائنا وقعوا فيه، أي أولئك الذين لا يدرسون ولا يعملون ولا يتابعون أي تكوين.
نحن متواطئون في إنتاج منظومة متكاملة تغلق الآفاق في أبناء المغاربة، وتحاصرهم بالضغوط لتجعل من الحصول على البكالوريا، واحدا من مفاتيح الإفلات من هذا المصير المشؤوم، عن طريق منظومة تعليمية لا نبدي أي قدر من الجدية تجاهها.
منظومة قائمة على الترقيع والبريكولاج الجماعي، كل من موقعه، للوصول إلى أرقام تفيد نجاح نسبة من أبناء المغاربة في الوصول إلى مستوي البكالوريا، دون وجود أي دليل أو مؤشر على اكتساب التلاميذ والتلميذات ما يؤهلهم لدخول حياة البالغين وتدشين مسار واعد في التعليم العالي أو سوق الشغل.
لا يمكننا أن نأتي اليوم ونلوم الأسر على إفراطها في السعي لحصول أبنائها على شهادة البكالوريا، بأي ثمن وكيفما اتفق، بينما منظومة التكوين والتأهيل لولوج السوق لا تعترف إلا بمنطق الشهادات والمعدلات والترتيب… دون أدنى اهتمام بالمهارات المكتسبة فعليا وببناء الشخصية، وعدم الحكم على قيمة الشخص انطلاقا من شهاداته ومعدلات نجاحه، وتنويع مسارات الاندماج…
هل يمكن لأي مشارك في العملية التربوية من جميع المستويات والنواحي، أن يزعم أن أبناء المغاربة “قراو شي زفتة” هذه السنة؟
الجميع يعلم أن السنة كانت ضائعة وشبه بيضاء، وأن التلاميذ في كثير من المؤسسات والأقاليم تمرّدوا على أساتذتهم وإدارات مؤسساتهم، ومنهم من رفض اجتياز امتحانات المراقبة المستمرة أو حضور الدروس…
لقد ساد مؤخرا منطق غير معلن، جعل التلميذ يفكّر بمنطق “لم تدرّسونا وبالتالي لا تمتحنونا”. وتواطأ الجميع، كل من موقعه، على “تمرير” السنة بأقل الأضرار. وساد الاعتقاد أن هناك توجه للتسامح مع الغش وتمكين أعلى نسبة ممكنة من النجاح للتغطية على ضعف التحصيل خلال السنة.
لقد ساد الاعتقاد أن الغاية النهائية للامتحانات هي أرقام ستعلنها الدولة حول عدد المترشحين ونسبة الناجحين… وأهم ما في الأمر هو اتفاق اجتماعي خلّف ضحايا من الأساتذة الموقوفين و… آلاف التلاميذ المطالبين بتدبّر أمرهم في الامتحانات.
على هذه الحفلة التنكرية الجماعية أن تتوفق. وعلى كل طرف أن يتحمل مسؤوليته. والأهم من كل ذلك أن هذه العصا الخشنة التي نشهرها في وجه الجيل الصاعد، في مقاربة أمنية عمياء، لن تسعفنا في إخفاء أعراض فشلنا المركّب، في التربية والتعليم والتنشئة السليمة على المواطنة والسلوك المدني.
خالص العزاء لأسرة الفتاة المنتحرة..
والله يحد الباس!