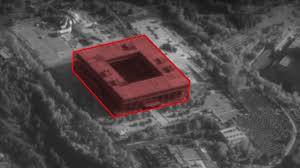الزفزافي.. حين يزور الابن أباه

في وطن الذي نحبّه كما لو كان حلما معلّقا بين السماء والأرض، بعض الأحداث لا تحمل قيمتها من وقعها المادي، بل من قدرتها على بثّ الرعشة في الشعور الجماعي، وعلى التسلّل إلى أعماق المعنى حين يكون اليأس قد بدأ يتسيّد الحاضر والمصير.
هكذا كانت الزيارة الثانية التي سُمح بها أول أمس الاثنين 14 يوليوز 2025، لناصر الزفزافي، المعتقل منذ سبع سنوات، إلى والده الذي يعاني مرضا عضالا ويخضع للعلاج في مدينة الحسيمة.
لم تكن زيارة عادية، ولا واقعة إدارية روتينية. بل كانت أشبه باستراحة روحٍ وسط صخب التاريخ، وبتنهيدة أخيرة قبل أن ينقطع النفس. لا لأهمية من زار أو من زاره فقط، بل لأن اللحظة اختزلت في جوهرها العلاقة المعقدة بين الدولة والمجتمع، وبين السلطة والشارع، وبين الأمل والانكسار.
قد يرى البعض في الذي جرى مجرد قرار إنساني مشكور، بينما يراها آخرون محاولة تهدئة عاطفية من جهاز إداري حذر. لكن خلف كل هذا، ثمة ما هو أبعد وأعمق: لحظة تستحق أن تُقرأ كتجلّ لنوع من التفكير الآخر، تفكيرٍ لا يسجن نفسه داخل المنطق الأمني أو البيروقراطي، بل يبدأ في مساءلة الطريق التي سلكناها، والعُقد التي ما زالت تمنع هذه البلاد من أن تتصالح مع نفسها بالكامل.
ليس سراً أن ملف “حراك الريف” كان، ولا يزال، من أعقد القضايا التي طبعت الحياة السياسية والاجتماعية في المغرب خلال العقد الأخير، ليس فقط بسبب ما رافقه من اعتقالات جماعية وأحكام ثقيلة، بل لأنه اختصر في لحظة واحدة تراكمات عميقة من التوتر البنيوي بين الدولة والمجتمع، ومن الشعور بعدم الاعتراف الذي ظلّ يلازم أطراف البلاد وهوامشها.
في تلك الهبّة التي انطلقت من محيط الحسيمة، لم تكن الشعارات المرفوعة تدور فقط حول المستشفى الموعود أو الجامعة الغائبة، بل كانت تعبّر عن قلق أعمق، وعن هوّة نفسية متجذّرة بين ما تتصوّره الدولة عن ذاتها ودورها، وبين ما يشعر به الناس إزاء حضورها في حياتهم اليومية.
لقد كانت لحظة مكثفة من تفجّر الوعي الجماعي داخل منطقة ما تزال تحمل الندوب التاريخية لعلاقات مأزومة مع المركز، وتستبطن في ذاكرتها الجماعية صورا من التهميش والإقصاء والتأديب الجماعي، منذ عقود الاستقلال الأولى.
ولعل الخطورة الكبرى التي حملها هذا الملف لم تكمن فقط في مضامينه الظاهرة، بل في رمزيته: كيف تتعامل الدولة مع الغضب؟ وكيف تتفاعل مع الاختلاف؟ وكيف تترجم خطاب المصالحة الوطنية، حين يوضع أمام اختبار عملي في منطقة لا تطالب بالانفصال بل بالكرامة والعدالة والاعتراف؟
بهذا المعنى، فإن “حراك الريف” لم يكن مجرد أزمة عابرة، بل لحظة كشف واسعة النطاق، أعادت إلى الواجهة أسئلة ظلّت مُؤجّلة لعقود: من يملك القرار في المغرب؟ من يُحاسب من؟ ومن يُمثّل من؟ بل ومن يُعترف له بحق الكلام، لا فقط داخل البرلمان، بل في الشارع والحي والمستشفى والمدرسة؟
وما دامت هذه الأسئلة قائمة، فإن أية معالجة تقنية أو قضائية للملف تظل ناقصة ما لم تُستكمل بإرادة سياسية صادقة لإعادة النظر في العلاقة بين الدولة والمجتمع، ليس بمنطق الصلح المؤقت، بل برؤية تؤسس لعقد اجتماعي جديد قوامه الثقة والمساواة والانتماء الفعلي لا الرمزي.
منذ أن انطفأت شعلة المظاهرات، لم ينطفئ السؤال: إلى أين نمضي بهذه الجراح المفتوحة؟ كم يلزمنا من الوقت حتى ندرك أن منطق الصرامة وحده لا يكفي لبناء وطن متماسك؟ وأن التخلي عن أبنائنا، وإلقائهم في السجون، ولو في لحظات غضبهم أو تمرّدهم، لن يكون أبدا الحل؟ وأن المصالحة لا تكتمل بإنشاء لجان أو إطلاق شعارات، بل بإصلاح العلاقة من جذورها، وتضميد الجراح بالفعل لا بالكلام؟
الزيارة الثانية لناصر الزفزافي إلى والده لا تقول ذلك صراحة، لكنها تهمس به. تخبرنا، بلغة المشاعر التي لا تحتاج إلى ترجمة، أنه ما زال في هذا البلد من يستطيع أن ينصت للإنسان قبل أن يقرأ التّهم.
إنه حدث يفتح الباب أمام سؤال أكبر: ألا يمكن تحويل هذه الإشارات إلى مسار؟ ألا يمكن أن تصبح لحظة إنسانية عابرة، مثل لقاء ابن بأبيه، بداية لعهد جديد، عهد تتقدم فيه الدولة بشجاعة المصالحة، لا بجبن التغاضي؟ عهد يُقال فيه للمعتقلين: لقد سمعناكم، حتى وإن كنّا نختلف معكم، وها نحن نمدّ اليد لنعيد ترميم ما تكسّر؟
لقد ملّ المغاربة من العناوين التي تَعد ولا تُنجز، ومن الملفات التي تفتح ولا تُغلق، ومن الرماد الذي يُذرى على الجراح كما يذرّ الرماد في العيون.
المغاربة اليوم في حاجة إلى إشارات جديدة على أن ما ضاع يمكن استدراكه، وأن المستقبل لا يكون بالضرورة امتدادا للنكبات، بل قد يكون انبعاثا من رمادها.
ومن أعظم الفرص المتاحة اليوم، تلك التي تمنحنا إياها لحظات كهذه: فرصة إعادة فتح ملف حراك الريف، لا بمعنى قضّ مضاجع الماضي، بل بنية إنهائه بشكل مشرّف، يعيد الأمل، ويمنح الوطن فرصة ثانية ليحتضن أبناءه الذين أُقصوا بالأمس، دون أن يتخلّى عن نفسه.
ليس هناك أجمل من وطنٍ يعرف كيف يطوي الصفحات السوداء، لا لأنه ضعيف، بل لأنه قوي بما يكفي لكي يتجاوز. وليس هناك أعظم من دولة تُدرك أن الحفاظ على اللحمة الوطنية لا يتم بفرض الولاء، بل بضمان الحق في الاختلاف، وتوسيع مساحة الانتماء لتشمل حتى الغاضبين.
قبل عام كامل من الآن، كنا نحلم ونأمل ونترجى أن يتم طي كل الملفات الأليمة في ذكرى عيد العرش، فتم ذلك، لكن جزئيا فقط، مع قرار العفو عن زملائنا الصحافيين..
واليوم، هذه ليست دعوة، وليست رسالة، إنها فقط قراءة في لحظة.
لحظة بدا فيها أن هذا البلد لا يزال قادرا على استدعاء أجمل ما فيه.. إذا إراد.