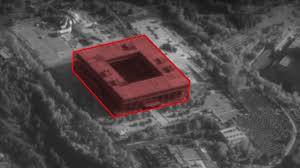ليلك طويل يا وطني!
آمنت دائما أن أحسن من يكتب الرواية هم اللذين يقتحمون عالم الكتابة والأدب من حقول معرفية أخرى مختلفة. وأفضل من قرأت لهم الرواية هم إما أطباء أو مؤرخون أو علماء اجتماع وسياسة واقتصاد…
لا يمكنك أن تعتبر رواية لعبد الله العروي مجرد رواية تقرأها للمتعة والتسلية، ولا روايات حسن أوريد مجرد فنتازيا أو استيهامات، تماما مثلما التحق أخيرا المؤرخ المرموق محمد حبيدة بكتّاب الرواية، فحلّق عاليا منذ خفقة جناحيه الأولى بروايته “عشتُ ثلاثَمئة عام”.
مع هؤلاء تقرأ أكثر من مجرد اللغة المنمقة والسرد الأنيق والخيال الواسع. تقرأ واقعا مزيدا ومنقحا، لا خيالا منفلتا من عقال المنطق، مع احترامي لمتذوقي أدب الأدباء المحترفين.
في رواية حبيدة الجديدة، لن تغيب شخصية المؤرخ عن ذهنك وأنت تتقدم بين فصول الرواية الجديدة، كما لو أن الرجل أعياه التعبير بكتب الفكر، ففتح نافذة كبيرة عبر هذه الرواية، لنتنفّس معه نسيما فيه خليط من كل ما كتب ودرس ودرّس في السابق.
لا يمكنك أن تقرأ “عشتُ ثلاثَمئة عام” دون أن تصادف حبيدة، صاحب كتاب “تاريخ أوربا: من الفيودالية إلى الأنوار”. تقابل مستفزّ يصاحبك طيلة فصول الرواية بين الأنا الجماعية والآخر. رغم أن هذا الآخر تجسده شخصيات الأسرى الأوربيين في مغرب ما قبل ثلاثة قرون، إلا أن الكاتب يفلح في منحك شعورا بأننا كنا نحن الأسرى وليس الآخر. أسرى التقليد والجمود والتكلّس والسير عكس مجرى التاريخ.
لا تستطيع قراءة الرواية دون أن تصادف بين صفحة وأخرى صاحب كتاب “المغرب النباتي: الزراعة والأغذية قبل الاستعمار”. حتى أن بطل الرواية، عاشور الملقّب ب”شاهين”، يكشف عن طبعه النباتي في الغذاء، وهو علي مائدة باشا مدينة مكناس في عهد السلطان مولاي إسماعيل. يعلنها البطل بكل جرأة وهو أمام مشهد الخروف المشوي المقدّم للضيوف الأوربيين، مكتفيا بما فوق الطاولة من حواشي نباتية لإسكات جوعه.
لن تقرأ رواية محمد حبيدة دون أن تشعر كيف يفرّغ بين فصل وآخر شحنة غضبه من وضع المرأة في المجتمع المغربي، وكيف يستمر هذا الوضع متأقلما مع تحوّلات التحديث، لا الحداثة. تلمس حنقه من تجديد هيمنة ذكورية لا يرى فيها الكاتب سوى تكريسا لخشونة وبؤس ما كان لهما أن يبسطا سيطرتهما لو كانت المرأة المغربية تتمتع ببعض ما تتمتع به “مريّة”، تلك الأوربية صاحبة الحانة التي يتردد عليها النصارى في مدينة مكناس. بل إن الرواية تِشعرك دون تكلّف كيف يستمر مشهد الحرث الذي تابعته عين “شاهين” ومن معه من الأسرى الأوربيين خلال رحلته من سلا إلي مكناس، لذلك الرجل المغربي الذي يحرث أرضه ب”جوج” تتشكل من حمار و.. امرأة، يجرّان المحراث ويلهثان تحت ضربات السياط.
رغم بدايتها الفنتازية، لذلك المريض الذي يلج مستشفى العاصمة الرباط، قادما ضمن ضحايا انهيار ثلجي في عمق جبال الأطلس، ليتبيّن أنه كان “مجمّدا” طيلة قرون ثلاثة تقريبا، نتيجة انهيار ثلجي سابق، ثم عاد إلى الحياة.. سرعان ما ينغمس حبيدة بقرائه في الفصول اللاحقة في خيال أكثر واقعية من الواقع نفسه.
يأخذنا البطل الذي “عاش ثلاثمئة عام”، في استعادة دقيقة لحياته السابقة، منطلقا من سلا، مدينة القراصنة والعلماء والأسرى والعلوج، إلى عاصمة السلطان مولاي إسماعيل، مكناسة الزيتون، فتشعر كما لو أن حبيدة قام بتجميع شظايا كل ما تعلّمه ودرسه عن تاريخ المغرب في تلك الحقبة القريبة-البعيدة، وأذابه في إناء واحد ليصنع لنا في النهاية صورة متحرّكة ومقرّبة، تشعرك كما لو أنك عشت بالفعل ثلاثمئة عام وقمت بزيارة مطولة للأجداد.
لا نية لي في إفساد متعة القراءة على الذين ستقع الرواية بين أيديهم، لكنني لم أستطع الاحتفاظ برسالة النص لنفسي، لأنني وجدتها ثقيلة ومتعبة. رسالة ألا شيء، تقريبا، تغيّر فينا رغم التحولات الشكلية الكثيرة التي عرفناها في القرن الماضي على الخصوص.
الركون إلى الخرافة والقدرية في ملاحظة وتفسير العالم من حولنا، وعدم القدرة على تحويل اختلافاتنا وتناقضاتنا إلى طاقة مولّدة للقيمة، وسيرنا عكس اتجاه التاريخ، ودفعا الجماعي لضريبة عدم الحسم في أمور أساسية كمثل علاقتنا بالسلطة وكيفية تدبيرها… كانت هذه رسالة ما يرويه “شاهين” بين دفتي الرواية.
المغاربة الذين أداروا ظهورهم للبحر قبل قرون، في وقت كانت جل الحضارات الصاعدة تؤسس لأمجادها عبد الخوض في البحار والمحيطات، والمغاربة الذين لم يركبوا هذا البحر إلا للقرصنة والهجمات الظرفية المباغتة، هم أنفسهم المغاربة الذين يكادون لا يركبون البحر اليوم إلا ليغامروا مغامرتهم الأخيرة، “إما ربحة ولا ذبحة”.
المغاربة الذين استباحتهم الأوبئة والطواعين، واستأسدت عليهم الجرذان والصراصير، كما هو الحال في أحد فصول الرواية حين تكتشف أم أن فأرة ضخمة التهمت رضيعها ولم تترك منه سوى بقايا من أطرافه الفتية… هؤلاء هم المغاربة الذين يقتلهم اليوم شراب الماحيا، وتلتهم النيران أجسادهم في قلب مدينة فاس، ويختنقون داخل الساندريات بحثا عن بقايا فحم، وتنقلب بهم سيارات الشحن وهم في الضريق نحو ضيعات “الفيوداليين”….
المغاربة الذين كانت علاقتهم بالسلطة قبل ثلاثة قرون قائمة على الخوف لا الاختيار والاقتناع، وعلى الثورة والانتفاض كلما سنحت فرصة تغيير بيولوجي، والذين يتفرجون على مشهد الجلد والسحل في “ساحة الهديم”، وينتشون بمنظر الرؤوس التي عاد بها جنود المخزن من فاس التي تمرّدت بعد وفاة السلطان القوي… والمغاربة الذين يسلمون مقاليد أمورهم لعبيد ينصرون من يدفع أكثر ويعزلون من يصيبه عجز عن الدفع… هؤلاء هم المغاربة الذين يعجزون اليوم عن حسم علاقتهم بالسلطة وإلباسها رداء العقل والمصلحة التي لا تضحي بحرية ولا تهمّش أقلية.
لا أعرف حقيقة هل كان الأستاذ والمؤرخ حبيدة يقصد استثارة ذاكرتنا القرآنية التي تختزن قصة أهل الكهف الذين “لبثوا في الكهف ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا”. لكن شعور المكوث في الكهف، لا نحن بالميّتين ولا نحن بالأحياء، جامدين تحت جبال من الثلوج، يخترق ذهننا بكل عنف ونحن نتقدم بين فصول الرواية الجديدة.
وكما ينهي الكاتب فصله المعنون ب”الفتنة”، بذلك الشيخ الذي يمشي وسط الغوغاء مستعينا بعكازة غليظة يهش بها على الأقدام الحافية، ويكلّم نفسه بصوت مسموع: “ليلك طويل يا بلدي!”… نردّد بدونا: ليلك طويل يا وطني!