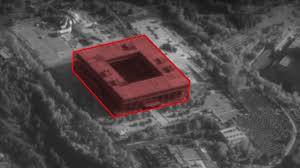المحرقة الثانية
من سخرية الأقدار أن يكمل التاريخ دورته الكاملة في أقل من قرن واحد، فتصبح ألمانيا التي أفجعت العالم في المرة السابقة بخروجها الاستعماري المدمّر نحو جوارها الأوربي ومنه بقية العالم، مسببة حربا كونية طاحنة، ومرتكبة في طريقها واحدة من الجرائم التي لا يمكن إنكارها في حق يهود أوربا من خلال محاولة إبادتهم، هي المسؤول الأكبر عن محرقة جديدة تجري هذه المرة على مرأى ومسمع من العالم في حق فلسطينيي قطاع غزة.
ألمانيا هي اليوم وبشكل رسمي، المسؤول الأول عن “المحرقة الثانية”، رغم كونها المصدّر الثاني للسلاح نحو إسرائيل، لأن المقارنة مع الولايات المتحدة الأمريكية لا تستقيم، سواء من حيث الحجم أو التاريخ أو الجغرافيا أو الوضع السياسي الداخلي.
ألمانيا التي يفترض أنها كانت أكبر مستفيد من الدرس الأليم الذي تعلمته البشرية في الحربين الكونيتين، والتي باتت تقدّم للعالم درس أخذ العبرة من خطأ الانزلاق نحو الكراهية والإقصاء والإبادة، لا تتوفّر على أي من العناصر السياسية الداخلية للولايات المتحدة، التي لا تبرّر الجريمة الدائرة حاليا في غزة، لكنها تفسّر كيف يُصنع القرار السياسي الأمريكي تحت ضغط اللوبيات الصهيونية القوية والنافذة في واشنطن.
لقد أثبتت ألمانيا بالفعل منذ انطلاق العدوان الإسرائيلي الحالي على غزة، وزيارة مستشارها على رأس وفد رسمي كبير إلى إسرائيل، وسقوط القناع بسرعة كبيرة عن السياسات الداخلية لألمانيا تجاه الأصوات الرافضة للمحرقة الجديدة، وتحوّل بعض المؤسسات الإعلامية الألمانية إلى بنيات قمعية لا تختلف في شيء عن المؤسسات الدعائية لأكثر الدول دكتاتورية وتخلفا في العالم، (أثبتت) أنها المفاجأة الحقيقية.
من كان يتصوّر قبل شهور قليلة أن تمثل ألمانيا اليوم أمام محكمة العدل الدولية كمتهمة بدعم جريمة الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزة، من خلال صادراتها القياسية من الأسلحة ووسائل القتل المتنوعة، إلى إسرائيل، وتُحاكم بطلب من دولة نيكاراغوا، بتهمة خرق اتفاقية منع الإبادة الجماعية التي تعتبر أول اتفاقية دولية من نوعها توقع بعد صدور ميثاق منظمة الأمم المتحدة إثر نهاية الحرب العالمية الثانية ودخول العالم مرحلة يفترض فيها أخذ العبرة من الماضي والالتزام بعد تكراره.
في خلفية تلك الاتفاقية كانت “المحرقة” التي يقرّ الغرب بارتكابها في حق اليهود من مواطنيه، ويستعملها كمبرر لدعم ومساندة إسرائيل في محاولة منه للتكفير عن “ذنبه”، فيقع بذلك في تناقضه المنطقي الأول، بدعمه دولة على أساس ديني رغم أن كل الإرث الحضاري والحقوقي الذي أنتجه هذا الغرب منذ عصر النهضة يقوم على عدم التمييز على أسس عرقية أو دينية.
صحيح أن الدولة الألمانية هي التي تمثيل اليوم أمام محكمة العدل الدولية، مقيّدة بالمعطيات الموثقة التي تقدمها مؤسسات مختصة في رصد وإحصاء المعاملات التجارية في مجال الأسلحة، وبانضمام ومصادقة ألمانيا على كل المواثيق والاتفاقيات التي تسمح بجرها إلى قفص الاتهام، عكس الولايات المتحدة الأمريكية التي يتعذر على الآليات الدولية مساءلتها أو معاقبتها لعدم انضمامها أو تصديقها على جل النصوص التي تسمح بذلك، لكن المشهد بتناقضاته الصارخة، يجعل الحضارة الغربية نفسها في موقف اتهام ومساءلة، خاصة عندما سقط القناع عن أوساط أكاديمية وإعلامية وسياسية راحت تنظّر وتبرّر للمحرقة الثانية متنكرة بذلك لجميع مرجعياتها الفكرية والحقوقية المفترضة.
قدّمت ألمانيا عبر هيئة دفاعها ردودا على الاتهامات التي وجهتها إليها نيكاراغوا أمام محكمة العدل الدولية، ومنها أن صادراتها من الأسلحة إلي إسرائيل ليست موجهة بالضرورة للحرب على غزة، ونفت على الأقل علمها بذلك، وقدمت رقما مثيرا لضحك كالبكاء، يفيد أن 25 في المائة من صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل موجهة أصلا لإعادة التصدير، أي أنه ومنطق الأشياء، 75 في المائة من تلك الأسلحة مخصصة ل”الاستهلاك الداخلي” لإسرائيل، والذي يتوفر على عنوان واحد لرسائل الموت منذ أكثر من ستة أشهر: أجساد الأبرياء المدنيين في غزة.
ليس بوارد لدى عاقل اليوم أن ينكر أو يتنكّر للإرث الحضاري، العلمي والفلسفي والفكري الكبير الذي قدّمته ألمانيا للبشرية وما زالت، لكن هناك وجه قبيح حد البشاعة لجل الدول والمؤسسات الغربية بات اليوم سافرا ومفضوحا بفضل صمود المقاومة الفلسطينية، بعدما سقط عنه القناع. وينبغي لجميع العقلاء، من الشرق والغرب، أن ينظروا إلى هذا الوجه القبيح بإمعان ويعملوا على معالجته وتحييده لأنه يقدّم لنا الدليل الحي في غزة، عن استعداد كامل لإعادة إحراق العالم، كما فعل الغرب مرتين في القرن الماضي، سعيا إلى السيطرة والاستحواذ.
كنت قبل بضع سنوات في العاصمة اللبنانية بيروت، وحضرت لقاء جمع صحافيين من دول عربية مختلفة بدبلوماسي ألماني، ولم أدرك وقتها سبب ذلك التوتر والعنف الذي بدا عليه في بداية اللقاء، حيث سارع منذ البداية إلى التحذير من الاستفزاز، قائلا إنه سيرد عليه بالمثل.
فهمت الأمر أكثر حين بادر صحافي من دولة عربية بطرح سؤال حول كيفية تجاوز ألمانيا للتناقض الذي تقع فيه بين خطابها الإنساني والحقوقي، وصادراتها من الأسلحة ووسائل القمع نحو الأنظمة الدكتاتورية في المنطقة العربية، فكان الجواب بأن تلك الأسلحة والتقنيات الاستخباراتية والقمعية موجهة لحفظ الزمن ومحاربة الإرهاب.
أي أنه ضمنيا وجّه الاتهام لشعوب المنطقة بإنتاج التطرف وتشكيل تهديد أمني على محيطها، وبالتالي فهي “تستحق” أن ينكّل بها ويمارس عليها القمع، وهو المنطق الذي يكاد يقفز من بين سطور الخطاب الرسمي لألمانيا حاليا، لتبرير دعم المحرقة الإسرائيلية في غزة، وحرمان الفلسطينيين حتي من الغذاء والدواء، بما أن ألمانيا كانت من أوائل المبادرين إلى وقف الدعم عن وكالة الأنروا الأممية الخاصة باللاجئين في غزة.