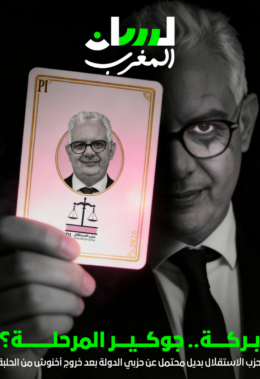من “يسار الفعل” إلى “يسار الانفعال”.. في الحاجة إلى “يسار وطني”

عرف اليسار العالمي، ومنه اليسار المغربي، عدة تحولات شملت علاقته بمرجعيته النظرية، كما شملت -تبعا لذلك- تصوراته ومواقفه السياسية والاجتماعية.. لقد أنهى “سقوط جدار برلين” ما بقي مع عِلمية كثير من الاشتراكيات عبر العالم، فركبت فئات واسعة من “اليسار” “ثورات ملونة” خاضعة لـ”كتالوج” استعماري جديد، لكنهم اعتبروها “ثورات حقيقية”.. لم تكن “حِراكات” ما بعد سقوط جدار برلين غير إنتاجٍ أو إعادةً لإنتاج سيطرة “الأحادية القطبية”، في حين اعتبرتها فئات من “اليسار” ثورات تعكس تحولات عميقة في بنيات الإنتاج. وهكذا تحول فئات واسعة من “اليسار” من “حركات فاعلة” إلى “حركات منفعلة”، من “حركات تقود الشعب” إلى “حركات يقودها الشعب”، من “شعبية متجذرة” إلى “شعبوية طارئة”.. هذا “يسار” في نظرنا غير مؤهل، وهو في حاجة مستمرة إلى تذكيره بالأساس النظري السديد لتحديد المفاهيم، بما فيها “مفهوم الثورة”.
الثورة الحقيقية ثورة اجتماعية أساسا، وكل “ثورة” غير هذه فهي صورية لا تعدو أن تكون انتقالا صوريا من فرد إلى فرد، أو من فرد إلى فتنة، أو من فرد إلى طغمة (فئة نافذة مستفيد)؛ في حين أن الانتقال من نظام سياسي إلى آخر لا يتحقق إلا اجتماعيا بالأساس. ولا وجود لثورة في التاريخ إلا وتخضع لهذا المعيار، حيث يكون المحرك الأساسي للتغيير هو التناقض الرئيس اجتماعيا.
في التاريخ الحديث هناك عدة نماذج لهذا النوع من الثورة، نذكر منها:
-الثورة الفرنسية علم 1789: وهذه كانت تتويجا لصعود البورجوازية الفرنسية وصراها المحتدم مع الإقطاع وكافة مؤسساته وتعبيراته، والتي كانت الكنيسة من أبرزها. في هذه الحالة، كانت الثورة بمثابة خروج نظام اجتماعي قديم من نظام اجتماعي جديد، أي بمثابة “تفجير لعلاقات الإنتاج” القديمة بتعبير ع. الموذن.
-الثورة الأمريكية 1776: والتي نتج عنها استقلال أمريكا عن بريطانيا، وهو في حقيقته استقلال اجتماعي للرأسمال الأمريكي عن نظيره البريطاني نتيجة للضغوط والقيود التي كان يفرضها الثاني على الأول في سوقه الداخلية (السوق الأمريكية).
-الثورة الروسية 1917: وكانت ثورة بمضمونين اجتماعيين: تهالك الإقطاع والحاجة لرأسمال وطني حديث، وتكتل الطبقة العاملة ووعيها بمصالحها في سياق انتشار الفكر الماركسي في أوروبا وغيرها من بلدان العالم. ولذلك فقد بقي الاتحاد السوفياتي، طيلة فترة وجوده وحتى تفككه، رهين جدلية: الاشتراكية والدولة القومية القادرة على منافسة الرأسمال الأمريكي.
-الثورة الصينية 1948: وهي ثورة تشبه في مضمونها الاجتماعي الثورة الروسية إلى حد بعيد، بحكم تقارب الجغرافيتين وتشابه نظام الحكم (إمبراطوري) والنظام الاجتماعي (الإقطاع).. الفرق بينهما هو أن روسيا القيصرية كانت أكثر تحديثا من الصين (كتلة عمالية أكثر من التي لدى الصين)، كما أن روسيا لم تشهد حربا ضد الاستعمار كالتي شهدتها الصين ضد الاستعمار الياباني، بالإضافة إلى المسار الذي اتخذته الصين في تطورها والذي يختلف عن المسار السوفييتي، وخاصة بعد انفتاح دينغ شياو بينغ.
هذا الأساس الاجتماعي لكل ثورة لا ينفي تدخل عوامل عديدة كالعامل الخارجي ومدى القدرة على تدبير تكتيكي للتناقضات الثانوية في المجتمع، وكذا اعتبار مدى قدرة النظام الاجتماعي المتهالك على الصمود العسكري والسياسي.. كلها عوامل متدخلة، لكنها لا تغني عن الشرط الحقيقي وهو قابلية النظام الاجتماعي للتغيير.. وكل “ثورة” لا تعتبر هذه القابلية ولا تنطلق منها وتتحرك متحررة من كل شرط اجتماعي، فهي مصطنعة، أو لنقل إنها صراع اجتماعي خارجي داخل الأرض المبلقَنة.. (من كتابنا “في النظرية أو حدود النظر”، فصل “تصحيح المفاهيم”، مخطوط ينشر قريبا).
هذا وتتراوح حركة “اليسار المنفعل” بالاحتجاج العفوي المحدود بين ثلاثة مواقع: الانفعال الواهم، الاعتزال العقيم، والانفعال المنتج.. الأول يعيش على واهم يراه قريبا في نفسانيته الإيديولوجية فيكتفي بالانفعال كلما استجد مستجد اجتماعي أو سياسي وكأن “القيامة” قائمة، لكنه سرعان ما يعود إلى غربته السياسية والإيديولوجية في مجتمع جديد وعالم جديد. أما الثاني فيكتفي بإبراز قصور الفعل العفوي وربما يواجهه ويختار موقعا نقيضا لحركته، فيكون انفعاله محكوما باختياره لموقع “الضرورة”.
فيما ينفعل النوع الثالث من “اليسار المنفعل” انفعالا منتجا، بمخالطة الاحتجاجات العفوية بأهداف: تأطير عملها الميداني، تسقيف وضبط خطابها السياسي، دراسة دوافعها ومعرفة أفقها، ممارسة الوساطة السياسية مع الدولة، دمج مطالبها في المطالب الحزبية والبرامج الانتخابية.. هذا النوع اليسار، وبسقفه “الوطني”، أصبح ضرورة لأنه الوحيد المؤهل، إذا تم تشكيله، للعب أدوار اجتماعية وسياسية لا تنوّم الاحتجاج فقط بل تسعى ضمن مساعٍ مدروسة ومخطّط لها لدمج “المطلب الاجتماعي” في “السياسة العامة” و”الاستراتيجية الوطنية”، أي أنها تجعل من هذا المطلب عنصرا من عناصر “حفظ النظام العام”.