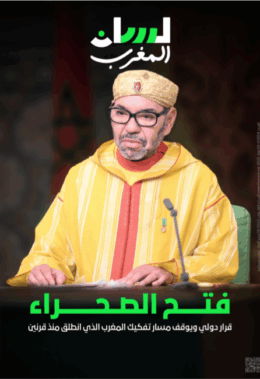الأسباب السيكولوجية للتعصب الرياضي أو جنون التشجيع

يُعتبر التعصب الرياضي من أكثر الظواهر التي تشغل بال الكثيرين في عالمنا اليوم، خاصةً مع الانتشار الواسع للرياضة وتأثيرها العميق على المجتمعات، بحيث أنه في حين يفترض أن تكون الرياضة وسيلة للترفيه والتآخي وتعزيز الروح الرياضية، نجد أن التعصب قد يحولها إلى ساحة للصراعات والخلافات، وقد يصل الأمر إلى العنف اللفظي والجسدي.
هذا التحول السلبي يثير تساؤلات هامة حول الأسباب الكامنة وراء هذا التعصب، وكيف يمكننا التعامل معه والحد من تأثيراته السلبية؟
التعصب الرياضي ليس مجرد انحياز لفريق أو رياضي معين، بل هو تجاوز للحدود المقبولة في التشجيع، والوصول إلى حالة من العداء والكراهية تجاه المنافسين. هذه المشاعر السلبية لا تؤثر فقط على الأفراد المتعصبين، بل تمتد لتشمل المجتمع بأكمله، وتؤثر على العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
الإنسان بطبيعته يسعى إلى الشعور بالفوز والتفوق. لكنه في حياته اليومية غالبًا ما يواجه أنماطًا من النجاح الفردي لا تُشبِع “غريزة الانتصار” الكاملة. النجاح الأكاديمي أو المهني لا يتطلب غالبًا وجود “منهزم”، بل هو نتيجة لمجهود شخصي منضبط.
أما في الرياضة، فهناك دائمًا “منتصر ومنهزم”. هذه الثنائية تمنح الجمهور شعورًا حقيقيًا بـ”النصر على الآخر”. عند كل فوز، يعيش المشجع حالة كيميائية كاملة داخل جسده: الدوپامين يولِّد السعادة، الإندورفين يخفف الألم، والأدرينالين يزيد التركيز والنشاط. إنها لذّة بدائية أصيلة لا نجدها بسهولة في واقعنا اليومي.
ومن هنا، يبدأ البعض بالتعلّق المفرط بهذا الشعور حتى يصبح نوعًا من الإدمان. وفي لحظة الغضب أو الخسارة، لا يعود المشجع قادرًا على الفصل بين الذات والفريق، فيُفرط في رد الفعل، ويهاجم الآخر كمن ينتقم لنفسه.
الاهتمام المشترك
في عالم باتت فيه السياسة والاقتصاد والتكنولوجيا معقدة وشائكة، تقدّم الرياضة منطقة راحة فكرية للجماهير. هي لغة مفهومة، بسيطة، لا تحتاج إلى شهادات لفهمها، بل مجرد شغف ومتابعة.
توفّر الرياضة محتوى يُمكن الحديث عنه في كل مكان: في المقهى، العمل، المنزل، وسائل التواصل. يملك المشجعون معرفة دقيقة بالتفاصيل والإحصائيات، وكأنهم خبراء استراتيجيون. هذا يمنحهم شعورًا بالسيطرة على موضوع ما، وبالتالي شعورًا بالثقة والتفاعل.
الخطير هنا أن هذا الفضاء البسيط قد يُصبح أيضًا بيئة خصبة للتحامل والتعصب، لأن الناس يشعرون بأن رأيهم له وزن حقيقي، وعندما يُعارَض هذا الرأي، فإنهم يردّون بشدة، ليس فقط دفاعًا عن الفريق، بل عن “كرامتهم الشخصية” المرتبطة بالفهم الرياضي.
الرغبة في الانتماء
الرياضة لا تكتفي بتقديم محتوى ترفيهي، بل تمنح المشجع هوية وانتماءً عاطفيًا. فبخلاف الانتماءات الكبيرة كالوطن أو الدين، التي تكون مشتركة لدى الجميع، فإن الانتماء لفريق رياضي يكون خاصًا، ومُميِّزًا، وأحيانًا متفردًا داخل محيطك.
هذا الشعور بالتميّز داخل المجموعة يخلق رغبة في الدفاع العاطفي عن الفريق، وكأن المشجع يدافع عن نفسه، عن شخصيته، عن مكانته في المجتمع. وكلما شعر الشخص بأن هذا الانتماء مهدَّد، زاد تعصّبه.
كما أن الشعور بالانتماء الرياضي يزداد في الأوساط التي تفتقر لهويات جامعة أو تعاني من الإقصاء أو الإحباط العام. فالرياضة هنا تصبح ملاذًا، ومصدرًا للفخر الشخصي، والحديث عن الفريق يصبح تعويضًا عن نجاحات يفتقدها المشجع في حياته.
الرغبة في التمرد
في الحياة العادية، يُطالَب الإنسان بالانضباط، اللباقة، ضبط النفس، ومراعاة الأعراف. لكن في عالم الرياضة، خاصة في المدرجات أو على وسائل التواصل الاجتماعي، يجد كثيرون متنفسًا للتمرّد.
اللغة نفسها في عالم الرياضة تعبّر عن ذلك: “رأس حربة”، “قذيفة”، “اجتياح”، “قتل المباراة”… كلها كلمات حربية تُضفي على اللعبة طابعًا قتاليًا. المشجع هنا لا يعود مجرد متابع، بل مقاتل لفظي، يُعبّر عمّا لا يستطيع التعبير عنه في حياته اليومية.
بل وتذهب بعض الجماهير إلى حد تبرير الغش أو الخروج عن الأخلاق باسم “الذكاء الكروي” أو “الحق الطبيعي”، كما حدث مع هدف مارادونا الشهير “بيد الله”. في هذه اللحظة، تصبح الرياضة مساحة للثورة الأخلاقية المؤقتة.
والنتيجة؟ جمهور يرى نفسه في حالة حرب لا تقبل الحياد. الخصم ليس مجرد فريق، بل هو “عدو”، وأي دفاع عنه يُعد خيانة. وهنا يكمن الخطر الأكبر للتعصب.
التأثير الإعلامي
يلعب الإعلام دورًا كبيرًا في تشكيل الرأي العام وتعزيز التعصب الرياضي. بحيث أنه غالبًا ما تركز وسائل الإعلام على الجوانب السلبية في المنافسة، وتضخم الخلافات بين الفرق والرياضيين، بهدف جذب المزيد من المشاهدين والقراء. هذا التركيز السلبي يمكن أن يخلق جوًا من العداء والكراهية بين المشجعين، ويؤدي إلى تفاقم التعصب.
بالإضافة إلى ذلك، تلعب وسائل التواصل الاجتماعي دورًا كبيرًا في انتشار التعصب، حيث يمكن للمشجعين التعبير عن آرائهم بشكل علني وغير مقيد، مما يؤدي إلى انتشار الشائعات والأخبار الكاذبة والتحريض على العنف.
كما أن ضغوط الأقران والمجتمع يمكن أن تدفع الأفراد إلى تبني مواقف متعصبة، حتى لو لم يكونوا مقتنعين بها في الأصل. الخوف من أن يُنظر إليهم على أنهم “غير منتمين” أو “غير مخلصين” يمكن أن يجعلهم أكثر عرضة للانخراط في سلوكيات متعصبة.
غياب الروح الرياضية والتعليم
غياب الروح الرياضية والتعليم الصحيح حول أهمية المنافسة الشريفة والاحترام المتبادل يساهم بشكل كبير في انتشار التعصب الرياضي. عندما لا يتم تعليم الأطفال والشباب قيم الروح الرياضية منذ الصغر، فإنهم يصبحون أكثر عرضة لتبني مواقف متعصبة وغير أخلاقية.
الروح الرياضية تعني احترام المنافسين، والاعتراف بالهزيمة، والاحتفال بالفوز بطريقة متواضعة، وتجنب الإساءة أو التحريض على العنف. بالإضافة إلى ذلك، يلعب التعليم دورًا هامًا في تعزيز التفكير النقدي والقدرة على رؤية الأمور بمنظور موضوعي.
عندما يكون الأفراد متعلمين ومثقفين، فإنهم يكونون أقل عرضة للتأثر بالشائعات والأخبار الكاذبة والتحريض على العنف، وأكثر قدرة على اتخاذ قرارات مستنيرة وعقلانية.