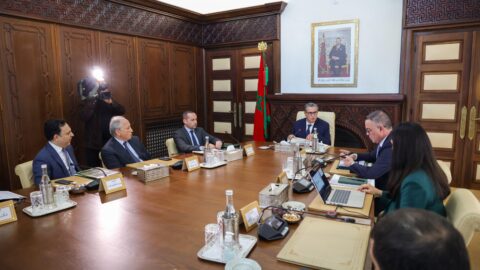نجيب أقصبي: سياسات إجرامية بدّدت الموارد المائية والسيادة الزراعية

وصف الأستاذ الجامعي المتخصص في الاقتصاد الفلاحي، نجيب أقصبي، السياسات التي شهدها المغرب على مدي عقود في المجال المائي، بالسياسات الإجرامية.
وحمّل أقصبي هذه السياسات التي قال إنها انطلقت في بداية الثمانينيات، مع ما يعرف ببرامج التقويم الهيكلي، مسؤولية “كارثتين” يعيشهما المغرب حاليا، وهما ضياع المخزون المائي الذي كانت تضمه الفرشة المائية، وضياع السيادة الغذائية بعجز المغرب عن إنتاج ما يلبي طلبه الداخلي.
واعتبر نجيب أقصبي خلال مشاركته في إحدى جلسات الجامعة الربيعية لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، المنظمة في مدينة الجديدة بين 18 و20 أبريل 2025، أن المغرب يعيش السيناريو نفسه منذ جفاف بداية الثمانينيات، أي تعبئة على جميع الأصعدة للحد من آثار الجفاف، وإطلاق مخططات وبرامج عديدة، “وبمجرّد هطول المطر، ننسى كل شيء وإلى جفاف مقبل”.
الخبير الاقتصادي ذو المرجعية اليسارية، حذّر من الاطمئنان التام بعد التساقطات المطرية الأخيرة، موضحا أن “مغرب بداية الثمانينيات ليس هو مغرب اليوم، والفرشة المائية التي تمثل الرصيد المائي للبلاد لم يعد بالإمكان مقارنته بأربعين سنة مضت… مناخ الثمانينيات والتسعينيات لن يعود من جديد، والتغير المناخي الذي وقع لا رجعة فيه، أي بعبارة أخرى، الواقع المناخي الجديد بتقلباته وأزماته شئنا أم أبينا هو الواقع والمستقبل”، معتبرا أن الحلول التي يتم الحديث عنها حاليا مثل تحلية مياه البحر والطرق السيارة للمياه… لن تعوّض النقص الذي حصل في الموارد المائية.
أقصبي قال إن التقلبات الحالية ليست تقلبات مناخية فقط، “بل تقلبات جيوسياسية أيضا، طابعها الأساسي هو اللا-يقين، وفلاحتنا عاجزة عن إطعامنا، وليس أمامنا إلا اللجوء إلى السوق الدولية في بعض المواد التي لا نحقق منها اكتفاء ذاتيا”، يقول المتحدّث نفسه، مشدّدا على أن هناك علاقة متنامية بين القدرة الشرائية الداخلية وتقلبات الأسعار الدولية.
وبعد تأكيده أن المغرب أطلق سياسة مائية تزامنا مع رهانه المبكر على الفلاحة، في عقد الستينيات وبينما كانت جل الدول النامية تراهن على الصناعة، غاد ليتساءل: أين أخطأنا؟
والجواب حسب نجيب أقصبي، يبدأ مع سياسات بداية الثمانينيات، لكون ما سمي بسياسة السدود في حد ذاتها كانت ضرورية، “لكن الاختيار الذي قمنا به، أي السدود الكبرى، يعني تركيز إمكانيات هائلة في مجال محدود وهي لا تغطي سوى 15 في المئة من الأراضي الزراعية وتم تهميش بقية العالم القروي”. وإلي جانب ذلك، جاء اختيار نظام السقي الذي كان يؤدى إلى ضياع 45 في المئة من المياه التي تخرج من السدود بفعل التبخّر.
وأكد أقصبي أن سنوات الثمانينيات شهدت منعطفا حقيقيا، من خلال انسحاب الدولة والاندماج في السوق الدولية، واختلال التوازن في المناطق السقوية التي استثمر فيها المغرب كثيرا، بين منتوجات التصدير ومنتوجات الطلب الداخلي.
“جاء التقويم الهيكلي بفكرة تحرير الفلاحين وهذا التحرير للإنتاج جعل كبار الفلاحين ينتجون ما يشاؤون من خلال توسيع مساحة المواد الغنية والمصدّرة وتوسيع المناطق المسقية من الفرشة المائية وهنا وقع المنعطف الخطير”.
انحراف قال أقصبي أنه تفاقم أكثر عندما بدأت الدولة تشجع، عبر ما يعرف بصندوق التنمية الفلاحية الذي أحدث في 1986، تجهيز الأراضي الفلاحية بأنظمة السقي، “والذي يمنح الدعم للسقي وحفر الابار واستهلاك غاز البوتان بحجم استثنائي…”.
وخلص أقصبي إلى أن مخطط المغرب الأخضر لم يكن سوى تتويجا لهذا المسار، حيث لم يتطرق في بدايته نهائيا لإشكالية الموارد المائية، “وتمت إضافة الركيزة السابعة الخاصة بهذه الموارد في وقت لاحق، وأصبح الجواب الذي يقدّم، هو وجود 700 ألف هكتار من السقي الموضعي… لقد وقع انحراف خطير جدا لأن هناك دعم بنسبة مئة في المئة لمشاريع السقي وحتى 80 في المئة للأراضي الكبرى”.
وجوابا عن سؤال “ما العمل؟”، قال أقصبي إن الجواب هو مراجعة الاختيارات الفلاحية بشكل شامل، لجعلها تراعي عنصري الموارد المائية والسيادة الزراعية.
“علينا ان نختار المنتوجات أخذا بعين الاعتبار العوامل الجيو سياسية، أي المواد التي تلبي حاجياتنا الداخلية أولا… هناك قاعدة واضحة هنا هي أنه بالنسبة للسيادة، هناك دائما كلفة لكن ليس لها ثمن”.