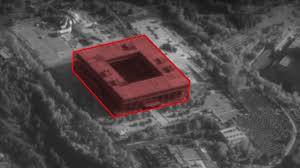ما قبل العاصفة

تابعتُ مساء أمس الأحد 13 يوليوز 2025 خطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمام قادة جيشه بكثير من الانتباه، وخرجت منه بخلاصة مفزعة: العالم يتجهّز لحروب ضخمة، حتى أن القادة الكبار لم يعودوا يخفون ذلك.
كان ماكرون يتحدث كمن يتهيأ لساعة الصفر، وبلغة لم تترك مجالا للغموض: تحفيز للشباب على الانخراط في العمل العسكري، ودعوة صريحة للتضحية من أجل “صون الوطن”، بالمال خصوصا، وإشارات دقيقة إلى ضرورة تعبئة مخزونات الذخيرة، واستعدادات لبناء تحالفات عسكرية جديدة، من بينها تقوية المحور الفرنسي البريطاني ووضع أسس تعاون عسكري وشيك مع ألمانيا، وقبل هذا وذاك، زيادة استثنائية في ميزانية الدفاع الفرنسية، بشكل يجعلها تتضاعف خلال عشر سنوات.
وبما أن البوصلة السياسية والعسكرية للمغرب ظلت منذ أكثر من قرن تتّجه نحو باريس، فإننا لا يمكن أن نكتفي بموقع المتفرج أو نُمني أنفسنا بالحياد الدافئ.
بل نحن مدعوون بدورنا إلى طرح الأسئلة الوجودية الثقيلة: هل نحن مستعدون؟ لا فقط من حيث الجاهزية التسليحية والبنية الدفاعية، بل أساسا من حيث الجبهة الداخلية: التماسك، والثقة، والمعنويات، والقدرة على الصمود في وجه العواصف القادمة؟
تلك، لا غيرها، هي العوامل التي تصنع القوة الحقيقية في زمن الحروب.
لقد أصبحنا عمليا في أجواء شبيهة بتلك التي سبقت الحرب العالمية الثانية، ولا يبدو أن أحدا يرغب في الضغط على المكابح.
ومع كل خطاب رئاسي أو اجتماع عسكري رفيع، تزداد نبرة التهديد وتغيب لغة التهدئة.
خطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، أمام قادة جيشه في حديقة وزارة الجيوش، لم يكن مجرد لحظة احتفالية عشية العيد الوطني، بل كان أقرب إلى قرع الطبول قبل اشتعال النيران.
لقد قالها ماكرون بوضوح لا يحتاج إلى تأويل: “لكي تكون حرا، يجب أن تُخشى. ولكي تُخشى، يجب أن تكون قويّا”.
ثم أرفق عبارته هذه التي تحولت إلي عناوين في صدر الصحف هذا الصباح، بإعلان زيادة فورية في الإنفاق العسكري قدرها 7 مليارات يورو، خلال سنتين فقط، وتعهّد بتسريع تنفيذ أكبر خطة تسلح فرنسية منذ الحرب العالمية الثانية.
لكن ما قاله الرئيس الفرنسي، وما أعلنه من تعبئة شاملة، ليس حدثا معزولا، ولا مجرد رفاه لغوي لرئيس مأزوم داخليا. بل إنه تجلّ آخر لتحول عميق في بنية النظام العالمي.
منذ شهور، بدأت المؤسسات الاستراتيجية الغربية وبعض المجلات المتخصصة، من “فورين أفيرز” إلى مراكز التخطيط العسكري الأطلسي، تتحدث بلغة غير مسبوقة: الحرب الكبرى لم تعد مجرد سيناريو خيالي، بل احتمال قائم، بل حتمي إن استمر المسار الحالي.
العالم، يدخل زمن “ما قبل العاصفة” بكل المقاييس، وهذه مؤشرات ذلك:
• الولايات المتحدة تُعيد ترتيب أولوياتها في آسيا، وتسجّل مصادر الطاقة والمواد الأولية في العالم ضمن ممتلكاتها غير القابلة للمساس،
• أوروبا تستعيد منطق التكتلات العسكرية وتعيد عسكرة حدودها،
• روسيا تقاتل على أكثر من جبهة وتحوّل أمنها القومي إلى ملف وجودي،
• الصين تُراكم القوة وتنتظر الفرصة ولا تنسى تسليح نفسها،
• إسرائيل تلوّح بنهاية الغموض النووي مع ايران،
• وحلف الناتو يُطالب أعضائه بتخصيص 5% من ناتجهم القومي للإنفاق الدفاعي.
في هذا السياق، تصبح تصريحات ماكرون امتدادا لحالة التعبئة الجماعية التي يشهدها الغرب، وتُحوّل كل فرد إلى مقاتل محتمل، وكل مؤسسة إلى أداة حرب.
لهذا لم يتردّد الرئيس الفرنسي في الحديث عن إعادة تجنيد الشباب، وتكليف رجال الأعمال بالمساهمة في “المجهود الوطني”، وتحويل الميزانية العسكرية إلى “رافعة اقتصادية” لا عبء مديونية.
لكن، ما مدى عقلانية هذا السباق المحموم؟
ألا تبدو دعوات “التوازن بالردع” أشبه بالعودة إلى منطق الحرب الباردة، دون تلك الضمانات التي وفّرتها؟
وهل فعلا نمنع الحرب بمزيد من التسلّح كما يقول بعض المنظّرين؟
أم أننا نُعجّل باندلاعها؟
لقد صُمّمت جارتنا أوروبا ما بعد الحرب العالمية الثانية لتكون ضمير العالم. فإذا بها اليوم تتحوّل إلى ساحة سباق تسلح مجنون، تتسابق فيه فرنسا وبريطانيا وبولندا وألمانيا على ملء مخازن الذخيرة، وتستعد لزج آلاف الجنود تحت مظلة “قوة استباقية” تُجهّز للأراضي الأوكرانية و”التهديدات العابرة للقارات”.
الأخطر أن خطاب ماكرون لم يحمل أي إشارة إلى الحلول الدبلوماسية أو المبادرات السياسية. كل ما في الأمر هو حديث عن “قوة الرّدع”، و”الصمود الوطني”. حتى لقاءاته المعلنة مع قادة الجيوش، ومع منظمات الشباب، جاءت في سياق تعبوي صرف، استعداداً لمرحلة يُرجّح ألا تُحلّ فيها النزاعات إلا على ظهر الدبابة أو من فوهات المسيّرات.
في هذه اللحظة المفصلية، يتحوّل الدفاع عن “الحرية” إلى عبء على الشعوب، وفرصة ذهبية لطبقة المنتفعين من الصناعات العسكرية.
إنها فرصة لفرض التقشف على الطبقات العاملة، وإعادة تشكيل الاقتصاد حول أولويات الحروب القادمة، واستدعاء الشباب إلى التدريب العسكري من جديد، لا ليخدموا أوطانهم، بل ليكونوا جاهزين ليوم “لا مفرّ منه”، كما يُروّج صناع القرار.
جارتنا أوروبا تتهيأ للانفجار، والعالم من حولنا يراكم مخزون البارود، وطبول الحرب تُقرع من باريس إلى موسكو، ومن واشنطن إلى بكين، والمشهد الدولي يدخل مرحلة “ما قبل العاصفة” بكل ما تحمله العبارة من رهبة ووضوح.
أما نحن، المقيمون على هامش هذه الاصطفافات الكبرى، فلا يكفي أن نراقب من بعيد أو نتلحف بالحياد الغامض.
إننا في أمسّ الحاجة إلى بوصلة سياسية وأخلاقية جديدة، لا لكي ننتظر أين ستسقط القنبلة الأولى، بل لنسأل أنفسنا بجدية مؤلمة: هل نحن في موقع الجاهزية أم على حافة المفاجأة؟ هل نملك الحد الأدنى من الوحدة، ومن الثقة في المؤسسات، ومن الروح الوطنية الصلبة التي تصنع الصمود؟ أم أننا سنظل نعيد اجترار الأسئلة نفسها، بعدما نكون قد فاتنا القطار، ووجدنا أنفسنا نواجه ارتدادات زلزال لم نستعد له؟