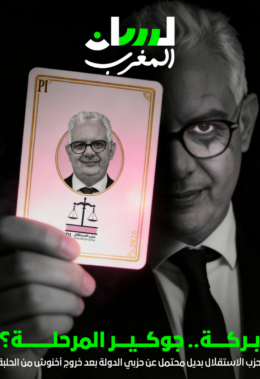ماذا بقي من كارل ماركس؟

كلما أثير النقاش حول الماركسية، إلا وطرِح سؤال أصبح اليوم راتبا عند المهتمين بفكر كارل ماركس: ماذا بقي من فكر مفكر الطبقة العاملة؟ يطرَح هذا السؤال أكثر من مرة من قِبل اليسار ومن قبل غير اليسار. يُطرح في ذكرى وفاة ماركس، ويطرح في ذكرى إصدار البيان الشيوعي، وفي ذكرى الثورة البلشفية (1907)، وذكرى وفاة فلاديمير لينين، وذكرى الثورة الماوية (1948)، الخ؛ وقد طرِح نفس السؤال مؤخرا بمناسبة “عيد العمال العالمي”، ولو أن طارحيه كانوا قلة لم يعد يلتفت إليهم أحد في غمرة القول في الماركسية بغير علم. فما الماركسية إذن؟
-الماركسية فلسفةٌ ماديةٌ جدلية؛ مادية تتأسس على ثلاثة مبادئ هي: العالم مادي، والعالم يمكن إدراكه، والعالم خارج شعورنا؛ وهي أيضا جدلية تتأسس على ثلاث قواعد هي: الترابط، والتغير، والتناقض. وقد شرح جورج بوليتزر هذه المبادئ والقواعد بتفصيل في الجزء الأول من كتابه “أصول الفلسفة الماركسية” لمن أراد العودة إليها. هناك جانب آخر تعتبره الماركسية في فلسفتها، وهو ارتباط النظرية بالممارسة العملية،في دورة معرفية تتأسس فيها النظرية على الممارسة وتختبر فيها (“الدورة المعرفية” كما وردت في رسالة ماو تسي تونغ “الممارسة العملية”/ وهي نفسها الممارسة التي دحض بها لينين لاأدرية اللاأدريين -الكانطيين الجدد-في كتابه “المادية الديالكتيكية والمذهب التجريبي”).
-الماركسية علمٌ في الاقتصاد والمجتمع؛ وهو ما يطلق عليه في الأدبيات الماركسية “المادية التاريخية” عندما يتعلق الأمر بدراسة القواعد المادية لتطور التاريخ، و”الاقتصاد السياسي النقدي/ نقيض البورجوازي” عندما يتعلق الأمر بدراسة تطور أنماط الإنتاج عبر التاريخ بمختلف بناها الإقتصادية وما يمكن أن تؤول إليه في تاريخ المجتمعات. ويُلحَق بالماركسية كعلم مختلف النظريات والأطروحات التي تتناول مختلف الظواهر الاجتماعية والنفسية والأدبية من وجهة نظر ماركسية. في دراسة المجتمع، نذكر “نقد علم الاجتماع البورجوازي” ليوري بوبوف كمثال. وفي دراسة الظاهرة النفسية، نذكر كتابا “المادية الجدلية والتحليل النفسي” و”ما الوعي الطبقي؟ نحو علم نفس سياسي للجماهير” لوليام رايش. وفي الدراسات الفنية والأدبية، نذكر “ضرورة الفن” لإرنست فيشر… الخ.
-الماركسية تخطيطٌ اشتراكي؛ وهو البرنامج السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تتحقق به غاية الماركسية في التاريخ، وهي: في شرط تفاوت داخلي، أنْ يتخلص جميع الناس من الملكية الخاصة الاستغلالية بتحويلها إلى ملكية عامة؛ وفي شرط إمبريالي، أن تتخلص الأطراف من قبضة الرأسمال الاحتكاري المركزي/ الغربي. واعتادت الأدبيات الماركسية، خاصة السوفييتية منها، إطلاق “التخطيط” على عملية “إخضاع الاقتصاد للدولة”. وهو ما يطلق عليه “اشتراكية السوق” في التجربة الصينية. ويتم تبرير هذه العملية عند الماركسييين الشيوعيين بأنها مرحلة انتقالية، بعدها أو بتطورها التلقائي تنحل الدولة “الاشتراكية” تلقائيا (يقول لينين في كتابه “الدولة والثورة”: “الدولة البورجوازية يُقضى عليها، أما الدولة البروليتارية فتضمحل/ أي تلقائيا”).
-الماركسية طوبى وإيديولوجية؛ إن انحلال “الدولة الاشتراكية” في الأدبيات المركسية، يعني تحولها تلقائيا إلى “شيوعية” بعد أن تكون الفئة المشرفة على الانتقال قد وفرت لها سبل وشروط هذا الانتقال. في الشيوعية تنعدم الملكية الخاصة، ومعها ينعدم التفاوت الطبقي. في “المشاعة الأخيرة” تنعدم التناقضات الطبقية لتحلّ محلها الاختلافات اللاطبقية، وينعدم الاستغلال فاسحا مجال الإبداع للإنسان، ويعمل الإنسان بحسب قدرته وحاجته لا بحسب ما يطلبه مالكو وسائل الإنتاج.
هي أربعة مستويات في الماركسية إذن؛ إلا أن كثيرا من نقادها، بل من مدّعي الانتساب لليسار، لا يعرفون من الماركسية إلا: ماديتها الإلحادية، وفشل تجاربها السياسية، وطوباوية غايتها في التاريخ. كل هذه الادعاءات، ولنقل الأحكام، قابلة للنقاش، وربما تثير عيوبا ما في الماركسية أو الماركسيين. لكننا نتساءل: لماذا يتم طمس أهم جانب في الماركسية، وهو جانبها العلمي؟! لماذا يغفله اليسار وينساه أو يتناساه؟! ولماذا يتجاهله نقاد الماركسية أو لعلهم لا يهتمون به كاهتمامهم بظاهر “العقيدة/ السياسة/ الطوبى”؟!
ليس هذا النسيان ذاتيا كما قد يرى البعض، وذلك لأن انحسار الماديتين الجدلية والتاريخية لم يحدث اعتباطا في المجال الأكاديمي، كما أن تحول فئات واسعة من اليسار إلى يسار ليبرالي لا ماركسي لم يكن محض صدفة. لقد كانت للأحادية القطبية الرأسماية/ الإمبريالية عدة آثار، بدءا من علاقات الإنتاج و”التقسيم الدولي للعمل”، وصولا إلى مختلف العلوم والفنون ومختلف مجالات الحياة العامة والخاصة الأخرى. ولذلك فقد تم “تجاوز” المتن الماركسي كلية وبمنتهى السرعة، تحت شعار “نهاية الماركسية بنهاية الاتحاد السوفييتي وانحراف الصين وفقر كوبا وديكتاتورية كوريا الشمالية”. وفضلا عن أن هذا شعار في حاجة إلى مراجعة دقيقة وتفصيلية قد تقلب مقولاته رأسا على عقب، فإنه لا يكفي لتخليف الماركسية كفلسفة (ليست إلحادية بالضرورة) وعلم.
إن الذي بقي من كارل ماركس هو كلّه باستحضار مختلف أنواع النقد الموجّهة للماركسية، من الماركسيين وغيرهم، ولعل من أبرزها:
-في موقف ماركس من الدين: لوجود فرق بين “الدين” و”الإيديولوجيا الدينية”؛ وهو ما لم يكن حاضرا عند كارل ماركس نظرا لاهتمامه بالمسألة الدينية في بعدها الاجتماعي فحسب، لا في بعدها الوجودي والأنثروبولوجي. في هذا الإطار يجب أن نفهم مقولتيه: “الدين أفيون الشعوب” و”الدين روح لعالم بلا روح”. بعد ماركس بعقود، وفي شروط غير أوروبية، في أمريكا اللاتينية بالذات، تبنت حركات تحررية “المسيحية” إيديولوجية لها، وأصبحنا نتحدث عن نوع جديد من اللاهوت هو “لاهوت التحرير”. بعده أيضا، وبعد أن كشفت المادية الأوروبية عن حدودها في فهم الظاهرة الإنسانية وحمايتها وتوفير العزاء لها، انتبه ماركسيون أمثال أنور عبد الملك (في كتابه “تغير العالم”) إلى الكفاءة الوجدانية والنفسية للدين إذا اشتد الخناق على الإنسان، سواء أكان هذا الخناق اجتماعيا (الفقر وانتشار الفساد الأخلاقي والفوضى الفكرية) أو طبيعيا (الكوارث الجيولوجية والوبائية)
-في موقف ماركس من الدولة: فقد دفعت ظروف أوروبا الصناعية كارل ماركس دفعا ليرى الدولة في نظيرتها التاريخية العامة، أي ك”جهاز وإيديولوجيا لسيطرة طبقة اجتماعية” هي البورجوازية في شرط ماركس. وقد أفرز الانتقال الرأسمال من رأسمالية تنافسية إلى رأسمالية احتكارية واقعا جديدا هو واقع الإمبريالية (راجع “الإمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية” فلاديمير لينين)، وهو نفس الواقع الذي أكسب دول الجنوب (المستعمَرة/ ثم التبعية) شرعية مواجهة الاستعمار كبورجوازيات وطنية تقود باقي الطبقات في معارك التحرير الوطني.
-في موقف الماركسية من الظواهر ما قبل الطبقية: وهي ظواهر من قبيل الدين والجنس واللغة الشفهية وباقي الظواهر والعلاقات الإنسانية التي يجب مراعاة أبعادها الما قبل طبقية (الما قبل تاريخية)، حتى لا يتم إهمال قوانينها وقواعدها القديمة عند تفسير عمليات إعادة إنتاجها في شرط “التناقض الطبقي”. ففي شرط ما قبل التاريخ، كانت العلاقة بين الرجل والمرأة جنسانية، كما كان تقسيم العمل بينهما جنسانيا، ولم يكن خاضعا لسلطة طبقية آنذاك (راجع “ينابيع الثقافة” لياسين بوعلي). أما اللغة الشفهية فكانت مرتبطة بالإنتاج المادي للإنسان مباشرة (راجع “الماركسية في علم اللغة” لجوزيف ستالين)، ولم تكن لتنتظر شروط التفاوت الاجتماعي لتتبلور كوسيلة للتعبير الشفوي. وهو ما يمكن أن نتحدث عنه بخصوص الدين الذي يعتبر وجوده سابقا على الوجود الطبقي الذي أعاد إنتاج الدين في “إيديولوجيات دينية” (راجع مقال “الدين والإيديولوجيا الدينية” لعبد الصمد بلكبير).
-في موقف الماركسية من الاستعمار: ونقصد هنا مواقف بعض الاحزاب الشيوعية، وبعض الماركسيين، الذين أهملوا إشكالية الاستعمار في مجتمعات الجنوب خاضعين بشكل لا واعٍ للمركزية الغربية. فانصب اهتمامهم على الثورة الأممية البروليتارية في كل بلد، عوض أن يدافعوا عن حق كل مجتمع بمختلف طبقاته في الإستقلال عن الاستعمار. وقد اتخذوا من تحليلات ماركس بخصوص الهند والجزائر سندا لمواقفهم، في حين أنها مجرد تحليلات لا تؤيد الاستعمار بقدر ما تشرح إمكانات التحويل القسري الرأسمالي في المستعمرات. ولم يضع ماركس في حسبانه، وهو يتحدث عن ذلك، باقي الإمكانات من قبيل تشكل بورجوازيات محلية في أحشاء الرأسمال الأجنبي. فهذه ظروف كانت متقدمة جدا على السياق الذي تحدث فيه ماركس عن الظاهرة الاستعمارية، وربما كان لينين أكثر وعيا منه بها، بل هذا هو الأرجح. ولو علم بها ماركس لتحدث عن الإمكان التاريخي الأنجع للتحرير، والذي كان هو تحالف كافة الطبقات والفئات الاجتماعية رغم تفاوتها ضد الاستعمار (الحالة المغربية/ راجع “الدولة المغربية: قضايا نظرية” لعبد السلام الموذن).
-في موقف ماركس من ثورة البروليتاريا في أوروبا الصناعية: وهو أيضا ناتج عن وقائع وأحداث وتطورات تلت المرحلة التأسيسية للماركسية (مرحلة “ماركس وإنجلز”). فقد خاب تنبؤ ماركس بالثورة البروليتارية في أوروبا الصناعية، بسبب عملية النهب التي أفرزت تهجيرا قسريا لفائض القيمة من الجنوب المستعمَر إلى الشمال الرأسمالي الإمبريالي. لقد ساهمت هذه العملية بشكل كبير في تحقيق بعض المطالب العمالية وإرشاء الزعماء النقابيين، الأمر الذي أخمد حدة المطالب واستحالت معه “الأحزاب الشيوعية” “أحزابا اشتراكية ديمقراطية (راجع “وجهة نظر” لمحمد عابد الجابري). وعلى هامش هذا الواقع الغربي، ظهرت إمكانات تقدمية أخرى، الأولى في روسيا القيصرية (1917)، والثانية في الصين (1948). ويقدر ما أغنت هذه التجارب الماركسية، فقد فتحت في وجهها أبوابا جديدة للتفسير والفهم والتحليل إذا ما تعلق الأمر بواقع يختلف عن الذي عليه واقع أوروبا الصناعية.
-في موقف الماركسيين من التحليل النفسي: ظهر التحليل النفسي في سياق بورجوازي، بالإضافة إلى النزعة الوضعانية التي اتسمت بها مدارسه التأسيسية (سيغموند فرويد، ألفريد آدلر، كارل غوستاف يونغ)، وكذلك اكتفاؤه بتحليل النفس وسبر أسرارها في معزل عن واقعها الاجتماعي، وباستحضار استغلال نتائجه في قهر الطبقة العاملة وتوظيفها و”تدجينها” رأسماليا. كل هذه العوامل استعدت على هذا الحقل المعرفي المهم فئات واسعة من الماركسيين، أمثال جورج بوليتزر صاحب “أزمة التحليل النفسي”، وجورج لوكاتش صاحب “الأدب والفلسفة والوعيد الطبقي”. وقد توارث كثير من الماركسيين هذا النوع من العداء والتجاهل، الذي ظل ينتظر تبلور مدرسة نفسية اجتماعية نقدية مع أمثال وليام رايش (له كتاب “ما الوعي الطبقي؟ نحو علم نفس سياسي للجماهير”)، وإريك فروم (من كتبه “مهمة فرويد”) وغيرهما.
-في موقف الماركسيين من العلوم الوضعانية: وقد اعترى الموقف الماركسي منها ما اعترى موقفه من علم النفس. فأهمِلت النجاعة الوصفية والبنيوية لكثير من العلوم الوضعانية، مقبل السوسيولوجيا والأنثروبولوجيا واللسانيات الخ، بدعوى خدمتها لمصالح الطبقة البورجوازية. ونتيجة لهذا النوع من الضغط، في شرط تواريخ الثنائية القطبية وضعفها، حُمِل علماء ومتخصصون على مغادرة أحزابهم الشيوعية، بل وتبني اختيارات علمية أكثر انفتاحا انزاحت بهم نحو المثالية والميتافيزيقية أحيانا (تذكرت هنا: ميشيل فوكو، وكارل بوبر). أبحاث هذين أو غيرهما من علماء الاجتماع والنفس والإناسة والتاريخ واللسانيات والاقتصاد والقانون؛ هي أبحاث ودراسات مهمة تحتاج تأطيرا اجتماعيا، لكنها لا تخلو من فائدة أصبحت اليوم أكثر وضوحا في زمن تدقيق المعرفة.
لا يقول أحد إن الماركسية لا تخطئ ولا تستبطن مواطن قصور هنا أو هناك؛ إلا أننا نتساءل: بأي منطق تم تجاوز “ماديتها الجدلية”، “تفسيرها الاجتماعي التحتي”، “مدرستها النقدية في الاقتصاد السياسي”؟! هذا هو السؤال الحائر الذي نظن أن الجواب عنه قريب إلينا من حبل الوريد، أما الخناق الذي كان يحول دون طرحه فإننا نراه يتبدد شيئا فشيئا، ومن شأن عالم جديد أن يطرح أسئلة جديدة ويعيد طرح أخرى قديمة غُيِّبت عن الإنسان منذ سقوط جدار برلين!