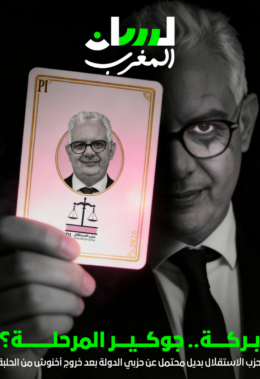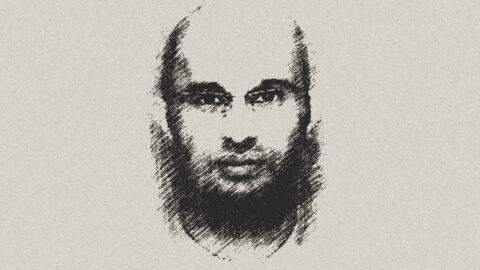لورينا غازوتي: ملفا الصحراء والهجرة مترابطان للغاية – حوار

شهدت سياسات الهجرة في الشمال العالمي تحولات جوهرية في العقود الأربعة الأخيرة، حيث اتجهت نحو تشديد القيود وتقليل أعداد الوافدين. في هذا السياق، أصبح الدعم التنموي أداة رئيسية في استراتيجيات ضبط الهجرة التي تتبعها أوروبا والولايات المتحدة، وهو ما أدى إلى بروز دور المانحين والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية كمحاور رئيسية في إدارة الحدود.
في كتابها الصادر عن جامعة كامبردج “أمة الهجرة: المساعدات، الضبط، وسياسات الحدود في المغرب” (Immigration Nation: Aid, Control, and Border Politics in Morocco،) تقدم الأكاديمية الإيطالية لورينا غازوتي الباحثة في أليس تونغ تسي في كلية لوسي كافنديش ومركز (CRASSH) التابع لبجامعة كامبريدج، رؤية نقدية لهذه الديناميكيات، معتمدة على أبحاث ميدانية موسعة في المغرب.
تحلل غازوتي كيف تجاوزت سياسات ضبط الهجرة الأدوات التقليدية مثل الجدران والترحيل، لتشمل آليات أكثر تعقيدًا، حيث يمارس الضبط بطرق غير مباشرة وغير مرئية، مما يعزز فاعليته دون اللجوء إلى العنف المباشر.
على عكس الدراسات التي تصور البلدان المانحة والمنظمات الدولية كجهات فاعلة متجانسة، وتعتبر دول العبور مجرد منفذين سلبيين للسياسات الأوروبية، يسلط هذا الكتاب الضوء على تداخلات أكثر تعقيدًا. فهو يظهر كيف تتجلى سياسات الحدود في تفاصيل الحياة اليومية بعيدًا عن مشهد العنف الحدودي الواضح، مما يعيد تعريف مفهوم السيطرة على الهجرة.
في هذا الحوار، نناقش مع لورينا غازوتي الأفكار الرئيسية التي طُرحت في كتابها، ونتناول بالنقد والتحليل العلاقة المتشابكة بين المساعدات الإنسانية والسياسات الأمنية، ودور المنظمات الدولية، وتأثير هذه السياسات على حياة المهاجرين في المغرب. كما نسعى إلى استكشاف أبعاد جديدة لفهم التحولات العميقة في سياسات الهجرة بالمغرب
- أول سؤال تبادر إلى ذهني عند بدء قراءة كتابك هو: كيف أصبح المغرب دولة للهجرة؟
من المثير للاهتمام ملاحظة أنه يوجد تصور شائع، حتى أنا كنت مضطرًا لتفكيكه أثناء البحث في الكتاب، وهو أن المغرب ليس لديه عدد كبير من المهاجرين عند مقارنته بنسبة المهاجرين في الدول الأوروبية.
المغرب بلد مرتبط بالهجرة منذ زمن طويل، لكن ما يلفت الانتباه هو أن صناع القرار عندما يتحدثون عن الهجرة في المغرب، فإنهم يقصدون بشكل خاص الهجرة من دول أفريقية أخرى إليه، مما يخلق صورة مشوهة للواقع.
فالمغرب، مثل معظم دول العالم، كان دائمًا موطنًا لمزيج من الناس القادمين والمقيمين، ولكن حتى استقلاله، كان هناك عدد كبير من المهاجرين فيه، خاصة الأوروبيين الذين قدموا خلال فترة الحماية.
من المثير للاهتمام أنه في نهاية فترة الحماية، تحديدًا بين عامي 1952 و1953، كان عدد المهاجرين في المغرب أكبر بكثير مما هو عليه اليوم، على الرغم من أن عدد سكانه كان أقل بكثير حينذاك. فقد كان هناك حوالي 500,000 مهاجر في المغرب، معظمهم من الأوروبيين، بينما كان عدد السكان المحليين أقل بكثير مما هو عليه اليوم. ومن منظور تاريخي، يمكن القول إن الهجرة إلى المغرب قد تراجعت بشكل كبير خلال السبعين عامًا الماضية.
مع إغلاق الحدود الأوروبية وإنشاء منطقة شنغن، أصبح المغرب وجهة أكثر وضوحًا للمهاجرين القادمين من دول أفريقية أخرى. هذا لا يعود فقط إلى أن بعضهم يبقى عالقًا أثناء محاولته الوصول إلى أوروبا، ولكن أيضًا بسبب الشراكات التي أقامها المغرب مع الدول الأفريقية لاستقطاب الطلاب، لا سيما في مدن مثل الرباط، الدار البيضاء، طنجة، ووجدة، حيث تستقبل الجامعات المغربية طلابًا من غرب ووسط أفريقيا عبر منح دراسية أو بسبب تفوق النظام التعليمي المغربي مقارنة ببعض الدول الأفريقية الأخرى.
ومع ذلك، لا يزال العديد من الأجانب المقيمين في المغرب من الأوروبيين. والمثير للاهتمام أن المغرب يعيش عند مفترق طرق بين الأجانب القادمين من أفريقيا والذين يطمحون للوصول إلى أوروبا، وبين الأوروبيين الذين يستقرون في المغرب لأسباب اقتصادية. فبعض المهاجرين الأفارقة يأتون إلى المغرب لفترة مؤقتة ريثما يكملون رحلتهم إلى أوروبا، بينما يقرر آخرون إعادة ترتيب حياتهم والاستقرار فيه.
علاوة على ذلك، فإن المغرب يعزز نظامه التعليمي لجذب طلاب من الجنوب العالمي عبر برامج مثل إيراسموس موندوس، حيث استقبلت الجامعات المغربية طلابًا من دول مثل باكستان، إذ كان أحد زملائي في السكن طالبًا في كلية الطب جاء عبر برنامج تبادل أكاديمي.
في المقابل، لا يزال عدد كبير من المهاجرين في المغرب من الأوروبيين، الذين يأتون للاستثمار أو للاستقرار بعد التقاعد، خصوصًا في أغادير ومراكش.
بعد أزمة 2008 الاقتصادية، لجأ العديد من الأوروبيين إلى المغرب بعدما فقدوا فرص العمل في بلدانهم، محاولين العثور على فرص جديدة فيه. ما حاولت تسليط الضوء عليه في الكتاب هو أن تاريخ الهجرة في المغرب معقد للغاية، كحال أي بلد آخر، لكن الصورة التي يرسمها صناع القرار تميل إلى تضخيم وجود المهاجرين الأفارقة الذين يسعون للعبور إلى أوروبا، دون الإشارة بشكل واضح إلى الفئات الأخرى من المهاجرين الذين يعيشون في المغرب، وهو ما يخلق صورة غير دقيقة عن الواقع.
- في كتابك، بدأت بالحديث عن كيفية نشأة وتطور سياسة الهجرة الأوروبية، وكيف أدى هذا التغيير في السياسة إلى جعل المغرب يلعب الدور الذي يؤديه اليوم. هل يمكنك توضيح هذه الفكرة أكثر؟
بالطبع. السياسة الأوروبية للهجرة شهدت تحولات كبيرة بعد الحرب العالمية الثانية. بدأت دول أوروبا الغربية، مثل فرنسا، ألمانيا، بلجيكا وغيرها، بإعادة الإعمار وتسريع التصنيع، لكنها واجهت نقصًا في اليد العاملة، مما دفعها إلى البحث عن عمال من الخارج.
في البداية، اعتمدت هذه الدول على مهاجرين من إيطاليا، اليونان، إسبانيا، والبرتغال، لكن مع بدء هذه الدول في التصنيع، انخفض تدفق المهاجرين منها. لذا، لجأت دول أوروبا الغربية إلى عقد اتفاقيات عمل مع دول مثل المغرب وتركيا لتشجيع الهجرة إليها.
بدأت حركة الهجرة المغربية إلى أوروبا الغربية في ذلك الوقت، ولكن مع صدمة النفط في السبعينيات، دخلت هذه الدول في ركود اقتصادي، وبدأت في تشديد سياسات الهجرة للحد من تدفق المهاجرين. ومع ذلك، فإن تشديد السياسات لا يوقف الهجرة، بل يؤدي إلى تغيير طرقها. على سبيل المثال، بدأ المهاجرون المغاربة والأتراك بجلب عائلاتهم إلى أوروبا خشية أن يصبح من المستحيل عليهم العودة إذا غادروا.
وفي ظل هذه الظروف، تحولت تدفقات الهجرة نحو إسبانيا وإيطاليا، حيث كانت اقتصادات هذه الدول أقل قوة، لكن سياسات الهجرة فيها كانت أكثر مرونة، خاصة أنها لم تكن قد انضمت بعد إلى الاتحاد الأوروبي.
ومع توقيع اتفاقية شنغن، اضطرت جميع الدول الأوروبية إلى فرض قيود على تنقل المهاجرين القادمين من دول خارج الاتحاد الأوروبي، مما أدى إلى فرض تأشيرات على المواطنين المغاربة من قبل إسبانيا وإيطاليا.
في ذلك الوقت، لم يكن لدى المغرب قانون حديث للهجرة، إذ لم يكن هناك حاجة ماسة لتنظيمها بشكل صارم، نظرًا لعدم تحولها إلى قضية سياسية، بالإضافة إلى قلة عدد المهاجرين الأجانب في البلاد. لكن ما كان لدى المغرب هو سياسة متقدمة تجاه الجالية المغربية في الخارج، تهدف إلى الحفاظ على روابطهم مع الوطن وتشجيع تحويلاتهم المالية.
ومع فرض إيطاليا وإسبانيا تأشيرات على المغاربة، أصبح على البلدين مراقبة الحدود الجنوبية لأوروبا، مما دفع إسبانيا في التسعينيات إلى طلب تعاون المغرب في ضبط الحدود، خصوصًا في سبتة، حيث لم تكن هناك آنذاك سياج حدودي، وكان العبور بين المغرب والمدينة يتم بسهولة دون ختم جوازات السفر.
بدأ بناء السياج الحدودي نتيجة مفاوضات بين السلطات الإسبانية والمغربية، ومع مرور الوقت، تدخل الاتحاد الأوروبي في النقاش، حيث طالبت إسبانيا بدعم أكبر لضبط الهجرة غير النظامية.
في هذا السياق، بدأ حوار أعمق بين المغرب والاتحاد الأوروبي بشأن سياسات ضبط الهجرة، مما أدى إلى إصدار المغرب قانون 02-03 عام 2003 لتنظيم الهجرة. ومع ذلك، لا يمكن القول بأن المغرب اعتمد هذا القانون فقط بناءً على طلب الاتحاد الأوروبي، فالمغرب كان لديه بالفعل سياسة قوية تجاه جاليته بالخارج، وتطبيق قانون يجرم الهجرة غير النظامية يعني تجريم المغاربة أنفسهم الذين يسعون للهجرة. لذا، حاول المغرب تحقيق توازن بين تعزيز مكانته الدبلوماسية مع الاتحاد الأوروبي والحفاظ على دعم داخلي لهذه السياسة.
من هنا، ركز المغرب على تطبيق القانون على المهاجرين القادمين من دول أفريقية أخرى، مما ساعد في توجيه الانتباه بعيدًا عن تأثير هذه السياسات على المهاجرين المغاربة أنفسهم. هذا هو السياق الذي تناولته في كتابي، حيث توضح هذه الأحداث كيف أصبحت سياسات الهجرة الأوروبية عاملًا رئيسيًا في تحديد دور المغرب في إدارة تدفقات الهجرة بين أفريقيا وأوروبا.
- يجعلني جوابك أتسائل متى أدرك المغرب أن سياسة الهجرة يمكن أن تكون ورقة ضغط سياسية على الاتحاد الأوروبي؟ متى أدرك المغرب قوة هذه الورقة؟ وكيف لعبها؟ وكيف يمكن تحليل دور المغرب في ضوء القانون الإنساني الدولي؟
أعتقد أن المغرب بدأ يدرك ذلك في أواخر التسعينيات، حيث بدأت إسبانيا بفرض التأشيرات على المواطنين المغاربة، ما أدى إلى بروز ظاهرة الهجرة غير النظامية. فغالبًا، عندما يتم تجريم شيء ما، تبدأ المشكلة الفعلية في الظهور. طوال التسعينيات، كانت هناك طلبات متكررة من إسبانيا للمغرب لمراقبة الحدود والمشاركة في ضبط الهجرة.
خلال بحثي في أرشيف صحيفة (El Faro de Melilla) عام 2023، درست مقالات تعود إلى أواخر التسعينيات حول حرس الحدود في المنطقة، واتضح أنه بمجرد أن بدأت مليلية في بناء السياج الحدودي، وبدأت في تحمل مسؤولية القاصرين غير المصحوبين، نشأ صراع متكرر بين السلطات الإسبانية في مليلية ونظيرتها في الناظور، وكذلك الحكومة المركزية في الرباط.
كانت إسبانيا تضغط باستمرار على المغرب لتحمل المسؤولية عن المهاجرين. عندها، بدأ المغرب يدرك أن الهجرة قضية حساسة بالنسبة لجيرانه الأوروبيين، ويمكنه استخدامها كورقة تفاوضية.
مع دخول الألفية الجديدة، ازداد اهتمام الاتحاد الأوروبي بقضية الهجرة، وبدأت الضغوط تتصاعد على المغرب. يمكننا رؤية ذلك بوضوح في مسألة القاصرين غير المصحوبين؛ فعندما يزداد عدد هؤلاء القادمين إلى جزر الكناري، الأندلس، أو فرنسا، يتم إرسال وفود سياسية إلى المغرب لمناقشة القضية. على سبيل المثال، في الأسبوع الماضي فقط، كان وفد من جزر الكناري في بنجرير يجتمع مع ناصر بوريطة لمناقشة هذه المسائل، مما يبرز العلاقة الوثيقة بين سياسات الهجرة المغربية والقانون الإنساني الدولي.
هناك عدة قضايا مرتبطة بسياسة الهجرة في المغرب. فبعد إقرار الدستور الجديد عام 2011 سعى المغرب إلى إظهار التزامه بتطبيق المعاهدات الدولية التي وقع عليها. ومع ذلك، لا يزال هناك جوانب في قانون 02-03 (قانون دخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة) لا تتماشى بالكامل مع الالتزامات الدولية للمغرب، رغم وجود مشروع لتعديله.
على سبيل المثال، فيما يتعلق بـالأطفال المهاجرين، لا يميز القانون المغربي بين معاملة البالغين والأطفال، خاصة فيما يتعلق بـالاحتجاز أو الغرامات على محاولات الهجرة غير النظامية. وهذا يتعارض مع اتفاقية حقوق الطفل، التي تنص على أنه يجب تجنب احتجاز الأطفال إلا إذا لم تكن هناك خيارات أخرى.
هناك عمل يجب القيام به في هذا المجال، ويبدو أن السياسيين المغاربة على دراية بذلك، حيث عبر الملك عن هذه النية عند إعلانه عن السياسة الجديدة للهجرة عام 2013.
كانت تلك السياسة محاولة لتأكيد التزام المغرب بمواءمة قوانينه الخاصة بالهجرة مع القوانين الدولية. لكن مع تزايد الضغوط الأوروبية، خاصة من إسبانيا، أصبح من الصعب تحقيق هذا التوازن بين ضبط الحدود والالتزام بـالقانون الإنساني الدولي.
- سلطت الضوء في كتابك على المنظمات التي تتلقى المساعدات وتؤدي دورًا في سياسات الهجرة، من يسيطر على هذه المساعدات في المغرب؟ وما هو دور المنظمات المجتمع المدني في إدارة ملف الهجرة بالمغرب؟
هذا سؤال مهم جدًا، وإجابتي ستكون أن الجميع معنيون بهذه المسألة. تؤدي المساعدات في جوهرها إلى توسيع شبكة الأفراد والمنظمات المنخرطة في ضبط الهجرة بالمغرب بدرجات متفاوتة. في الكتاب، ركزت على المساعدات المقدمة من الجهات الحكومية الأوروبية، مثل الاتحاد الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء. ولكن من المثير للاهتمام أن الجهات التي تقدم المساعدات ليست بالضرورة هي الأكثر نفوذًا في المشهد.
ما اكتشفته في بحثي هو أن السلطات المغربية، بما في ذلك وزارة الداخلية، وزارة الشؤون الخارجية، السلطات المحلية مثل العمالات والولايات، خاصة في المناطق الحدودية، تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد حجم وأشكال توزيع المساعدات.
فالمغرب يفاوض بنشاط مع الاتحاد الأوروبي لزيادة حجم المساعدات، مستندًا إلى الأرقام التي توضح حجم الإنفاق المغربي على مراقبة الحدود. وهذا هو السبب في أنني أحذر دائمًا من التصور القائل بأن الاتحاد الأوروبي “يشتري” تعاون المغرب في ضبط الحدود، لأن المغرب ينفق على هذا المجال أكثر بكثير مما يحصل عليه من المساعدات الأوروبية.
على سبيل المثال، في عام 2018، قدمت السلطات المغربية أرقامًا دقيقة عن إنفاقها السنوي على مراقبة الحدود، وكانت المساعدات الأوروبية المقدمة لهذا الغرض بعيدة جدًا عن تغطية هذا الإنفاق. ومع ذلك، فإن السلطات الوطنية تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد كيفية تخصيص هذه المساعدات، سواء لتمويل إدارة الحدود (مثل شراء المعدات، تطوير السياج الحدودي، دعم قوات المراقبة)، أو توجيهها نحو المنظمات غير الحكومية لتمويل برامج التعليم، والرعاية الصحية للمهاجرين.
أما على المستوى المحلي، فإن السلطات في المناطق الحدودية تتحكم في تنفيذ هذه السياسات. قد لا تمنح التراخيص اللازمة لبعض المنظمات غير الحكومية لمزاولة أنشطتها، أو قد تمنع الوصول إلى مناطق معينة مثل الغابات القريبة من سبتة ومليلية، أو تمنع عقد تجمعات عامة حول قضايا الهجرة. هذا يمنح السلطات المغربية نفوذًا واسعًا في هذا المجال.
من جهة أخرى، تلعب المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية، بالإضافة إلى المنظمات الأممية مثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR) والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، دورًا هامًا في هذا المشهد. فإلى جانب توفير التمويل لبعض المشاريع، تساهم هذه المنظمات في صياغة السردية المرتبطة بالهجرة في المغرب.
على سبيل المثال، إذا قامت منظمة غير حكومية بكتابة تقرير يشير إلى أن الهجرة في المغرب بدأت في التسعينيات وأنها تقتصر فقط على المهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء (وهو مصطلح غير دقيق)، فإنها بذلك تخلق سردية غير صحيحة.
يؤدي هذا الخطاب إلى زيادة الضغوط على المهاجرين القادمين من السنغال، الكونغو، ساحل العاج وغيرها، بينما يتم إغفال الأبعاد الأخرى للهجرة في المغرب، مثل الهجرة الأوروبية والاستثمارات الأجنبية.
إذن، المساعدات لا تقتصر فقط على الدعم المالي، بل تساهم أيضًا في توسيع دائرة الجهات المنخرطة في ضبط الهجرة، وتشكيل الخطاب العام حول المهاجرين. هذا الدور معقد جدًا، وأكثر دقة وتشعبًا مما يتم تصويره في الكتب أو الخطابات الشعبية حول الهجرة في المغرب.
- ذكرت في كتابك أن هناك ثلاثة أنواع من المنظمات غير الحكومية التي تتلقى المساعدات وتقوم بعملها وفقًا لتوجهاتها الخاصة. وفي الوقت نفسه، أشرت إلى وجود سياسات قادرة على التلاعب بهذه المساعدات لإعادة تشكيل السياسات العامة. هل يمكنك توضيح هذه الفكرة أكثر؟
نعم، بالطبع. أعتقد أن هناك عدة طرق تتعامل بها المنظمات مع التمويل المؤسسي، وهذا لا ينطبق فقط على المغرب، بل يحدث في العديد من الدول. هناك منظمات ترفض تمامًا تلقي هذه الأموال لأنها لا تريد أن يكون لها أي علاقة بهذه السياسات. وهناك منظمات تقبل التمويل بالكامل دون طرح أي تساؤلات، فمثلاً إذا تم توفير تمويل لإنشاء مركز لترحيل المهاجرين، فإنها تأخذ المال وتنفذ المشروع كما هو دون التفكير في تبعاته.
ثم هناك النوع الثالث من المنظمات، وهو الأكثر شيوعًا، والذي يواجه معضلة معقدة. فمعظم المنظمات غير الحكومية لديها موارد مالية محدودة، ومن الصعب إيجاد مصادر تمويل لتشغيلها. وأبرز التمويلات المتاحة تأتي من الجهات الحكومية، وفي السياق المغربي، تكون هذه الجهات غالبًا مرتبطة بسياسات ضبط الهجرة. لذلك، من الصعب على بعض المنظمات أن ترفض التمويل تمامًا لمجرد انتقادها لهذه السياسات.
ما تقوم به العديد من هذه المنظمات هو قبول التمويل الأوروبي المخصص لمشاريع إدارة الهجرة، لكنها تحاول تطوير مشاريع ذات أهداف مختلفة، مثل تمكين المجتمعات الأفريقية في المغرب لمساعدتهم على التعامل مع البيروقراطية المغربية.
لكن هذا الوضع معقد للغاية، لأن المنظمة تحتاج إلى:
- صياغة المشاريع بلغة تتناسب مع توجهات المانحين، وإلا فلن تحصل على التمويل.
- تصميم مشاريع مقبولة من قبل السلطات المغربية، وإلا فلن يُسمح لها بالعمل.
- الحفاظ على وضوح أهدافها الحقيقية حتى تتمكن من كسب ثقة ودعم المجتمعات المهاجرة والمجتمع المدني المغربي.
هذه معادلة صعبة للغاية، وبعض المنظمات تنجح أحيانًا وتفشل أحيانًا أخرى في تحقيق هذا التوازن.
في الكتاب، قدمت تصنيفًا عامًا لهذه المنظمات، لكنني لاحظت أن بعضها يتنقل بين هذه الفئات المختلفة وفقًا للظروف.
ومؤخرًا، تحدثت مع الباحث الإيطالي باولو كويتيتا، الذي أجرى بحثًا مشابهًا في ليبيا، ومصر، وتونس، ووجد نموذجًا مشابهًا جدًا، مما يشير إلى أن هذا الوضع لا يقتصر على المغرب، بل يشمل أيضًا دولًا أخرى متأثرة بسياسات “توطين الهجرة” الأوروبية.
- كيف تؤثر معايير تحديد الأولوية في المساعدات الإنسانية على الفئات المختلفة من المهاجرين، وما هي التناقضات التي تبرز في سياسات الدعم والعودة الطوعية؟
ما أردت قوله هو أنه عندما تقرر منظمة ما تقديم الدعم لمجموعة معينة، فإنها، بحكم أن مواردها محدودة، تكون قد قررت ضمنيًا من لن يحصل على المساعدة. هذا الأمر ينطبق بشكل خاص على المنظمات الإنسانية التي تعمل في مناطق ذات احتياجات هائلة.
وهذه المسألة ليست مقتصرة على المغرب؛ فحتى في الدول الأوروبية، يضطر العاملون الاجتماعيون دائمًا إلى تحديد أولويات المساعدة، بحيث يتم دعم فئات معينة وإهمال فئات أخرى. غالبًا ما تعتمد هذه المشاريع على معايير “الهشاشة”، بحيث يتم تحديد الأشخاص الأكثر عرضة للخطر في حال لم يتلقوا المساعدة.
ما يحدث دائمًا هو أنه إذا كنت رجلًا شابًا في سن العمل وبصحة جيدة ظاهريًا، فإن فرصك في تلقي المساعدة تكون ضئيلة جدًا، حتى لو كنت تعاني من أزمة نفسية حادة. لأن السياسات تركز على المهاجرين الأكثر ضعفًا، مثل الأطفال، النساء، أو المصابين بإعاقات ظاهرة.
من المثير للاهتمام أن السياسات الأوروبية للهجرة تصوّر المهاجر الأفريقي الذكر على أنه تهديد، فيُنظر إليه على أنه شخص قادم ليأخذ وظائف الأوروبيين. وعبر تجاهل هؤلاء المهاجرين الذكور في برامج الدعم، يتم بشكل غير مباشر تعزيز هذا التصور النمطي، حيث يُترك هؤلاء الرجال دون مساعدة، مما يعزز فكرة أنهم “غير مستحقين” لها.
وفي نفس الوقت، هناك تناقض واضح في سياسات الإعادة الطوعية التي تديرها المنظمة الدولية للهجرة (IOM). فمثلاً، المهاجرون الذين يوافقون على العودة الطوعية إلى بلدانهم يجب أن يكونوا في صحة جيدة جسديًا ونفسيًا ليتمكنوا من العودة. فإذا كان المهاجر يعاني من صدمة نفسية شديدة بسبب التجربة القاسية التي عاشها في الغابات المحيطة بسبتة ومليلية، فإنه لن يكون مؤهلًا للعودة الطوعية لأنه قد لا يكون قادرًا على تحمل الرحلة.
وبهذا الشكل، نجد أن المهاجرين الذكور الشباب هم الفئة الأقل استهدافًا بالمساعدة. فهم لا يحصلون على الدعم لأنهم لا يعتبرون “ضعفاء”، ولكن في الوقت نفسه، إذا أصيبوا بأزمات نفسية حادة، فقد لا يكونون مؤهلين للعودة الطوعية. وبهذه الطريقة، تتحول سياسات “الرعاية” إلى أداة إقصاء، حيث يتم تهميش نفس الفئة مرارًا وتكرارًا.
- سلطت الضوء في كتابك على فشل إدماج المهاجرين في سوق العمل المغربي، وربطت هذا الفشل بقصور السياسة المغربية في إدماج المهاجرين. ألا ترين أن الوضع الاقتصادي للمغرب هو جزء من المشكلة؟ فالمغرب، في نهاية المطاف، ليس دولة أوروبية، ويواجه تحدياته الاقتصادية الخاصة التي تحدّ من قدرته على التعامل مع أوضاع المهاجرين؟
نعم، بالطبع، وقد حاولت التطرق إلى هذه النقطة في أحد فصول الكتاب، رغم أنها تخرج قليلاً عن نطاق تركيزي الأساسي. ما أراه حقيقة لا جدال فيها هو أن ارتفاع معدلات البطالة، والعمل غير المنتظم، والتشغيل في القطاع غير الرسمي بين المهاجرين في المغرب يعكس بشكل مباشر الوضع العام لسوق العمل المغربي.
ما حاولت توضيحه في الكتاب هو أن الوضع الحالي لسوق العمل المغربي، الذي يتميز بارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وانتشار العمالة غير المستقرة، يرتبط بشكل وثيق بكيفية اندماج المغرب في الاقتصاد العالمي.
فالاقتصاد المغربي اليوم هو نتيجة عقود من القرارات الاقتصادية التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية، عندما كان المغرب يُنظر إليه كمصدر لليد العاملة الرخيصة لصالح الاستثمارات الأجنبية.
منذ فترة الحماية الفرنسية والإسبانية، تم ضخ رؤوس الأموال الأوروبية في المغرب ليس لتطوير اقتصاد يخدم السكان المحليين، بل لتصدير الإنتاج إلى الخارج. يحدث هذا في أماكن أخرى أيضًا، فعلى سبيل المثال، أعيش في جزر الكناري، حيث نشهد وضعًا مشابهًا: عندما يتم تطوير اقتصاد موجه للتصدير، لا يتم إنتاج السلع لاستهلاك السكان المحليين، بل لتلبية احتياجات الأسواق الخارجية. وهذا يؤدي إلى الضغط على تكلفة العمالة، حيث تسعى الشركات إلى دفع أقل الأجور الممكنة، مما يؤدي إلى تقويض الابتكار والاستثمار في قطاعات اقتصادية جديدة.
في فترة ما بعد الاستقلال، حاول المغرب تغيير هذا المسار عبر التركيز على التصنيع في قطاعات رئيسية مثل الفوسفات، وفي السنوات الأخيرة، قام المغرب باستثمارات كبرى في الطاقة المتجددة، والبحث العلمي، والتعليم العالي، مثل إنشاء مراكز بحثية وجامعات خاصة.
مع ذلك، فإن تغيير هذا المسار الاقتصادي الراسخ يتطلب وقتًا طويلاً، خاصةً مع استمرار هيمنة رؤوس الأموال الأجنبية، حيث لا تزال العديد من الشركات الفرنسية والإسبانية تستثمر في المغرب للاستفادة من العمالة الرخيصة، كما هو الحال في قطاع زراعة الطماطم والفراولة.
ورغم أن السلطات المغربية تبذل جهودًا نشطة لتغيير هذا الواقع، إلا أن إعادة هيكلة الاقتصاد تتطلب وقتًا طويلاً بسبب عمق التشابكات الاقتصادية القائمة. ما حاولت تسليط الضوء عليه في الكتاب هو أن هناك قيودًا قانونية لا تزال تعيق المهاجرين من الاندماج الكامل في سوق العمل المغربي بشكل منتظم، ولكن انتقادي الرئيسي كان موجّهًا إلى القطاع المانح للمساعدات، حيث يبدو أنه يتعامل مع إدماج المهاجرين في سوق العمل المغربي وكأنه قضية منفصلة عن البنية الاقتصادية للبلاد، وكأن إدماج المهاجرين يمكن تحقيقه ببساطة عبر تنظيم دورات تدريب مهني فقط.
بالطبع، الدورات التدريبية قد تكون مفيدة في تطوير المهارات وخلق فرص للتفاعل بين الناس، لكنها في كثير من الأحيان تؤدي إلى إحباط كبير بين المهاجرين الذين يخضعون لدورات تدريبية متكررة دون أن يتمكنوا من العثور على وظائف حقيقية. وهذا هو الواقع الذي حاولت تصويره في الكتاب، وهو أن سياسات إدماج المهاجرين لا يمكن فصلها عن التاريخ الاقتصادي والبنية العمالية للمغرب.
- في الكتاب، وفي الفصل المتعلق بـ “شركة العودة” ناقشت كيف يتم استخدام برنامج العودة الطوعية كأداة للتحكم في الهجرة، وشرحت كيف يوسع هذا البرنامج من قدرة الدولة والمنظمات الدولية على ترحيل المهاجرين. هل يمكنك توضيح هذه الفكرة أكثر؟ لأنك قدمت تصورًا بأن الهجرة أصبحت بمثابة “شركة”، فكيف تحولت الهجرة إلى قطاع اقتصادي في المغرب؟
صحيح تماما، ما حاولت توضيحه هو أن قطاع الهجرة أصبح جزءًا من الاقتصاد، أي أنه لم يعد مجرد ظاهرة اجتماعية، بل تحول إلى مجال يمكن العمل فيه. لم تعد الهجرة مجرد حركة بشرية طبيعية كما كانت عبر التاريخ، بل أصبحت قطاعًا مؤسساتيًا، حيث لكل جهة دور تلعبه، ولكل منظمة مشروع متعلق بالهجرة، مما جعلها جزءًا من النشاط الاقتصادي العام.
في الفصل الخاص بـ”العودة الطوعية”، حاولت تسليط الضوء على أن هذا البرنامج يُطرح كـ بديل أكثر إنسانية للترحيل القسري، حيث يُسمح للأشخاص الذين يجدون أنفسهم في وضع صعب باتخاذ قرار العودة إلى بلدانهم بأنفسهم. ولكن في الوقت نفسه، يوسع هذا البرنامج من قدرة الدولة والمنظمات الدولية على إخراج عدد أكبر من المهاجرين من البلاد.
على سبيل المثال، ينص القانون المغربي 02-03 على إجراءات واضحة لإعادة المهاجرين الأجانب إلى بلدانهم، والتي تشمل نوعين من الترحيل:
- الإبعاد القسري: يطبق على المهاجرين غير النظاميين الذين انتهت صلاحية تصاريح إقامتهم أو لم يحصلوا على تصريح إقامة منذ البداية.
- المرافقة إلى الحدود: إجراء يُستخدم في ظروف أوسع، خاصة إذا كان الشخص يُعتبر تهديدًا للأمن الوطني.
لكن برنامج العودة الطوعية يستهدف المهاجرين الذين لا ينطبق عليهم أي من هذه الإجراءات. في البداية، كان هذا البرنامج في المغرب يقتصر على المهاجرين غير النظاميين فقط، لكن في دول أوروبية أخرى، مثل إيطاليا، كان يُسمح حتى للمهاجرين الذين يحملون إقامة قانونية بالتقدم لهذا البرنامج. وهناك مرحلة معينة في إيطاليا، لم يكن بإمكان المهاجرين غير النظاميين الاستفادة من العودة الطوعية لأن الهجرة غير النظامية أصبحت جريمة جنائية، وبالتالي أي شخص لديه سجل جنائي لم يكن مؤهلًا للبرنامج، مما جعل الأمر يبدو متناقضًا تمامًا.
ما يفعله برنامج العودة الطوعية هو أنه يوسع نطاق الترحيل بحيث يشمل حتى الأشخاص الذين لم يتم ضبطهم من قبل الشرطة، أو لم يرتكبوا أية مخالفة قانونية تتعلق بالأمن القومي. وبهذا، يصبح برنامج العودة الطوعية أداة غير مباشرة لتعزيز قدرة الدولة على ترحيل المهاجرين دون الحاجة إلى اللجوء إلى إجراءات قانونية صارمة.
ومن الأمور التي وجدتها مثيرة للاهتمام أثناء البحث، أن المنظمة الدولية للهجرة تسعى إلى التحكم في نوعية الأشخاص الذين يمكنهم الاستفادة من البرنامج.
فمثلًا، هذا البرنامج مصمم ليستهدف الأشخاص في “حالة ضعف شديد”، مثل الأمهات العازبات، المصابين بإصابات خطيرة، أو الأشخاص غير القادرين على العمل. ولكن في الواقع، هناك أسباب أخرى قد تدفع الأشخاص إلى العودة الطوعية، مثل وفاة أحد أفراد العائلة في الوطن، أو رغبتهم في العودة بعد فترة طويلة في المغرب.
هناك أيضًا فئة من المهاجرين، مثل أصحاب المحلات التجارية الصغيرة، الذين قد يستخدمون البرنامج فقط للحصول على تذكرة سفر مجانية للعودة إلى بلدانهم لجلب المزيد من البضائع، ثم يعودون إلى المغرب لاحقًا. هذه الفئة كانت تحاول المنظمة الدولية للهجرة استبعادها من البرنامج، رغم أنهم من الناحية التقنية كانوا أكثر تطابقًا مع مفهوم “العودة الطوعية” لأن قرارهم كان مبنيًا على اختيار شخصي واضح.
لكن ما كان يثير الاهتمام هو أن الأشخاص الذين كانوا مؤهلين للاستفادة من البرنامج كان يجب أن يتناسبوا مع صورة نمطية معينة. وهذا يوضح كيف أن الهجرة أصبحت جزءًا من منظومة اقتصادية منظمة، وليست مجرد ظاهرة اجتماعية عشوائية.
- في الفصل المعنون بـ “اليد اليسرى للحدود”، سلطت الضوء على دور المنظمات غير الحكومية في الحدود المغربية-الإسبانية. ما هي النتائج التي توصلت إليها بشأن هذه النقطة تحديدًا؟
كان هذا الفصل من أكثر الفصول تعقيدًا وصعوبة في الكتابة، لأن المنظمات التي تعمل قرب الحدود تقوم بعمل حيوي للغاية، حيث تقدم المساعدة للمهاجرين الذين تعرضوا لإصابات أثناء محاولتهم العبور أو أثناء عمليات إخلاء الغابات التي تقوم بها السلطات.
السبب في أنني أطلقت على الفصل اسم “اليد اليسرى للحدود” هو أن هذه المنظمات تعمل بشكل غير مباشر على معالجة العواقب السلبية لسياسات ضبط الحدود، فهي تعمل على ترميم الأضرار التي تنتج عن عمليات المراقبة والتشديد الأمني. وما حاولت توضيحه هو أن القيام بهذا العمل يتطلب جهدًا هائلًا، لأن وجود هذه المنظمات قرب الحدود يتطلب منها الحفاظ على مستوى عالٍ من الحذر والتوازن في أنشطتها.
فمثلًا، للوصول إلى الغابات القريبة من مليلية، كان على المنظمات التنسيق مع السلطات المحلية (الولاية) والتفاوض بشأن الفترات التي يُسمح لها بالعمل فيها. وهذا يعني أنها بحاجة إلى علاقة عمل مع الجهات الرسمية، رغم أن أهداف هذه الجهات تختلف جذريًا عن أهداف المنظمات الإنسانية.
في هذا الفصل، حاولت تتبع تطور هذا النشاط عبر السنوات. ففي بداية الألفية، لم تكن هناك أي منظمات تقريبًا تعمل في هذه المنطقة الحدودية. ومع زيادة الاهتمام الإعلامي، بدأت منظمات مثل “أطباء بلا حدود” العمل هناك، لكنها انسحبت لاحقًا، ليحل محلها فاعلون جدد. واليوم، نشهد وجودًا متزايدًا لمنظمات ممولة بالمساعدات الإنسانية في هذه المناطق.
أحد الجوانب المثيرة للاهتمام بالنسبة لي كان التداخل بين تاريخ هذه المنطقة وعلاقتها بالمغرب من جهة، وبين طبيعة العمل الإنساني فيها من جهة أخرى. فمدينة الناظور، كونها جزءًا من الريف المغربي، ظلت لفترة طويلة بعيدة عن المركز السياسي والاقتصادي للبلاد. تاريخيًا، نشأت الناظور كمستوطنة عسكرية إسبانية، وظلت تربطها علاقة وثيقة بمليلية، حيث كان الناس يعبرون الحدود يوميًا قبل إغلاقها بسبب الجائحة.
ما وجدته جديرًا بالتوثيق هو كيف تعمل هذه المنظمات على تقديم الرعاية للمهاجرين المصابين في سياق إغلاق منطقة كانت دائمًا متصلة تاريخيًا، لكنها الآن مفصولة بسياج حدودي.
لذلك، كان هذا الفصل الأكثر تعقيدًا في الكتاب، نظرًا لوجود عدة أبعاد تاريخية وعملياتية يجب تحليلها. آمل أن أكون قد وفّقت في تسليط الضوء عليها بشكل كافٍ، لكني أعتقد أن هذا الموضوع لا يزال بحاجة إلى مزيد من البحث والدراسة.
- باعتبارك خبيرًا في دراسات الحدود: كيف ترين السياسة المغربية تجاه الحدود، وكيف يستخدم المغرب مسألة الحدود كورقة تفاوضية مع الفاعلين الدوليين مثل الأمم المتحدة والولايات المتحدة؟ خاصة فيما يتعلق بربط ضبط الحدود بمسألة الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء. كيف تحللين هذا الأمر؟
الأمر مثير للاهتمام، فقد كنت أعيش في مليلية عندما أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن الموقف الجديد لإسبانيا بشأن قضية الصحراء. وبصراحة، لو لم أكن هناك لأرى ذلك بأم عيني، لما صدقت مدى سرعة التغيرات التي حدثت.
قضية الصحراء المغربية تُعتبر حاضرة في جميع قضايا ضبط الحدود، رغم أنها نادرًا ما تُذكر بشكل مباشر. فبمجرد إعلان بيدرو سانشيز دعمه لخطة الحكم الذاتي المغربية، استؤنفت فورًا المناقشات حول إعادة فتح الحدود بين بني أنصار ومليلية، بعد أن كانت مجمدة تمامًا لمدة عامين.
أتذكر أنني كنت أتحدث مع زميلي في السكن، حيث وقع هذا الإعلان في بداية مارس 2022، وكنا نتساءل: “متى ستُعاد فتح الحدود؟”. توقعتُ حينها أن ذلك قد يستغرق عامًا على الأقل، لأن إغلاق الحدود استمر عامين كاملين، وإعادة فتحها تتطلب مفاوضات وإجراءات معقدة. لكن المفاجأة كانت أنه بعد أسبوعين فقط، كان جميع أفراد الشرطة الإسبانية على الحدود منهمكين في اجتماعات يومية لإدارة عملية إعادة الفتح.
ثم رأينا بيدرو سانشيز يسافر إلى الرباط للقاء الملك محمد السادس، وكان من المذهل رؤية مدى ارتباط القضيتين. فقد كانت إسبانيا بحاجة ماسة إلى تعاون المغرب في ضبط الحدود والهجرة، ما دفعها إلى إثارة قضية الصحراء من جديد. كانوا يعلمون جيدًا أن هذه هي الورقة الحاسمة.
لذلك، أعتقد أن ضبط الهجرة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ومسألة الصحراء المغربية، مترابطان بشكل وثيق للغاية، وأتوقع أن يبقى هذا الترابط قائمًا لفترة طويلة.