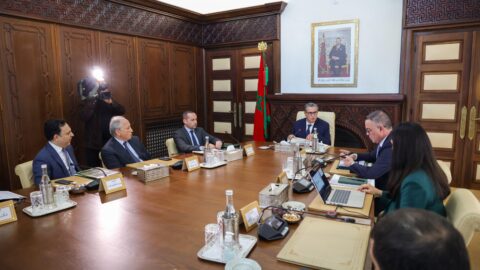“كيّة الصحافيين”

نمارس في بعض الأحيان الإنكار، عن وعي أو بدونه، لتجنّب قسوة ومرارة الواقع. نؤجّل النظر في المرآة لأن الصورة موجعة، ونقنع أنفسنا بأن الأمر سحابة وستمر، وبأن ما نعيشه مجرد أزمة عابرة في نموذج اقتصادي مأزوم أو في شروط اجتماعية خانقة أو في مناخ سياسي متقلّب.
لكن الحقيقة التي لا تقبل التجميل هي أن حالة الصحافة في المغرب اليوم أسوأ من كل توصيفاتنا الجاهزة، وأكثر مأساوية من أي عنوان نضعه لتلطيف الفاجعة.
“كيّة الصحافيين”، قالها الصديق عبد الله الترابي مرتين في حلقة “من الرباط“كيّة الصحافيين” الأخيرة، وبنبرة من يعرف أن الملح لم يعد يكفي لوصف الجرح، في لحظة مقارنة قاسية بين ما تعيشه “صاحبة الجلالة” (زعما زعما) وما حقّقه المحامون من نصر كبير ضد مشروع كان يهدّد مهنتهم في مقتل.
وفي السياق نفسه، كتب الزميل مصطفى ابن الرضي عبارة تجرّح أكثر مما تشرح حين وصف الصحافيين بأنهم “مكفولو الأمة”، لا باعتبارها شتيمة بل كمرآة لدرجة الهشاشة والاعتماد والخذلان.
أقول هذا وأنا أرفض أن يتحول الألم إلى مهرجان شكاوى، وأرفض أيضا أن يتحول الغضب إلى عجز. لكنني لا أرى اليوم مجالا للمواربة أو التجاهل أو إنكار الواقع، خصوصا وأن السؤال لاحقني بإلحاح أمس في ندوة طلابية بمدينة طنجة: لماذا نجح المحامون وفشل الصحافيون؟
واجهت السؤال نفسه قبل أيام على لسان الزميل حميد المهداوي. وفي الحالتين كان الجواب السريع الجاهز يخرج وحده: المحامون لا ينتظرون صرف أجورهم من موظفي الحكومة نهاية كل شهر، بينما جزءٌ واسع من الصحافة، مباشرة أو بالتفافات كثيرة، بات مربوطا بخيط الرواتب والدعم والتحويلات.
جوابٌ يبدو مقنعا لأنه يلتقط لبّا اقتصاديا حقيقيا، لكنه في العمق اختزالٌ معيب لا يعترف بفداحة النكبة التي تعيشها مهنة يُفترض أنها حملت لقبا لم تحمله حتى مهنة المحاماة حتى وهي جزء لا يتجزأ من أسرة العدالة: “السلطة الرابعة”.
لننظر إلى المشهد الحزين كما هو، دون مساحيق: مقاولات صحافية عاجزة عن صرف أجور صحافييها منذ صيف 2020، و”فرسان” الصحافة ينتظرون، حين تقع مشكلة إدارية أو مرحلة انتقالية بين ميزانية وأخرى، كما ينتظر “المحجورون” على أبواب الضرورة، لا على أبواب المهنية.
ثم الهيئة التي يفترض فيها تمثيل المهنة وتحصينها وحمايتها باسم التنظيم الذاتي، في حالة أشد من “منكوبة”.
المجلس الوطني للصحافة استحال إلى لجنة مؤقتة، واللجنة خرجت من ولايتها، والفضيحة لا تكتفي بأن تلاحقها، بل تكاد تصبح تعريفا لها. موظفوها عالقون منذ أشهر في وضع لا يشبه مؤسسة دستورية أو هيئة تنظيم ذاتي، بل يشبه مكتبا مهجورا يُدار بالقروض الصغيرة، وبالذهاب إلى المقر كي لا يفعلوا فيه شيئا ثم العودة للانتظار، وكأننا أمام طقس يومي لتطبيع الانهيار.
وفي قلب هذا العبث الإداري، يتحول الصحافي نفسه إلى كائن منتهي الصلاحية. بطاقة مهنية لا تُجدَّد لأن المؤسسة المعنية غائبة أو معطّلة، وهو وضعٌ لو وقع في دولة تُحترم فيها المهن لكان فضيحة دولية، لكنه هنا يُقدّم باعتباره تفصيلا.
ثم يأتي انهيار النموذج الاقتصادي شبه التام. صغار يقتاتون على دعم يذهب إلى الأجور ومن فتات الإعلانات، ومن لا يحصل على دعم في شكل أجور ينتظر دعما “جزافيا” لا يساوي أجرة “مدير نشر” واحد في مؤسسة محظوظة ومحظيّة.
أما الإشهار فليس مجرد سوق، بل كثيرا ما يتحول إلى آلية شراء للخطوط التحريرية، أو إلى رافعة لصناعة منصات دعائية موالية، فيسقط القارئ المفترض بين “مؤثر” يبيع الانفعال و”مضلل” يبيع الوهم.
ثم لننظر إلى جوهر المهنة: الأخبار والتغطيات والتحقيقات والاستجوابات… كلمات من قاموس ذكريات. لم يعد من هذه “الأجناس” سوى ما يستوعبه “الكيت” التجاري الموجّه لمن يدفع أكثر، أو ما تسمح به توازنات الخوف والرغبة في البقاء.
هكذا تُسحب الصحافة من مكانها الطبيعي كسلطة مساءلة، لتُدفع نحو وظائف خدماتية: ترويج، وتبييض، وتزيين، أو إزعاج صغير محسوب لا يقترب من المراكز الحقيقية للقوة.
عند هذه النقطة بالذات يبرز سؤال “لماذا نجح المحامون وفشل الصحافيون” كأنه سؤال قاس في امتحان بلا رحمة.
المحامون نجحوا لأنهم امتلكوا شروط المعركة، من تنظيم مهني متجذّر، واستقلال اقتصادي نسبي، وتقاليد تضامن صارمة، وقدرة على تحويل الاحتجاج إلى فعل مؤثر في الدولة وفي المجتمع.
حين قاطع المحامون المحاكم، فعلوا ذلك وهم يعلمون أن المواطن سيتألم من تعطيل مصالحه، لكنهم بذلوا جهدا لإقناع الناس بعدالة قضيتهم، فصبر المواطن إلى جانبهم، وفهم أن المعركة ليست ضدّه بل من أجله أيضا، وأن استقلال الدفاع جزء من استقلال العدالة. ثم عرفوا أين يختبئ “أصحاب دعوتهم”، ورفعوا أصواتهم، ورفضوا الخضوع والانكسار، فانتهى الأمر بأن الدولة أنصتت واعترفت واستجابت… أو على الأقل فتحت باب التراجع.
أما الصحافيون، فدخلوا المعركة، إن دخلوا، بأجساد متعبة، وبمؤسسات ممزقة، وبسوق يبتزهم، وبتمويل يجرّهم إلى حيث لا يريدون، وبانقسام داخلي يُشبه لعنات صغيرة تتغذى من بعضها.
الصحافي الذي لا يملك أجر شهره، يطلب منه أن يقف في وجه من يملك ميزانية الدولة وأموال قارون. الصحافي الذي لم تُجدّد بطاقته لأن المؤسسة التي تُصدرها نفسها معلّقة، يطلب منه أن يقود معركة التنظيم الذاتي بثقة مؤسساتية. الصحافي الذي تُغلق أمامه أبواب القضاء والنقاش العمومي ويُترك وحيدا في مواجهة حملات التشهير والاستهداف، يطلب منه أن يرفع السقف دون شبكة حماية.
ومع ذلك، في هذا الركام كله، لا يجوز أن نستلذّ دور الضحية أو نُقدّس العجز. لأن في المشهد نقطة ضوء تستحق أن تُشهر بصوت عال، حتى لا يتحول اليأس إلى قدر.
ما وقع مع المحكمة الدستورية قصة ملحمية عظيمة مقارنة بالسياق الطافح بالهزال. ليست الملحمية في النص وحده، بل في أن تتحرك القنوات السياسية والمؤسساتية، وحين تُفعَّل الأعصاب الدستورية والقانونية للدولة، لتتحقّق الاستجابة وإنقاذ الموقف حتى داخل ميزان قوى غير متكافئ.
في هذا الملف، رأينا معارضة صغيرة، وضعيفة عدديا، ومشتتة سياسيا، تنجح في توحيد نفسها خلف قضية واحدة، فجمعت النصاب الدستوري لإدخال المحكمة الدستورية في المعادلة. فانتهت الأخيرة إلى التصريح بمخالفة مواد بعينها للدستور.
هذه القصة لا تعني أن معركة الصحافة انتهت. بل تعني أن الإنقاذ ممكن حين نخرج من مقعد الفراغ إلى مقعد الفعل. وأن المعركة لا تُربح بالندب ولا ببلاغات عامة ولا بالصراخ في منصات التواصل، بل بالاشتغال داخل المؤسسات، وبالتقاط نقاط الضعف القانونية والدستورية في النصوص، وببناء تحالفات، وباستعادة المجتمع كحليف لا كجمهور عابر.
نعود إلى السؤال الذي طاردني في طنجة: لماذا نجح المحامون وفشل الصحافيون؟ والجواب هو أن المحامين فهموا، عمليا لا نظريا، أن الكرامة المهنية لا تُمنح بل تُنتزع ضمن قواعد الدولة نفسها، وأن الشرعية تتقوّى حين يتقوى التنظيم، وحين يصبح الاحتجاج وظيفة جماعية لا بطولة فردية.
ولأن الصحافة، مع الأسف، قبلت طويلا أن تُدار كقطاع يضم هشاشة مالية إلى هشاشة تحريرية، والأخيرة تنتج هشاشة في الثقة العامة تعود فتغذي انهيار السوق، في دائرة جهنمية لا تنتهي إلا حين تُكسر من مكان ما.
لكن الاعتراف بهذا ليس نهاية الكلام، بل بدايته. لأن الدرس العميق الذي ينبغي التقاطه من معركة المحامين ومن ملحمة المحكمة الدستورية معا هو أن الأمل كل الأمل في الرهان على القيم والمبادئ والعمل من داخل المؤسسات والاعتصام بها وإعمالها.
نعم، الدولة تنصت وتحترم عندما تجد من يقف ويصمد ويدافع، لا عندما تجد قطاعا مشتتا يشتكي ثم يعود إلى يومياته وكأن شيئا لم يكن. ولا بديل عن تقوية المؤسسات التي تمثل المجتمع في حماية الحقوق والحريات، سواء كانت نقابات أو هيئات مهنية أو جمعيات أو أحزابا أو برلمانا.
إن أخطر ما في وضع الصحافة اليوم ليس فقط تأخر الأجور أو تعطل البطاقات أو انهيار المقاولات، بل التطبيع مع هذا كله بوصفه عاديا. الأخطر أن نعتاد أن المهنة بلا هيئة فاعلة، وبلا سوق سليم، وبلا حماية اجتماعية، وبلا ثقة عامة، ثم نتساءل لماذا لا تنتصر حين تخوض معركة. لا ينتصر من يدخل المعركة بأدوات مكسورة ثم يلوم العالم لأنه لم يصفق له.
الصحافة المغربية تعيش اليوم أسوأ ما عاشته منذ الاستقلال، لأن الأزمة لم تعد أزمة تضييق فقط ولا أزمة اقتصاد فقط، بل أزمة معنى. ما وظيفة الصحافي؟ ما حدود استقلاله؟ من يحميه ومن يمثل مهنته؟ كيف يُموَّل الإعلام دون أن يتحول التمويل إلى حبل على رقبة التحرير؟ كيف نستعيد القارئ من فوضى “المؤثر” و“المضلل” إلى فضاء المعرفة الموثوقة؟
مهما بدا الجواب صعبا، فإنه يبدأ من نقطة واحدة: الحضور لا الانسحاب. المشاركة لا المقعد الفارغ. بناء التنظيم لا الهروب من التنظيم. إعادة الشرعية إلى المؤسسات لا السخرية منها حتى تموت. حين نُسلم بأن المؤسسات فاشلة وننسحب، نمنح الفشل شهادة رسمية ونمنح من يريدون السيطرة فراغا جاهزا لملئه.
قد يبدو هذا الكلام مثاليا في زمن القسوة، لكنه في الحقيقة هو الواقعية الوحيدة الممكنة. لأن ما أثبتته تجربة المحامين، وما أثبتته معركة المحكمة الدستورية، هو أن الدولة تتراجع عندما تواجه مجتمعا منظما يعرف أدواته. ولا تتراجع أمام قطاع منكوب يكتفي بوصف نكبته.
“كيّة الصحافيين” ليست قدرا، بل جرس إنذار. إما أن نسمعه الآن ونحن قادرون على الفعل، أو سنسمعه لاحقا ونحن نكتب رثاء بضمير الغائب.