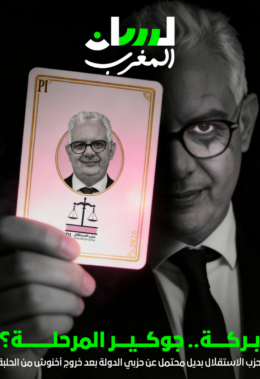الصحافة بين القانون والممارسة

بغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف مع مضمون ما يقوله حميد المهداوي، مدير موقع “بديل أنفو”، أو الأسلوب الذي يعتمده في متابعاته الإعلامية، فإن صدور حكم قضائي يساير قرار اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة بعدم أحقيته في الحصول على بطاقة الصحافة المهنية يثير موضوعا أساسيا يتجاوز حالة فردية، ويعيد إلى الواجهة إشكالية عميقة تتعلق بحدود التعريف القانوني للصحافي في المغرب، خاصة في ظل التحولات البنيوية التي يشهدها المجال الإعلامي بفعل الرقمنة، وانتشار المنصات البديلة، وبروز الصحافة الحرة والمبادرات الفردية.
لقد استند حكم المحكمة الإدارية الابتدائية بالرباط الصادر بتاريخ 22 ماي 2025 إلى تأويل حرفي لمقتضيات المادة الأولى من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، التي تشترط في الصحافي أن يزاول مهنته بصورة رئيسية ومنتظمة ومؤدى عنها في واحدة أو أكثر من النشرات أو الجرائد اليومية والدورية الصادرة بالمغرب أو في واحدة أو أكثر من وكالات الأنباء أو في واحدة أو أكثر من هيئات الإذاعة والتلفزة الموجود مقرها الرئيس في المغرب، معتبرا أن صاحب الدعوى لا يستجيب لهذه الشروط، بدعوى أنه لا يشتغل بموجب عقد مع منشأة صحافية مرخص لها حسب مقتضيات المادة المذكورة، ولم يدل بما يثبت تقاضيه أجرا منتظما يربطه بوضعية مهنية مستقرة داخل المؤسسة الناشرة.
واعتمدت المحكمة، في تعليلها، على ما ورد في شهادة الوضعية الجبائية القانونية المسلمة من طرف المديرية العامة للضرائب بتاريخ 10 دجنبر 2024، التي تشير إلى أن شركة “بديل ميديا”، التي تملك “موقع بديل أنفو”، تمارس أنشطة في مجال الاستشارة، وليس في مجال الصحافة، وهو نفس الموقف الذي انطلقت منه اللجنة المؤقتة لتسيير المجلس الوطني للصحافة لرفض تجديد البطاقة المهنية للصحافي المعني.
كما لاحظت المحكمة أن الشهادة التي أدلى بها الطاعن لإثبات الطابع الصحافي لنشاط الشركة جاءت لاحقة لتاريخ تقديمه طلب تجديد البطاقة المهنية، وبعد أن تم البت فيه ورفضه، حسب ما يستفاد من التاريخ المدرج (24 مارس 2025). أما بخصوص شهادات الأجر التي قدمها الطاعن، فقد رأت المحكمة أنها لا تثبت بشكل قاطع أن الأجر المتقاضى من طرف الشركة المذكورة يعد أجره الرئيسي.
في المقابل، تجاهلت جهة التقاضي حجية استمرارية حصول المعني بالأمر على بطاقة الصحافة المهنية طيلة الفترة الممتدة من 2012 إلى 2024، وواقع ممارسته للصحافة كاسم متداول في المشهد الإعلامي الوطني، وتأكيده أن شركة “بديل ميديا”، المصدرة لـ “بديل أنفو”، حددت في المادة 3 من قانونها الأساسي أنها تشتغل في مجال الصحافة الإلكترونية السمعية البصرية، إَضافة إلى أنشطة أخرى؛ كالإشهار والوساطة والخدمات والاستيراد والتصدير.
كما لم تعر اهتماما للدفوعات الأخرى التي قدمها الطاعن، المتعلقة بعيوب الإجراءات الشكلية التي اتبعت من طرف لجنة تسيير المجلس الوطني للصحافة أثناء مسار معالجة طلبه، واكتفت بالقول إن المسطرة تم احترامها، بدءا من تقديم الطلب عبر المنصة الإلكترونية وصولا إلى التوصل بالجواب. بل وذهبت في اتجاه اعتبار أن عدم احترام الإدارة للآجال القانونية لا يؤدي إلى بطلان القرار، بل يفضي، وفق القواعد العامة في القانون الإداري، إلى صدور قرار ضمني بالرفض.
وبهذا المنطق، الذي اعتمدته المحكمة الابتدائية الإدارية، والذي سايرته محكمة الاستئناف الإدارية لدى نظرها في نفس الموضوع بتاريخ 16 شتنبر الجاري، فقد تم حصر مفهوم الصحافي في من تتوفر فيه شروط شكلية تتعلق بالعلاقة التعاقدية والمؤسسية.
وبالتالي، فإن المعيار المعتمد يظل ماديا صرفا، يتمثل في الراتب والتعويضات المرتبطة بممارسة مهنية داخل مؤسسة إعلامية مرخصة، ويعكس منطقا تقنينيا صارما يعزل الصحافة عن جوهرها، المتمثل في نقل المعلومة ومساءلة السلطة وتأطير النقاش العام.
لكن مشكل هذا التوجه هو أنه لا يراعي الدينامية الجديدة التي يعرفها المجال الإعلامي، والتي باتت تشهد بروز “فاعلين مستقلين” لا يشتغلون ضمن القوالب التقليدية، لكنهم يمارسون عملا صحافيا فعليا من حيث التحقيق، والمساءلة، ونشر المعلومة بدقة وانتظام.
إنه يعكس تباينا متزايدا بين منطق القانون ومنطق التأثير الإعلامي، لا سيما في ظل بروز فئة متنامية من الفاعلين الإعلاميين الذين قد لا ينتمون بالضرورة إلى مؤسسات رسمية أو معترف بها إداريا، لكنهم ينقلون أخبارا ويؤثرون، بكيفية أو بأخرى، في جزء من الرأي العام، عبر منصات رقمية، متجاوزين أحيانا المؤسسات التقليدية.
ولذلك، لئن كان الأمر يتعلق بـ”صحافي رقمي” يزاول المهنة من حيث المضمون لا من حيث الشكل المؤسسي، فإن الإشكالية الحقيقية تكمن في النظرة الضيقة التي تبنتها السلطات الإدارية، ممثلة في اللجنة المؤقتة لتسيير المجلس الوطني للصحافة، وسايرها في ذلك القضاء الإداري، حيث تحصر مهنة الصحافة في إطار الأجير المرتبط بعقد عمل داخل مؤسسة إعلامية مرخصة، بينما الثورة الرقمية التي حررت ممارسة الصحافة فتحت آفاقا جديدة لمنابر مستقلة تسمح ببلوغ أوسع شرائح المجتمع وتحفيز وعي نقدي متجدد.
وبالتالي، فإن الاقتصار على المقاربة القانونية وحدها يعكس تصورا جامدا لمهنة شهدت تغيرات جوهرية في طبيعتها، خصوصا مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي التي أوجدت فضاءات إعلامية جديدة يمكن من خلالها إنتاج محتوى صحافي ميداني وتحليلي يتفوق أحيانا على ما تنتجه المؤسسات الرسمية.
صحيح أن هذه الدينامية الإعلامية تثير تساؤلات مشروعة حول مصداقية المعلومات المسوقة، وأخلاقيات المهنة، مما يدفع بعض الجهات إلى التشبث بمرجعية البطاقة المهنية كأداة ضبط وتنظيم؛ لكن ذلك لا يمكن أن يكون مبررا للتضييق على الأصوات الإعلامية المستقلة التي تسهم بفعالية في بناء صحافة بديلة، قائمة على القرب من المواطن، والجرأة في الطرح، والابتعاد عن القيود التحريرية الرسمية.
من هذه الزاوية، يبرز الحكم الصادر في قضية المهداوي الفجوة بين النص القانوني والممارسة الواقعية، وبين الرؤية المؤسسية الضيقة لمهنة الصحافة والواقع المتحول الذي يفرض إعادة تعريف المهنة من حيث الدور لا من حيث الوضعية القانونية.
فحرمان فاعل إعلامي ينتج محتوى إخباريا وتحليليا، اختلفنا أو افتقنا معه، ويتعرض أحيانا للمساءلة القانونية، فقط بسبب غيابه المفترض عن الأطر المؤسسية الرسمية، يعكس منطقا إقصائيا لا يعترف بتعقيد المشهد الإعلامي المعاصر. والمفارقة أن هذا الصحافي “غير المعترف به قانونيا” قد يكون أكثر ممارسة للإعلام، من حيث الإخبار والتحليل والحوار…إلخ، من صحافيين مهنيين يحملون البطاقة، وأكثر تأثيرا منهم.
وبالتالي، فإن قضية المهداوي تطرح تساؤلات جوهرية حول طبيعة الصفة الصحافية: هل تتحدد بالانتماء إلى مؤسسة معترف بها، أم بالممارسة الإعلامية الفعلية؟ وهل يكفي غياب الراتب الرئيسي أو العقد لإسقاط الصفة، حتى وإن توفرت أركان العمل الصحافي من حيث المحتوى، التأثير، والمسؤولية؟ وهي أسئلة لا تهم المغرب فقط، بل تعكس رهانات كونية حول إعادة تعريف المهنة في عصر الإعلام الرقمي والفاعلين الإعلاميين غير المعتادين.
عبر العالم، تتباين النماذج القانونية والثقافية في تعريف الصحافي، غير أن القاسم المشترك بينها يتمثل في الميل المتزايد نحو توسيع هذا التعريف ليشمل أشكالا جديدة من الممارسة الإعلامية.
ففي فرنسا، على سبيل المثال، وإن كان قانون 29 مارس 1935، المعروف باسم Loi Brachard، الذي دمج لاحقا ضمن المادة L7111-3 من قانون الشغل (Code du travail)، يربط الصفة الصحافية بممارسة مهنية رئيسية ومنتظمة داخل منشأة صحافية لقاء أجر، فإن الواقع شهد تطورا تدريجيا نحو الاعتراف بصيغ أخرى من الممارسة.
فقد بدأت بعض النقابات ومنظمات مهنية تقر بوجود صحافيين مستقلين ومدونين، ولو لم يرتبطوا بعقود عمل تقليدية، شريطة احترامهم لمعايير المهنة وأخلاقياتها.
وفي الولايات المتحدة، تعد حرية الصحافة مضمونة بموجب التعديل الأول للدستور، حيث لا يفرض أي تعريف رسمي أو بطاقة مهنية للتمتع بصفة الصحافي.
وقد اعتمدت المحاكم الأمريكية، في قضايا متعددة، مبدأ أن جوهر الصحافة يكمن في طبيعة العمل نفسه لا في الجهة التي تصدر عنه. وتعتبر قضية Glik v. Cunniffe لسنة 2011 مثالا دالا على هذا التوجه، حيث أقرت المحكمة الفيدرالية العليا بأن ممارسة التحقيق والنشر بانتظام ومسؤولية تؤهل الشخص لأن يعامل كصحافي، بغض النظر عن صفته الإدارية أو المؤسسية، وحتى ولو لم يكن مرتبطا بمؤسسة إعلامية معترف بها إداريا، مشددة على أن المحامي “سيمون غليك” لما قام بتصوير مشهد لتدخل الشرطة ضد أحد المواطنين في مكان عام بمدينة بوسطن لم يرتكب أي فعل يستوجب اعتقاله بتهمة تسجيل فيديو من دون إذن، لأن تسجيل الفيديو والصوت لأنشطة رجال الشرطة في الأماكن العامة ممارسة تندرج في إطار الحماية التي يضمنها التعديل الأول للدستور الأمريكي.
أما في ألمانيا، فيكفل الدستور حرية الإعلام، حيث تعطى البطاقة كأداة إثبات للعمل الصحافي المهني، وليست شرطا قانونيا لمزاولة المهنة. وبالتالي، لا توجد بطاقة مهنية إلزامية، بل يعترف لأي شخص بأن يمارس العمل الصحافي بصفة مستقلة ومنتظمة، حتى ولو لم يكن أجيرا رسميا، شريطة احترامه للمهنية والمصداقية.
وبالمثل، تعتمد التجربة البريطانية على منطق مرن، حيث تشرف هيئات مستقلة، مثل المجلس المستقل للصحافة في المملكة المتحدة (IPSO)، على ضبط الأداء المهني دون احتكار تحديد من هو الصحافي. وتترك للمحاكم مهمة تقييم مهنية الشخص واستقلاليته وجودة إنتاجه، وهو ما سمح بدمج الصحافيين الرقميين والمستقلين في المشهد الإعلامي الرسمي، شريطة احترامهم لأخلاقيات التحرير والمهنية.
توضح هذه التجارب الدولية أن الصحافة في عصرنا الحالي تحررت من القوالب التقليدية، وأن الاعتراف المهني لا ينبغي أن يقتصر على الانتماء المؤسسي أو على البطاقة المهنية، بل يجب أن يرتكز على الممارسة الفعلية، والتأثير المجتمعي، والمسؤولية الأخلاقية، والاستمرارية في الأداء المهني.
في ضوء ذلك، يمكن القول إن التعريف القانوني المعتمد في المغرب يعاني من قصور بنيوي، إذ لا يواكب التحولات الرقمية والمهنية التي يعيشها المجال الإعلامي. فقضية مثل هاته التي كانت موضوع الحكم القضائي المذكور تظهر بجلاء مفارقة جوهرية: كيف يمكن إنكار صفة الصحافي على شخص يتعرض للمساءلة أو التضييق بسبب محتوى إعلامي مهني، فقط لأنه لا يتقاضى راتبا من جهة معترف بها؟ وهل نقيم العمل الصحافي من حيث الجهة المانحة للأجر، أم من حيث مضمونه وأخلاقياته؟
إن اختزال الصحافة في شروط شكلية يعكس، في كثير من الأحيان، إرادة ضبط وتقييد لها وليس تنظيم مهني حقيقي يعترف بالتنوع والخصوصيات الجديدة. فحين ينتج شخص محتوى صحافيا ويخضع للمساءلة أو حتى التضييق بسببه، يصبح من المفارقة إنكار صفة الصحافي عنه لمجرد عدم تلقيه أجرا أو لغياب عقد عمل رسمي.
وتصبح هذه الحقيقة مثيرة عندما نعلم أن في خلفية هذه القضية، وقضايا أخرى، تطفو على السطح مفارقة قد تبدو مؤلمة تختزل عمق الأزمة البنيوية التي تعانيها مهنة الصحافة في المغرب، مفادها أنه ليست السلطة السياسية أو الأجهزة الأمنية هي فقط التي تضيق على حرية الصحافة، بل إن جزءا من المعاناة يأتي من داخل الحقل الصحافي نفسه، حيث يصبح الصحافي في موقع “الخصم” أو “القاضي” لزميله، لا لسبب سوى أن هذا الأخير يشتغل خارج إطار المؤسسات المعترف بها، أو لا يحمل بطاقة الصحافة التي تمنحها هيئة تضم بدورها صحافيين.
هنا يتجلى تناقض صارخ: من يقصي الصحافي ليس شرطيا أو قاضيا، كما يفترض عادة، بل صحافي آخر يمتلك امتياز السلطة الرمزية والمؤسسية لتعريف من هو “المهني” ومن هو “الدخيل”، مما يحول البطاقة المهنية من وسيلة للتنظيم إلى أداة للإقصاء.
وفي الحالة التي نتحدث عنها، لم يكن الصراع حول حرية التعبير فقط، بل أيضا حول من له الحق في ممارسة هذه الحرية بصفته صحافيا. لقد أصبح السؤال الجوهري لا يدور حول مضمون ما ينشر، بل حول “هوية” من ينشره: هل هو من داخل المنظومة أم من خارجها؟ وبذلك، تتحول المهنة إلى دائرة مغلقة يديرها من في الداخل ضد من في الخارج، في انسجام غير واع مع منطق السلطة، ولو من موقع خصومة ظاهرية معها.
من هنا، تبرز الحاجة الملحة في المغرب إلى إعادة النظر في الإطار القانوني والتعريف المهني للصحافة، بما يسمح باستيعاب الفاعلين الإعلاميين المستقلين الذين يمارسون الصحافة بمهنية ومسؤولية أخلاقية، خارج القوالب المؤسسية التقليدية.
لايتعلق الأمر بدعوة إلى الفوضى، ولا إلى فتح المجال أمام كل من هب ودب لممارسة هذه المهنة النبيلة، بل إلى الاعتراف بتطور المشهد الإعلامي وبتعدد أشكال الممارسة الصحافية، وضرورة مواكبة التشريع لهذه التحولات، دون الإمعان في “أسطرة” النموذج المؤسسي الضيق.
في الوقت الراهن، يوجد مشروع قانون رقم27.25 يتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين المعروض على أنظار البرلمان، بموازاة مشروع قانون آخر حول المجلس الوطني للصحافة، يروم إدخال تعديلات على القانون رقم 21.94 المعمول به حاليا.
لكن رغم ما يتضمنه هذا المشروع من مستجدات، خصوصا على مستوى التمييز بين “الصحافي المهني المحترف” و”الصحافي المهني الحر”، فإنه لا يعالج جوهر الإشكال المرتبط بتعريف الصحافي وتحديد من يمارس فعلا مهنة الصحافة.
فالتمييز المقترح، بدل أن يسهم في توسيع دائرة الاعتراف بالممارسة الصحافية خارج الأطر التقليدية، يستمر في تكريس مقاربة شكلية تعتمد على المعايير الإدارية والانتماء المؤسسي، دون أن تأخذ بعين الاعتبار التحولات العميقة التي تعرفها المهنة، لا سيما مع بروز الصحافي المستقل، والصحافة الرقمية، وممارسات النشر الجديدة التي باتت تتجاوز النموذج الكلاسيكي للصحافي “الموظف” أو “الأجير”.
وهكذا، يبقى الإشكال الأساسي مطروحا: هل يعرف الصحافي بوضعه التعاقدي داخل مؤسسة معترف بها، أم بممارسته المنتظمة للتحقيق والنشر وفقا للمعايير المهنية والأخلاقية للمهنة؟ وبالتالي فإن الإجابة عن هذا السؤال تظل غامضة في المشروع الحالي، بما يبقي الباب مفتوحا أمام التأويلات الضيقة، بل وأحيانا الإقصائية، في منح صفة “الصحافي المهني”.
هذا الوضع يفرض مراجعة شاملة لمفهوم الصحافي في التشريع المغربي، بما يتجاوز المقاربة القانونية الصرفة نحو تصور أكثر انفتاحا وواقعية. فالمطلوب ليس فقط تعديل النصوص، بل بناء ثقافة مؤسسية تعترف بتعدد أشكال الممارسة الصحافية، وتقدر الدور الذي تلعبه المنصات المستقلة والصحافيون غير التقليديين في تغذية النقاش العمومي.
وفي هذا الإطار، تبرز أهمية فتح نقاش عمومي حول ميثاق أخلاقي جامع يضم جميع العاملين في الميدان، يمكن أن يشكل مدخلا مهما لإعادة الثقة بين الجسم الصحافي والسلطات والمجتمع، ويضمن الاعتراف المستحق لكل من يخدم حرية التعبير والحق في المعلومة.
فالتجارب الدولية تعلمنا أن الصحافي ليس بالضرورة من يحمل بطاقة مهنية، بل من يمارس سلطة الكلمة بمهنية وشجاعة، والتزام بالحقيقة، ويقف في مواجهة السلطة بما يضمن الشفافية والمسؤولية.
لذلك، ففي زمن تتآكل فيه الحدود بين المواطن والصحافي، وبين المنبر المؤسسي والمنصة الشخصية، يصبح توسيع تعريف الصحافي ضرورة لا خيارا، لتأمين مستقبل حرية الصحافة ومصداقيتها واستقلالها.
دون مثل هذا التطور، سيظل القانون متخلفا عن واقع الممارسة الإعلامية، وستظل بطاقة الصحافة أداة إقصاء، بدل أن تكون وسيلة إدماج وتأطير تحفظ حرية الإعلام ومسؤولية الصحافيين، وتواكب التغيرات الاجتماعية والسياسية والتقنية التي يشهدها الحقل الإعلامي المعاصر.