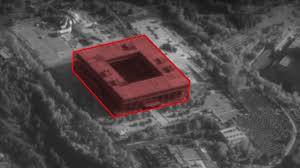طفولة مغصوبة

يقال إن من أراد أن يقرأ مستقبل أمة، فلينظر في عيون أطفالها، وفي خطواتهم الصغيرة وهم يجوبون أزقة مدنهم، وفي مدارسهم التي ينبغي أن تكون مصانع للأمل، لا معتقلات يومية.
عندنا الأطفال يموتون في بالوعات الصرف الصحي، والآبار المجهولة، ويحترقون أمام أعين الجماهير في شرفات بيوت مسيّجة بقضبان التخلّف والجهل، ويموتون ببطء في سراديب الجهل والفشل التي تسمى مدارس عمومية، وينتزعون من مدارسهم، كما هو الحال مع الطفلة ملاك، ليزجّ بهم في إجراءات تقييد الحريجة في قضايا جنائية قد لا يستدعي الأمر أكثر من شهادتهم فيها.
أمس كان علينا أن نمضي ليلة على وقع غصة طفلة جرفتها مياه أمطار صلّينا كثيرا من أجلها، وأغرقتها في بالوعة يفترض أنها مخصصة لمياه الصرف الصحي، لا لاحتضان جسد بريء والسفر به داخل قنوات نتنة لما يربو عن أربعة كيلومترات قبل أن يلقي بها السيل في أحد الأودية.
من أراد أن يقرأ مستقبل بلاد فلينظر كيف يعبر أطفالها الشوارع، وكيف يلعبون في الحدائق، إن وُجدت، وكيف يستنشقون الهواء إن لم يكن ملوثا باللامبالاة.
مستقبل الأمم ليس شعارات جوفاء ولا خطط تُكتب على الورق، بل هو طفل آمن في طريقه إلى المدرسة، غير مهدد بسقوط مفاجئ في بالوعة مهملة، أو بجدار آيل للسقوط، أو بسيارة بلا كوابح يقودها من لا يخشى القانون.
حين ترى الأطفال يعيشون مطمئنين، فاعلم أن هناك دولة حقيقية تحميهم، وإن وجدتهم يختفون في زوايا النسيان، يموتون في تفاصيل الإهمال، ويكبرون قبل الأوان في قسوة الظروف، فاعلم أن المستقبل نفسه يلفظ أنفاسه الأخيرة، كما يلفظها هؤلاء الصغار الذين لم ينصفهم وطنهم.
وما وقع ليلة أمس في بركان ليس مجرد حادث، والطفلة الضحية ليست مجرد اسم آخر ينضم إلى قائمة طويلة من الضحايا الذين سقطوا في فخ لامبالاة تقتل بلا ضجيج.
بالأمس، لفظت طفلة أنفاسها الأخيرة في بالوعة بمدينة بركان، كأن الأرض لم تعد قادرة على حمل أبنائها إلا لتبتلعهم، وكأن المدن في هذا البلد لم تعد فضاءات للعيش بل مصائد للموت، مصائد تُترك مفتوحة، بلا غطاء، بلا اكتراث، بلا أي إحساس بأن حياة الناس تستحق الحد الأدنى من العناية.
كيف لمدينة في بلاد تدّعي الحداثة أن تعجز عن تأمين الشوارع التي يسير فيها أطفالها؟ كيف لمنظومة كاملة، من مجالس منتخبة إلى إدارات تقنية، أن تغض الطرف عن هذه الفخاخ القاتلة التي تملأ الشوارع والأزقة؟
ليست هذه أول مرة، ولن تكون الأخيرة، ما دامت المسؤولية هنا تتبخر كما تتبخر مياه السدود، وما دام الإهمال سياسة، واللامبالاة قانون غير مكتوب يسري على الجميع.
هذا ليس مجرد حادث عرضي، بل هو مرآة للطريقة التي يُدار بها الفضاء العمومي في المغرب. مدن تُسلَّم للمضاربين العقاريين، شوارع تُحفر بلا عودة، أزقة تُركب فيها مصائد قاتلة، وبنية تحتية تُنجز بمنطق “سدّ الخصاص”، لا بمنطق حماية أرواح الناس.
قادني سفر حديث إلى عبور مدينة بركان من شرقها إلى غربها، وصادف ذلك تساقط أمطار متوسطة الغزارة، ولاحظت يومها كيف أن الشوارع تحوّلت إلى سيول قوية تكاد تهدّد سلامة بعض السيارات الخفيفة.
اعتقدت أن في الأمر معطى استثنائيا ما، لأن مدينة حديثة معاصرة لا يمكن أن تكون بهذه الهشاشة.
الآن فمهنا أن الأرواح عندنا تُحسب بأقل من كلفة غطاء حديدي لبالوعة. وبعد أن يُوارى جسد الطفلة تحت التراب، سيعود الجميع إلى أعمالهم وكأن شيئاً لم يكن، وكأن الحياة والموت في هذا البلد مجرد احتمالين متساويين عندما تخرج إلى الشارع.
أستغرب لبعض المتطفّلين الذين سارعوا إلى مهاجمة من عبّروا عن غضبهم للحادث المأساوي. هؤلاء يستكثرون علينا حتى الحق في الغضب. هؤلاء يريدون تحويل نقد تدبير مدينة إلى طابو لأن اسمها مرتبط بشخصية يصرّ البعض على جعلها رمزا لنشاط رياضي مقدّس، وتظاهرات قارية ودولية موعودة.
للإنصاف فإن الأمر لا يعني مدينة بركان وحدها، بل يهمّ جلّ مدننا ودواويرنا. المدن التي يُفترض أن تكون فضاءات للعيش تحوّلت عندنا إلى حقول ألغام، حيث المشي مغامرة، وركوب الدراجة مقامرة، وعبور الشارع فعل تحدّ يومي.
لا شيء في شوارعنا مصمم ليحمي مستعملي الطريق، كأن من خطط لهذه الفوضى لم يسبق له أن سار على قدميه، أو قاد دراجة وسط زحام المدينة، أو جرّب أن يعبر ممر الراجلين دون أن يفاجئه سائق يعتبر الضوء الأحمر مجرد إشارة ديكور.
أينما وليت وجهك، تجد الأرصفة المحتلة، إن وُجدت أصلا، والحفر والمنحدرات والفوضى التي تجعل من الطريق مصيدة للفئات الهشة، من راجلين وراكبي دراجات هوائية وكهربائية، كأن وجودهم خطأ في معادلة المدينة التي لم تُبن لهم.
في زيارة قادتني الصيف الماضي إلى العاصمة الأندونيسية جاكرتا، فاجأني شكل تنظيم وتهيئة المدن والشوارع ليستوعب جميع الفئات.
وكم أعجبتني طريقة تصميم الطرق لتستوعب العدد الكبير من الدراجات بنوعيها النارية والعادية.
ممرات مخصصة حصريا لهم، وبضع أمتار الأولى قبيل إشارات المرور الضوئية تتوقف فيها الدراجات بينما تصطفّ السيارات خلفها، حتى إذا صدرت إشارة الضوء الأخضر انطلقت الدراجات آمنة ثم تبعتها السيارات.
عندنا لا شيء يدلّ على أننا نصمّ الفضاء العمومي من أجلنا جميعا. لا شيء يحمي مستعملي الدراجات، وطرقنا تصمّم كأنها لم تخترع بعد، علما أن أولى الدراجات ولجت بلادنا متم القرن التاسع عشر.
اليوم تأتي الدراجات الكهربائية لتلتحق بقائمة أسباب الموت، لا وسائل النقل الحديثة. لا ممرات محمية، ولا مسالك آمنة، ولا أدنى اعتبار لمن لا يملكون سيارة مصفحة تعزلهم عن فوضى التهيئة العشوائية.
هنا، الطريق لا تنتمي للجميع، بل لمن يستطيع أن يفرض هيمنته عليها، سواء كان سائقا بلا ضمير، أو إدارة بلا رؤية، أو مقاولة أنجزت المشروع ثم تركته غير مكتمل، بلا تخطيط، بلا مراقبة، بلا محاسبة.
في مدن كهذه، لا أحد ينجو، لكن وحدهم المستضعفون يدفعون الثمن.
من أراد أن يستطلع مستقبلنا فلينظر في عيون أطفالنا، حتى إذا بدت له حوادث الغرق والحرق والاختناق مجرّد متفرّقات وحوادث معزولة، فلينظر إلى حال مدرستنا، ولا يعتمد في ذلك سوى المعطيات والتصريحات الرسمية.
عادة نقول عن الطفولة المهملة إنها “طفولة مغتصبة”، والحقيقة أننا أمام طفولة مغصوبة ومسلوبة الحق قبل أن تنضج المطالب..
طفولة مقهورة قبل أن تتشكل لديها القدرة على المقاومة، ومجبرة على أن تكبر قبل الأوان؛ لأن هذا الوطن، حين يغفل عن صغاره، فإنه لا يترك لهم سوى أن يتدبروا أمرهم وحدهم، أو أن يسقطوا، حرفيا، في هاوية الإهمال.