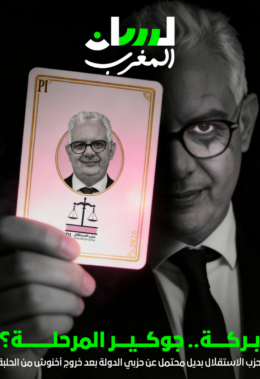شططٌ تشريعي.. ولا “هانس كلسن” له

جاء مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 المتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 الخاص بمجلس النواب بمواد مثيرة للجدل، من أبرزها ما ورد في إحدى فقرات المادة 51 المكررة، التي تنص على ما يلي: يُعاقَب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من قام أو ساهم أو شارك، بأي وسيلة، بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو أي منصة إلكترونية أو تطبيق على الأنترنيت أو الأنظمة المعلوماتية، بنشر أو إذاعة أو نقل أو بث أو توزيع إشاعات أو أخبار زائفة بقصد التشكيك في صدقية ونزاهة الانتخابات.
بهذا النص، قد يصبح أيّ تعليق أو تدوينة تنتقد أداء الجهة المشرفة على الانتخابات أو تسائل دقة الأرقام الرسمية، سواء تعلّقت بنسبة المشاركة أو بنتائج الصناديق أو بحياد الإدارة أو برواج المال الانتخابي، جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدة قد تصل إلى خمس سنوات. وهي عقوبة تعادل في شدّتها العقوبات المقرّرة لجرائم عنيفة، مثل “الاعتداء على شخص باستعمال سلاح نتج عنه عجز تتجاوز مدته عشرين يوماً”، وهي الحالة التي يحدّد الفصل 401 من القانون الجنائي المغربي عقوبتها بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات.
قد تُعامَل إذن تدوينة سلمية على شبكة اجتماعية تعبّر عن رأي نقدي بشأن العملية الانتخابية معاملةَ من حمل سلاحًا واعتدى به على إنسان، في مفارقة تثير تساؤلات عميقة حول خلفيات من صاغ هذا النص وأهدافه.
سيُحال القانون وجوبًا إلى المحكمة الدستورية بعد موافقة البرلمان عليه، باعتباره قانونا تنظيميا يخضع للمراقبة الدستورية القبلية. ولا أدري أيّ محكمة دستورية يمكن أن تجيز هذه المادة، إذ تطرح إشكالا جوهريا يمسّ فكرة الدستور ذاتها، إذ ترهب وتمنع المواطنين من مجرد التشكيك في أداء السلطة التنفيذية.
إنّ فكرة الدستور تقوم، في أصلها، على قاعدة التشكيك في الحكام، لا التسليم التام لهم. لأنها تعتبر أن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة، والحكم إذا ترك دون رقابة أو نقدٍ فسدَ وأفسد.
فالدستور، قبل أن يكون قيدا على المحكومين، فهو بالأساس قيد على الحكام. ذلك أن المحكومين ملزمين بالامتثال للقانون -بوجود دستور أو بدونه- بحكم ما تملكه السلطة من وسائل إكراه. أما الحكام، فهم الذين يمتلكون هذه الوسائل، ولا توجد جهة تنفيذية تعلو عليهم تُلزمهم باحترام القانون.
وهذا ما تنبّه إليه مناهضو الاستبداد ومؤسّسو الفكر الدستوري الحديث حين قرّروا مبدأ فصل السلط، إدراكا منهم أن السلطة لا يحدّها إلا سلطة مثلها، فأنشؤوا مؤسسات متوازنة تراقب بعضها بعضا، وجعلوا في قمة هذا البناء المحكمة الدستورية، التي مُنحت صلاحيات وامتيازات تضمن استقلال أعضائها، لتكون سدًّا منيعًا أمام أي طيش تشريعي أو تجاوز للسلطة.
وهنا يبرز اسم “هانس كلسن”، الفقيه الدستوري الذي أسّس في النمسا سنة 1920 أول محكمة دستورية في التاريخ الحديث، واضعًا حجر الأساس لفكرة أن الدستور ليس زينة قانونية، بل سلاح المواطن في وجه السلطة. آمن “كلسن” بأن القانون يفقد معناه إذا صار أداة بيد الحاكم بدل أن يكون قيدًا عليه، وأن وظيفة القضاء الدستوري هي أن يُذكّر السلطة دومًا بأنها خاضعة للدستور لا مالكة له.
ومن جوهر هذا البناء، جاءت حرية الرأي والتعبير والنقد باعتبارها الوسيلة المدنية الأولى لحماية الدستور ومراقبة الحكّام، لا جريمةً تستوجب العقاب.
جعل منظّرو “دولة القانون” الدستورَ أساس المشروعية في الدولة، بحيث إنّ أي سلطة تخرج عن أحكامه تفقد مشروعيتها وتخرج من اعتبار المواطنين الأخلاقي والسياسي، ويصبح من المشروع عندها مقاومتها بوصفها سلطة معتدية على الإرادة العامة. وهنا تكمن قوة الدستور الحقيقية.
فحماية الدستور، في النهاية، ليست وظيفة الحكام بقدر ما هي وظيفة المحكومين، لأنهم المستفيد الأول من وجوده، إذ وُضع الدستور أساسًا لضمان حقوقهم في مواجهة الحكام. فالحُكم بطبيعته متفلت من القيود، فإذا لم يجد أمامه مواطنًا قويًّا يقظًا امتدّ وتغوّل. ووسيلة المواطن الأجدى في ذلك هي الكلمة الحرة. فمَن يجرّد المواطن من حقه في النقد يضعف آخر حصن للدستور.
وفق البلاغات الرسمية، فقد تم إعداد هذا المشروع من طرف وزير الداخلية بأمر ملكي وردَ في خطاب العرش، والذي أُريد له أن يكون ورشا منفتحا على الأحزاب السياسية. وقد تم اطلاع المجلس الحكومي عليه والتداول بشأنه، ثم أُعيد التداول والمصادقة عليه في المجلس الوزاري. وهذا يعني أن النص جاء من مسار يُفترض أن لا سهو فيه ولا خطأ، وأنه يعبّر عن حقيقة المواقف والتوجهات الرسمية، فكيف جاء يحمل هذه المادة الغريبة المنسِفة لكل وعود الانفتاح والشفافية؟
ستظل محطة المحكمة الدستورية -بعد أن يتجاوز المشروع البرلمانَ بسلام- آخر فرصة لاستدراك هذا الشطط التشريعي، فهل تستطيع المحكمة أن تواجه هذا المسار وتعلن عدم مطابقة المادة للمبادئ الدستورية العامة؟ أرجو ذلك.
لو استدعينا “هانس كلسن” وعرضنا عليه هذه المادة، لتوقعنا رده كالتالي: “في دولة دستورية، لا تُقاس نزاهة وصدقية السلطة التنفيذية بقدرتها على فرض الصمت على المواطنين وروّاد مواقع التواصل الاجتماعي، بل بقدرتها على أن تسكت شكوكهم بإنجازاتها وصدق أدائها. فحرية التعبير ليست خطرا على نزاهة الانتخابات، بل تأكيدٌ لها، إذ إنّ النزيه لا يخشى النقد. والصدقية لا تُرسّخ بالعقوبات، بل تُبنى بالثقة والشفافية والمساءلة”.