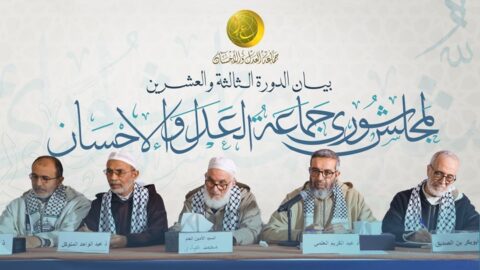“شابات من أجل الديمقراطية” تدافعن عن إثبات النسب بالخبرة الجينية

نظمت مجموعة “نساء شابات من أجل الديمقراطية” ندوة فكرية، يوم الجمعة 23 ماي 2025، بمدينة المحمدية، تحت عنوان: “إشكالية النسب في مدونة الأسرة – نحو قراءة جديدة للنصوص الدينية والقانونية”، حيث شهد النقاش مشاركة نخبة من الباحثات والفاعلين المدنيين، واستحضر شهادات حية من الميدان، كما لامس قضية النسب، وما يطرحه من “تمييز بين الأطفال، ومن هشاشة قانونية واجتماعية تحاصر الأمهات العازبات”.
وتهدف هذه الندوة حسب منظميها، إلى “خلق فضاء للحوار النقدي والتفكير الجماعي، من خلال مساءلة التصورات السائدة، والانفتاح على مقاربات بديلة، تستثمر أدوات الفكر المقاصدي، والسوسيولوجيا النقدية، والفلسفة السياسية، والتحليل القانوني، إضافة إلى استحضار صوت الفاعلين الميدانيين وتجارب النساء على الأرض”.
في هذا السياق، قدمت الناشطة الحقوقية والاجتماعية كريمة نادر شهادة ميدانية مؤثرة حول معاناة الأمهات العازبات، مشيرة إلى أن ‘الإقصاء يتجلى في كل مستويات الحياة: من الاقتصاد إلى المشاركة السياسية، وصولاً إلى التفاعل الاجتماعي”.
وقالت نادر في تصريح لصحيفة “صوت المغرب” على هامش الندوة إن الواقع يعكس “مفارقة أخلاقية صارخة لمجتمع يصف نفسه بالمحافظ، بينما يمارس وصما جماعيا ضد نساء وأطفال لا ذنب لهم سوى أنهم وُلدوا خارج مؤسسة الزواج”.
وأضافت نادر أن الأرقام الرسمية تٌغفل “معاناة واقعية مهولة”، كما رفضت “الاستمرار في تبرير هذا الوضع بمقولات أخلاقية جاهزة”، داعية إلى التفكير في حلول جماعية تراعي كرامة الإنسان، وكذا إلى وقف استخدام الأخلاق كأداة للتمييز.
“ردّ فعل بعد الصدمة“
بدورها شددت هدى السحلي، عن الهيئة المنظمة، على أن اختيار موضوع النسب لم يكن اعتباطيا، بل جاء “كرد فعل على الصدمة التي أحدثها تجاهل المذكرة المرجعية لتعديل مدونة الأسرة لمطلب إقرار الخبرة الجينية”.
وقالت السحلي في حديثها لـ”صوت المغرب”: “ارتأينا أن نفتح نقاشا يتجاوز المقاربات القانونية الباردة إلى مساءلة المرجعيات المؤسسة للتشريع، بما فيها الفقه والسوسيولوجيا والفلسفة، انطلاقاً من الواقع ومن تجارب حية استعرضها الفاعلون من قلب الميدان”.
وأكدت المتحدثة نفسها أن الهدف من الندوة ليس تقديم أجوبة جاهزة، بل “فتح مساحة للتفكير الجماعي تُتوّج بكتيب وحملة رقمية، ضمن دينامية ترافعية واسعة قبيل صدور النص النهائي لمدونة الأسرة”، مضيفة أن “معالجة إشكالية النسب لا يمكن أن تتم إلا عبر مقاربة شاملة تتداخل فيها الأبعاد القانونية، الاجتماعية، الثقافية والحقوقية”.
كما أعلنت هدى السحلي باسم “نساء شابات من أجل الديمقراطية” العزم على مواصلة الترافع من خلال إصدار كتيب يوثق النقاشات والمقترحات، إلى جانب إطلاق حملة رقمية، والتحالف مع جمعيات المجتمع المدني الفاعلة، من أجل “التأثير على الصيغة النهائية لمدونة الأسرة المرتقبة”.
“قاعدة وليس استثناء“
من جانبها اعتبرت المنسقة الوطنية لمجموعة “شابات من أجل الديمقراطية”، مريم هواد، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، أن مسألة إثبات النسب “ليست فقط قضية قانونية أو فقهية، بل بنية ثقافية مترسخة تنظر إلى جسد المرأة باعتباره موضوعاً للتأديب الاجتماعي، فيما يُعفى الرجل من المساءلة”.
وقالت هواد إن “النسب قضية ذكورية بامتياز، لأن جسد المرأة يتحول إلى ساحة عمومية للنقاش، بينما يظل الرجل في مأمن من المساءلة الاجتماعية والقانونية”.
وأكدت المتحدثة “أن آلاف الأطفال يُحرمون من حقهم في النسب فقط لأن القانون لا يعترف بالزواج غير الموثق أو بزواج القاصرات”، مشيرة إلى أن “اعتماد الخبرة الجينية يجب أن يكون قاعدة وليس استثناء”.
ودعت هواد إلى إتاحة اختبارات الحمض النووي مجانا أو بأسعار رمزية، “لأنه حق وليس امتياز”، مضيفة أن حرمان الطفل من نسبه يعني” حرمانه من كرامته”.
المنظور السوسيولوجي والقانوني
بدورها خديجة براضي، أستاذة باحثة في سوسيولوجيا الإعلام والنوع الاجتماعي بجامعة ابن طفيل، ألقت مداخلة تمحورت حول التحولات الجذرية التي يعرفها النموذج الأسري بالمغرب، والتي “باتت تتحدى التصورات التقليدية حول الأسرة والنسب”.
وأبرزت براضي أن “الأنماط الجديدة للتعايش الأسري – كالأسرة ذات الوالد الواحد، أو تلك التي تضم أطفالا خارج مؤسسة الزواج – ليست مجرد ظواهر هامشية، بل تعبيرات اجتماعية قائمة تستوجب الاعتراف والتأطير القانوني”.
كما نبهت براضي إلى خطورة الحديث عن هذه التحولات دون معطيات علمية دقيقة، مشيرة إلى “غياب شبه تام للأبحاث الوطنية الأكاديمية أو المؤسساتية في هذا المجال”، باستثناء ما تقدمه بعض الجمعيات كجمعية “إنصاف” أو “100٪ أمهات” من دراسات جزئية “رغم محدودية نطاقها”.
وأوضحت الباحثة أن هذه “الهوة المعرفية” تجعل من الصعب اعتماد سياسات عمومية أو نصوص تشريعية مواكبة، داعية إلى ربط البحث السوسيولوجي بالتشريع، وإلى تزاوج المقاربة السوسيولوجية مع المعرفة القانونية، ودمج العلوم النفسية والسياسية في قراءة الظواهر الأسرية الجديدة، لتحقيق عدالة منصفة وغير تمييزية”.
التزامات دولية
وربطت نبيلة جلال، ممثلة فدرالية رابطة حقوق النساء، في مداخلتها بين إشكالية النسب والتزامات المغرب الدولية، خصوصاً اتفاقية حقوق الطفل التي تنص في مادتها السابعة على الحق في النسب دون قيد أو شرط. وقالت: “إذا كنا فعلا نحترم سمو الاتفاقيات الدولية، فإن النسب حق دستوري وإنساني يعلو على أي تأويل تقليدي”، مضيفة أن استمرار هذا التردد من المسؤولين “يعكس تردياً تشريعياً لا يليق بدولة تحاول تحديث منظومتها القانونية”.
“القانون أصبح عائقا“
وفي سياق النقاشات التي شهدتها الندوة، قدّم عبد العزيز الدراز، فاعل جمعوي مختص في قضاء الأسرة، مداخلة ركز فيها على الإشكالات المرتبطة بإثبات النسب ضمن مدونة الأسرة الحالية.
وعبّر الدراز عن قلقه من “تضييق المشرّع لنطاق النسب إلى درجة تستثني الأطفال المتخلى عنهم ومجهولي النسب”، معتبراً أن النصوص القانونية القائمة “لم تعد فقط غير مواكبة للواقع، بل باتت تشكل عائقاً أمام الاعتراف بالنسب البيولوجي”.
وسجّل الدراز أن استمرار رفض اعتماد الخبرة الجينية بحجة تعارضها مع الشرع، هو في حقيقته نوع من “التماهي مع أعراف فقهية تحتاج إلى إعادة نظر، وليس مع النصوص الدينية نفسها” على حد قوله.
وأشار إلى أن ما يُعرف بـ”حكم طنجة” الذي رفض فيه القضاء اعتماد تحليل الحمض النووي رغم مطابقته العلمية، يمثل سابقة خطيرة وصادمة. “ففي هذا الحكم، اعتُبر الطفل المولود خارج مؤسسة الزواج أجنبيا عن والده البيولوجي، وهو ما نفى أي علاقة نسب أو آثار قانونية بينهما”.
وانتقد الدراز اشتراط الإعلان الرسمي والاحتفالات لإثبات الزواج والخطبة في سياق قضايا النسب، مبرزاً أن “هذا الشرط يوصد الباب أمام كثير من الحالات الواقعية التي تكون فيها العلاقة موثقة عرفياً أو تتم في سياق اجتماعي غير تقليدي”. وأكد أن هذا التوجه “يُضيّق على الأمهات والأطفال معاً”، داعياً إلى “مراجعة هذه المقتضيات بروح منفتحة تراعي التحولات المجتمعية، والحقوق الدستورية والإنسانية للطفل”.
*كنزة احسيني الخضير