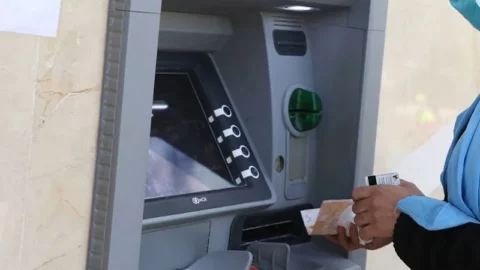ساعة في الجحيم

تماما كما كان الحال مع أختها البكر ياسمين، لم تكفّ ابنتي الصغرى، دينا، طوال أسابيع، عن طرح السؤال نفسه بصيغة طفل يلتقط الحقيقة بلا مقدمات: لماذا نخرج نحو المدرسة والنهار لم يستيقظ بعد؟كان سؤالها يخرج كل صباح من فم لم يتعلّم بعد مفردات السياسة العمومية ولا بلاغات الحكومة ولا هندسة التوقيت “القانوني”؛ لكنه يعرف، بالحدس الفطري الذي لا يخطئ كثيرا، أن هناك خطأ ما يحدث حين يُطلب من الجسد أن يبدأ يومه قبل الضوء، وأن يتظاهر باليقظة بينما العالم ما يزال في نصفه الليلي.
وأنا أستعيد عنوانين قديمين كتبتُهما في مثل هذه المناسبة التي نعود فيها إلى “الساعة القانونية” قبيل رمضان، الأول يقول “الساعة لله” والثاني هو “ساعة الشؤم”؛ كنتُ أظن أن الزمن، على الأقل، لا يكرر نفسه بهذا القدر من السخرية.
لكننا نعود هذا العام أيضا إلى النقطة ذاتها، مع فارق واحد، هو أن الغضب أصبح أكبر، لأن المبررات صارت أضعف، والاعتراض صار أوضح، واليقين صار أوسع بأن هذه الساعة ليست إجراء تقنيا بسيطا، بل قرارا يمسّ حياة الناس في أكثر لحظاتها هشاشة: الصباح.
في الطريق إلى المدرسة، يتبدى الأمر كما لو أن الدولة تضعنا يوميا في اختبار طاعة صغير. اقبلوا أن تقودوا أبناءكم في الظلام، واقبلوا أن يبدأ العمل حين تكون الطبيعة في غير مزاجها، واقبلوا أن تُقاس الإنتاجية بساعة مسروقة من النوم لا بقدرة المؤسسات على التنظيم، واقبلوا أن تكيّفوا أجسادكم على قرار لا يُقدَّم لكم عنه، كل سنة، حتى الحد الأدنى من الشرح، ولا الحد الأقصى من الثقة المطلوبة من طرف واحد.
حين أُقرت هذه الساعة، قيل لنا، بأكثر من صيغة، إنها مرتبطة بالطاقة. وسمعتُ شخصيا، ذات لحظة، من مسؤول كبير، تلك العبارة التي تُقال عادة كأنها تُغلق النقاش: “الخصاص الطاقي”.
كانت الحجة تبدو قابلة للتصديق على الورق، لأن الطاقة كلمة ثقيلة، ولأن الدولة تعرف كيف توظف الكلمات الثقيلة لتبرير القرارات الخفيفة على الناس والثقيلة عليهم.
لكن وبعد سنوات، أين هو التقييم العمومي المحيّن الذي يقول للمغاربة، بالأرقام والقياس والمنهج، إن هذه الساعة خففت فعلا العبء الطاقي؟ لا شيء يوازي استمرار القرار إلا استمرار الغموض.
القاعدة البسيطة تقول إن القرارات التي تُفرض باسم المصلحة العامة لا يجوز أن تُترك بلا محاسبة تجيب عن أسئلة بديهية: أين أثرها؟ أين تقريرها؟ أين قياسها؟
الأكثر إرباكا أن النقاش الدولي نفسه صار ينسف آخر ما تبقى من السند النفسي لهذه الحجة. في أوروبا، حيث كانت الطاقة أحد أعمدة فكرة التوقيت الصيفي تاريخيا، عاد قادة سياسيون ليقولوا علنا إن التوفير المسجّل لم يعد مقنعا، وإن المسألة ترتبط أيضا بصحة الناس وإيقاعهم البيولوجي.
وفي هذا السياق، خرج رئيس الحكومة الإسبانية قبل أشهر ليعلن أنه سيدفع داخل مؤسسات الاتحاد الأوربي نحو إنهاء تغيير الساعة، في رسالة مفادها أن ما كان يُقدَّم كحلّ اقتصادي صار يُنظر إليه كعبء اجتماعي.
إذا كانت دولٌ تملك أدوات القرار والقياس والنقاش، تعود لتسائل هذه الممارسة وتفكك حججها، فكيف تُدار عندنا الساعة الإضافية وكأنها قدرٌ منزَّل؟ وكيف يستمر العمل بها رغم أنها من الأمور القليلة التي يكاد يتشكل حولها إجماع شعبي على رفضها ومقتها؟
لا نحتاج استطلاعا كي نعرف ذلك. يكفي أن تراقب وجوه الناس في الصباح، وأن تسمع تذمر الآباء والأمهات أمام المدارس، وأن تلتقط الانقباض الذي يصير عادة جماعية حين يُطلب من بلد كامل أن يبدأ يومه ضد ايقاع الضوء الطبيعي.
حتى في أمريكا، لم يعد النقاش انطباعات مبعثرة. وخلال السنة الماضية، عادت دراسات أكاديمية إلى واجهة الإعلام لتقول إن اختيار التوقيت ليس تفصيلا، بل قرار صحة عامة.
واحدة من هذه الدراسات، التي قام بها باحثون في جامعة ستانفورد، حاولت تقدير العبء الصحي لسياسات التوقيت المختلفة، وخلصت إلى أن التوقيت المعياري الدائم، دون توقيت صيفي ولا تبديل الساعة، أقرب إلى مصلحة الإنسان من منظور الساعة البيولوجية. وأن إلغاء التبديل قد يرتبط بانخفاضات صغيرة لكن ملموسة في بعض المخاطر الصحية.
وإلى جانب هذا المسار، ما تزال أبحاث أخرى تربط الانتقال الربيعي، حين تُقدَّم الساعة، بفقدان ساعة نوم واضطراب قصير المدى في الإيقاع اليومي، مع مؤشرات عن زيادات مؤقتة في بعض المخاطر مثل حوادث السير وبعض أمراض القلب والسكتة الدماغية في الأيام التالية مباشرة.
فإذا كان العالم الذي قيل لنا إننا نقترب منه بهذه الساعة، يعيد طرح المسألة بوصفها عبئا على الجسد، فما الذي يبقى من مبرراتنا نحن؟
إنها ساعة تُضاف على الورق وتُقتطع من النوم، وتتحول إلى ضريبة يومية تُدفع بالنعاس، وبالمزاج، وبالتوتر، وبسلامة الطريق، وبقدرة طفل صغير على أن يصدق أن المدرسة امتداد للحياة لا قطيعة معها.
حين تقول “دينا” إن النهار لم يستيقظ بعد، فهي لا تهاجم ساعة “غير قانونية” فقط. هي تشير، دون أن تدري، إلى فجوة بين القرار وحياة الناس، وإلى نظام يطلب منك أن تُعدل جسدك كي يظل القرار ثابتا، بدل أن يُعدل القرار كي يظل الجسد سليما.
قد يقول قائل إن الأمر تفصيل. لكنه قرار يرافقك كل يوم، ويصوغ أعصاب الصباح، ويعيد ترتيب النوم، ويحوّل الطريق إلى المدرسة إلى مسار في العتمة، ويجعل بداية اليوم معركة صامتة على اليقظة.
لهذا أكتب اليوم مجددا، بعدما كتبت العام الماضي والعام الذي قبله، لأقول إن هذه الساعة الإضافية لم تعد قرارا يمكن التعايش معه على مضض؛ بل صارت رمزا لطريقة اتخاذ القرار حين تُختزل حياة الناس في هامش ورقة، ويُطلب منهم أن يصدقوا أن ما يؤلمهم “مصلحة عامة”.
نريد أن تنتهي هذه الساعة. لا لأننا نكره الطاقة، بل لأننا نحبّ البديهة، ونحبّ أن يبدأ اليوم مع الضوء، لا ضده.
نريد أن تُدار الدولة بمنطق يزن أثر قراراته على الأجساد كما يزن أثرها على الجداول.
ونريد أن يكون الإجماع الشعبي قيمة لا ضجيجا، وألا يتحول وطنٌ كامل، كل صباح، إلى دقيقة صمت طويلة وسط ساعة في الجحيم.