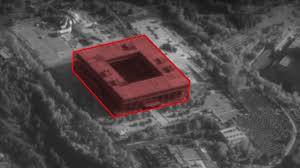جايحة الهندية

من كان يعتقد قبل بضع سنوات، أننا ونحن “بلاد الخير” التي لم تعدم يوما غذاء ولا شرابا منذ عقود طويلة، رغم الجوائح والنكبات… ومنا من جعل من جعل السخرية من بطاطس وموز الجيران خطا تحريريا ومنهجا في بناء الموقف، سنصبح، كما هو الحال اليوم، نضرب ألف حساب قبل أن نمدّ أيدينا نحو حبات الخضر والفواكه؟
بعد مصيبتنا الأولى التي ضربت تشكيلتنا من الخضر، وجعلت “طاجين” الفقراء يصبح ضربا من الخيال، ها هي اليوم أصناف الفواكه تلتحق بهذا ال”ترند”، و”تبيع شبابها غالي” لبسطاء المغرب.
أعتقد وبدون مبالغة، أنه الصيف الأول على الإطلاق الذي يحلّ علينا دون أن تكون موائدنا مزيّنة بالفواكه مختلفة الألوان والأشكال. بل ها هو حتى “الكرموس الهندي” يحلّق عاليا في سماء الأسعار ويصبح سعر الحبّة الواحدة منه بثمن الصندوق قبل عقدين أو أقل.
لقد كانت هذه الفاكهة رخيصة للغاية، لدرجة أن كثيرا من المغاربة كانوا يجعلونها فطورهم اليومي. يقضمون حباتها الحلوة وهم في الطريق إلى العمل، فيشبعون ويحققون اكتفاء ذاتيا من حاجياتهم الغذائية الأساسية، مقابل دريهمات، وأحيانا سنتيمات…
نعم، كان سعر الحبة الواحدة يقل في كثير من الأحيان عن “ريال” واحد، أي أقل من خمس سنتيمات. وها هي “كرموس النصارى” أو “الهندية” أو “الزعبول”… تزاحم منتجات كانت إلى وقت قريب تحتكر الواجهات الزجاجية للمحلات التجارية الراقية.
يربط الكثيرون بين هذا الارتفاق الكبير في أسعار مواد غذائية أساسية، ومخطط تنمية وتطوير الفلاحة المعروف باسم “المغرض الأخضر”. وهو بالفعل مسؤول عموما عن كل ما حصل من تغيير نحو الانتكاس، في حصول المغاربة على غذائهم.
ها هي زيت الزيتون التي كانت تراوح مستوى ثلاثين درهما للتر الواحد، صعودا ونزولا، ترقص في مستوى المئة درهم. وها هو اللحم الأحمر وقد أصبح مثل الدرهم الأبيض، نذخره في المجمّدات لليوم الأسود. وها هي جل فواكه الموسم، من بطيخ ومشمش وبرقوق… ترفع التحدي عاليا في وجه متوتسطي المغرب وفقرائه.
خلاصة ما فعله مخطط المغرب الأخضر بمستوى معيشة المغاربة، أن المغرب كان فقيرا لكن المغاربة كانوا أغنياء. جاء هذا المخطط ليجعل المغرب أغنى، لكنه حوّل المغاربة إلى شعب من الفقراء العاجزين عن إتمام شبعهم خلال الوجبات. كان المغرب فقيرا بفلاحته المعيشية البسيطة والتقليدية، لكن المغاربة كانوا يحصلون على الطماطم والبطاطس والجزر… إلى جانب الخضر الموسمية من فول وفاصوليا وقوق… وكانوا يتذوقون الفواكه الصيفية في وقتها وبمذاقها الحلو الأصيل… لكن فلاحتنا تطوّرت واغتنت، فأصبحنا جميعا فقراء، نراقب غلالنا وهي تعبر تحت أنوفنا من المزارع والضيعات إلى موانئ التصدير، فلا نجد إلى ما تبقى من “شياطة” سبيلا.
هذا جزء من التفسير الممكن لما حصل لفاكهة التين الشوكي. أتى مخطط المغرب الأخضر رافعا شعار “التثمين”، وشجّع على تأسيس التعاونيات والبنيات الصناعية الضرورية لجمع وتحويل هذه الفاكهة التي تمنحها الطبيعة مجانا تقريبا، إلى زيوت ومستخلصات طبية وتجميلية تباع في الأسواق العالمية بالعملة العصبة.
هذا هدف قد لا يجد القائمون على هذا المخطط، وفي مقدمتهم وزير الفلاحة السابق ورئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش، أي حرج في الافتخار به والدفاع عنه. وأنا مستعد باسمي الشخصي، للتغاضي عن الأمر، بما أن النتيجة النهائية هي خلق نشاط صناعي وتجاري منتج لفرص الشغل والقيمة المضافة العالية، ويصدّر مواد ثمينة، ودون أية كلفة بيئية تقريبا، من حيث استهلاك المياه.
نعم من واجب السياسة العمومية أن تحرص على استمرار الاكتفاء الذاتي، والحفاظ على توازن النظام الغذائي للمواطنين، والعمل في الوقت نفسه على التثمين وتصنيع، وعلى الرفع من الإنتاج وتنويعه حتي يستمر تزويد السوق المحلية بهذه الفاكهة موازاة مع التصنيع والتصدير… لكنني شخصيا مستعد للاكتفاء بحبة واحدة من “الهندية” بدل خمس أو ست.
المشكلة أن هذا “التثمين” ليس السبب الوحيد ولا الرئيس لخسارة المغاربة أحد مصادرهم الأساسية من الغذاء الصحي والرخيص. السبب الأخطر والأكبر هو تلك الحشرة المعروفة باسم “الحشرة القرمزية”، والتي ضربت مناطق واسعة من المغرب، وتحديدا المناطق التي كانت توفّر الجزء الأساسي من الإنتاج الوطني، وسط وجنوب المملكة.
سوف لن نبحث في المجلات العلمية ولا تقارير المنظمات الدولية، بل سنكتفي بوثيقة قصيرة صادرة عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، المعروف اختصارا باسم “أونسا”. ونقرأ في هذه الوثيقة التحسيسية بخطر هذه الحشرة، كيف أن هذه الأخيرة ظهرت في المغرب أول مرة أواخر العام 2014، بينما يعود أصلها إلى الغابات الاستوائية وشبه الاستيوائية في كل من أمريكا والمكسيك.
وحين نعلم أن أمريكا والمكسيك هما أكبر منتجي هذه الفاكهة، وما يستخرج منها من زيوت ومواد صناعية وطبية. علاوة على كونهم أصل نبات الصبار الذي أطلق عليه المغاربة اسما يحيل على الهنود الحمر… فإن الاشتباه في تعرّض المغرب لضربة خارجية بسلاح بيولوجي من نوع “الحشرة القرمزية”، يصبح فرضية بديهية.
والعارفون بحروب أسواق المنتجات الزراعية، يعرفون جيدا قصص هذه الحروب، وكيف يتم تسريب الفيروسات والجرثومات والحشرات المدمّرة للزراعات، من بلد إلى آخر للقضاء على المنافسة.
ويمكن لمن شاء أن يختبر حساسية هذا الموضوع، أن يحصل على تأشير سفر إلى الولايات الأمريكية، ويحاول دخولها حاملا أبسط كمية من المواد الغذائية، ولو كانت بحجم سندويتش أو ربطة “نعناع”، ليعرف كيف أن الأمر أصعب من تمرير شحنة مخدرات صلبة، لأن الحرب البيولوجية لا تقل فتكا وخطورة من الحروب النووية والكيماوية.
هل هذا مبرّر يعفي القائمين على الشأن العام ويعفيهم من تحمّل المسؤولية؟ كلا.
الذي خطّط ودبّر في اليوم الأول لما يعرف بالمغرب الأخضر، “شاف الربيع ما شاف الحافة”. ومثلما جرى تجاهل الانعكاسات البيئية الخطيرة لتشجيع بعض الصادرات المستنزفة للمياه، مثل الطماطم والفواكه… نسي شقا أساسيا في التخطيط، وهو استحضار المخاطر وتوقعها وتدبيرها.
لا يمكنك أن تجلس في مكتب مكيّف في الرباط (أو أكادير)، وتحلم باقتحام أسواق دولية عالية القيمة ومربحة، لمنتجات ومستخلصات فاكهة التين الشوكي، دون أن تتوقع ردّ الفعل المحتمل للمسيطرين على تلك الأسواق، وإمكانية ركوب الحشرة القرمزية للرحلات العابرة للأطلسي، واستقر ارها في حقول الصبّار المغربي في سوس والصحراء.
وحين تفعل ذلك، فمن الطبيعي أن تتفرّج علينا اليوم من برجك العاجي، ونحن نبكي خسارتنا المزدوجة: من جهة افتقار التعاونيات والبنيات الصناعية التي استثمرنا فيها للمادة الأولية الأساسية، ومن جهة ثانية افتقاد المغاربة البسطاء لفاكهتهم الرخيصة والمغذية. أي “لا ديدي لا حبّ الملوك”.
ولا نملك أمام هذا المصاب الجلل إلا أن نردد مع الشاعر عبد الرحمان فهمي في قصيدته “الجايحة”:
…
دخلت عليك بكل ما فالكون من اسرار
دخلت عليك بكل ما فالارض من نوار
دخلت عليك بصبيان الدوار
شيوخ وعكّايز
وحنوط لكنايز
سبايا واحرار
دخلت عليك بكل خيمة ودار
بعاهد لقبيلة
والشوك الصبار
ها لعار ..
ها لعار
لا ما كفي علينا لضرار
الا كنتي قدار
ها كفوفنا مرفوعة تايبة للقهار…