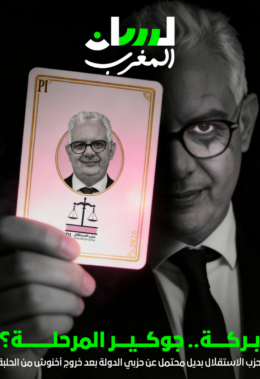تشريعات الأحوال الشخصية
من المقاربة التوفيقية إلى المقاربة الدستورية الديمقراطية
إلى متى ستبقى النخب الفكرية والسياسية والإعلامية تستنزف طاقتها وجهدها في مناقشة قضايا الأحوال الشخصية، وما يرتبط بها من تشريعات مرتبطة بحقوق الأسرة والمرأة والطفل، بطريقة ترى فيها كل جهة من الجهات المتجادلة أن منظورها هو المنقذ مما تعتقد أنه “ظلال تشريعي” أو “قصور قانوني” أو “حيف حقوقي”، وكأنها تمتلك المغرب وحدها؟
هذا المغرب الذي هو عائلتنا جميعا، تحتضننا جميعا، باختلافاتنا وتنوعاتنا، الأمازيغية والعربية، التي لا تحول بين أن يجلس على ذات مائدة العائلة المتدين ليتقاسم طعامه مع أخيه “الضعيف التدين” أو حتى غير المتدين، ولا يجد حرجا في التبادل والتقاسم مع جاره الذي يدين بملة موسى، الذي تشبث بالبقاء في بلده ولم تغره الدعاية الصهيونية بالهجرة إلى “أرض الميعاد”. ويخرج وإياه في مسيرات النضال الديمقراطي والحقوقي، ووقفات الاحتجاج الشعبي ضدا على غطرسة الاحتلال الصهيوني.
هل سيتحمل المغرب، باعتباره بيتنا جميعا، هذه الاحترابات النخبوية التي تطفو على السطح، على رأس كل عقد من الزمن على الأقل، بسبب غياب “سياسة الاعتراف” و”ثقافة الاعتراف”، الاعتراف بالمغرب، كما هو لا المغرب المتخيل إيديولوجياً عند هذه الفئة من النخبة أو تلك، المغرب المتعدد والمتنوع؟ خاصة وأن هذه الاصطفافات المجتمعية، بلغت حدتها القصوى خلال بداية الألفية بسبب ما عرف حينها ب”خطة إدماج المرأة في التنمية”، حيث بدا الانقسام النخبوي حادا حول قضايا الأسرة والمرأة والطفل، حاولت المؤسسة الملكية احتواءها بتعيين السيد محمد بوستة رئيسا للجنة مراجعة مدونة الأحوال الشخصية، الذي اتبع المغرب منهجية سياسة توفيقية لمعالجة القضايا الخلافية ذات الصلة بهذه القضية.
ومن دون التبخيس من قيمة المقاربة التوفيقية لقوانين الأحوال الشخصية، التي أدت دورها خلال مراحل تاريخية من تطورنا المجتمعي والقانوي والدستوري، فإننا نعتقد أنه، وبعد دستور 2011، أصبحت المقاربة الدستورية لهذه القضية تفرض نفسها فرضا، ومن غير المناسب الحديث عن مقاربات غير دستورية لهذه المسألة. فهذا الدستور، هو أكثر الدساتير التي عرفها المغرب الحديث، تقدما على مستوى توزيع السلط وتوازنها، وعلى مستوى ضمان الحقوق والحريات، وعلى مستوى الانفتاح على سمو المواثيق الدولية.
وككل عمل بشري، لا بد أن تسجل على دستور 2011 تحفظات من هنا، واعتراضات من هناك، وهو أمر طبيعي في مغرب متعدد ومتنوع، ويعطي للإجماع الوطني مدلولا خاصا، بما لا يشترط التطابق التام في الآراء والتقديرات، بقدر ما يعني حدا معقولا ومقبولا من التوافق على العيش المشترك والسلم الأهلي والمجتمعي. إذ لم يشهد المغرب، نقاشات وحوارات وجدالات وجلسات استماع، واستشارات واسعة، مثل تلك التي عرفتها لحظة التحضير للوثيقة الدستورية التي تؤطر اليوم عيشنا المغربي المشترك، باعتبارها القانون الأسمى الذي هو عنوان تعاقدنا المجتمعي.
إننا نعتقد أن المنهجية الدستورية المتبعة، إلى حدود اللحظة، ينبغي تثمينها، فالقوانين المؤطرة لسلوك المغاربة الخاص والعام، تستمد مشروعيتها الإلزامية من المؤسسة البرلمانية، ومهمة الحكومة، تقديم مقترحات قانونية بهذا الصدد. كما يمكن للبرلمان القيام بمبادرات تشريعية ذاتية، شريطة احترام الجميع، حكومة وبرلماناً، للوثيقة الدستورية نصا وروحا، وكل إجراء مخالف للدستور مآله البطلان، الذي تقدره المحكمة الدستورية بصفتها الجهة القضائية المختصة.
تطلب المقاربة التوفيقية من كل طرف من الأطراف المتجادلة، التنازل عما يعتقده ثابتاً من “ثوابته” و”اعتقاداته” ليقترب من الطرف المناقض له، وهذا يدخل في إطار المطالب التي يصعب تلبيتها عن اقتناع وإيمان راسخ، وإذا كان لا بد من الاستجابة لها، فلا يتم ذلك إلا من باب “التكتيك المرحلي”، في انتظار أن تسمح الظروف باستعادة ما تم التنازل عنه. فلا “الحداثيون” يمكنهم أن يتنازلوا ل”المحافظين” على ما يعتقدونه جزءا لا يتجزأ من قناعاتهم الحقوقية الراسخة، ولا “المحافظون” يستطيعون تقديم أي تنازل بخصوص ما يرون فيه تعديا على الشريعة، وتجاوزا لتعالميها بخصوص الحلال والحرام.
هكذا، تعد المقاربة الدستورية، بما تقوم عليه من مبادئ ومرتكزات، أجمع عليها جل هؤلاء، “الحداثيين” و”المحافظين”، وهي”الدين الإسلامي السمح، والوحدة الوطنية المتعددة الروافد، والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطي”، هي المسلكية الطبيعية والسليمة للتسوية المجتمعية المنشودة.
إن اتباع المنهجية الدستورية، هو ما يمكنه أن يقدم التسوية الديمقراطية المطلوبة لقضايا الأحوال الشخصية، بطريقة لا تفرض على الناس تغيير معتقداتهم، الفكرية والدينية والمذهبية، فهذا غير مطلوب وغير ضروري، بالنسبة لمجتمع مفتوح كالمجتمع المغربي، تتفاعل فيه تيارات فكرية وسياسية ومدنية مختلفة، منها من يرى أن الخلاص الفردي والجماعي لا يمكن أن يتم خارج مركزية الدين، ومنها من يرى الخلاص الفردي والجماعي خارج الموروث الفقهي التقليدي، بالانفتاح على منظومات فكرية وقانونية مستمدة من سياقات حديثة ومعاصرة.
إنه من غير المجدي أن نطلب ممن يوظف آليات القراءة الحرفية للنصوص الدينية وآليات تأويلية محافظة للدفاع عن تصوره للكرامة الإنسانية، أن يغير موقفه بسهولة أو يتنازل عن مقاربته هذه من أجل الالتقاء بالآخر المخالف له في التوجه والتقدير، كما أنه من غير الممكن طلب الخطوة ذاتها ممن يعتبر نفسه رافعا لراية حقوق الإنسان في صورتها المحافظة المستمدة من المركزية الغربية.
ورغم اعتقادنا، أن كلا الطرفين محافظين، سواء من جهة الجمود على الموروث الفقهي أو على المفهوم التقليدي لحقوق الإنسان، فإنه لا يمكننا إلا الاعتراف بحق كل طرف في اختلافه، وحقه في معتقده، والدعوة إليه، والسعي إلى الإقناع به؛ انطلاقا من رؤيتنا الفلسفية، التي تستلهم بعض أفكارها مما يعرف اليوم في الفلسفة السياسية المعاصرة بسياسات التعدد والاعتراف، ونظرية المواطنة المتمايزة، والتي تقوم على نمطين من الحماية المجتمعية والفردية.
أولها، حماية حقوق الجماعات التي ترفض التقاليد الليبرالية كليا أو جزئيا، وتنتصر لحقها في الاحتكام إلى تقاليدها وأعرافها حتى ولو كانت مناقضة للمبادئ الليبرالية، وليس من حق المجتمعات الليبرالية فرض مبادئها على المجتمعات غير الليبرالية، من خلال استغلال ما تتيحه المؤسسات الدولية، وخاصة الاقتصادية، من آليات الضغط والإكراه. وثانيهما حماية حقوق الأفراد داخل الجماعات غير الليبرالية؛ إذ ليس من حق الجماعة فرض قيود على أفرادها، تحول بينهم وبين ممارسة حقهم في الاختلاف.
هذه المقاربة القائمة على التفاهم والتسوية والتسامح بين المكونات المجتمعية، والمتجاوزة للمقاربة التوفيقية التقليدية، ولا تفرض على أي فئة مجتمعية الإقدام على تنازلات مبدئية، تسمح بها الوثيقة الدستورية المغربية، بل تتلاءم معها، نصا وروحا، حسب تقديرنا، من خلال ما أسفر عنه تأملنا لأركانها الأربعة السابق ذكرها.
فإذا تأملنا في ركن “الإسلام السمح”، فسنجده يتعلق بدين الأغلبية من المغاربة، لكننا نجد داخل هذه الأغلبية فئات متعددة، تتوزع بين المتدين و”غير المتدين”، والمتدينون أصناف وأنواع، يتوزعون بين تدين فردي، وتدين سياسي. كما أن “اللامتدينين” أصناف وأشكال، ونحن نضع عبارة “غير متدين” بين مزدوجتين عن قصد وإصرار، ما دام التدين مسألة إيمانية واعتقادية من الصعب قياسها بالنسبة لهذا الفرد أو ذاك، بحيث ليس من حق أي جهة فرض تصورها لما هو تدين حقيقي على الآخربن المختلفين، عملا بالقاعدة الدستورية القائمة على “الإسلام السمح”، وإضافة مفردة “سمح” هنا ليست من باب البلاغة والإنشاء، ولكنها، في اعتقادنا، تتبنى تأويلية قائمة على مبدأ لا إكراه لا في الدين ولا في التدين. وأن الاختلاف سنة من السنن الكونية. وكل ذلك يصب في مصلحة الوحدة الوطنية، القائمة على أساس الاختيار الديمقراطي، والنظام الملكي بأدواره الضمانية والتحكيمية.
إذا كان من المتعذر، في ظل الثقافة المحافظة السائدة في المجتمع المغربي، تغيير قوانين الإرث مثلا، فإنه، ووفق نموذج المواطنة المتمايزة، لا يمكن فرض هذه القوانين قسرًا على النخب والفئات، التي تنطلق من تصورات أخرى مغايرة وغير محافظة؛ إذ يمكن تبسيط المساطر التي تتيح للأفراد والأسر والمجموعات، العمل بالمساواة التامة بين الجنسين؛ وذلك وفق أطر قانونية واضحة تحظى بإجماع كل الفئات المختلفة.
ولعل هذا ما سبق أن تطرق إليه المفكر المغربي عبد الله العروي، في سياق عرضه لفلسفته في التشريع، حيث عرج على مسألة الإرث قائلا: “في مسألة المساواة في الإرث، ودون الدخول في التعقيدات، يوجد نظريا حل وهو تعميم الوصية. اليوم أناس كثيرون يتحايلون على النص، عن طريق الهبات والتنازل المسبق على الملكية، ليكون حظ البنت مساويا لحظ الابن. والأمر أوضح عند الميسورين المثقفين منه عند المعوزين الأميين (…) تلقى مسؤولية الفصل في قضية الإرث على الفرد. يظل النص على حاله ويعود تطبيقه بيد صاحب الشأن. هو الذي يختار إما أن يطبقه بالحرف وإما أن يتصرف” (من ديوان السياسة، ص125).
ومن دون الدخول في جدل فقهي وقانوني حول مفهوم الوصية، ومجالاتها وحدودها، فإنه يمكن تبسيط تدابير إبرام عقود الهبات والصدقات والوصايا، وغيرها من المسميات، ويمكن نحت مسميات أخرى لها، لتخدم قضية التسوية المجتمعية المنشودة حول هذه القضايا الخلافية المزمنة، بما لا يمس بما تراه أي فئة من الفئات المتصارعة معتقداتها الخاصة، التي لا يمكنها التنازل عنها، بالاستثمار في كل ممكنات الاجتهاد التشريعي وأسباب الابتكار النظري للحلول والتسويات المجتمعية الكبرى.
ينتبه العروي، بعين المؤرخ الفاحص والناقد، إلى أن هذه الإجراءات، معمول بها عند الفئات المثقفة والميسورة. ولعله يقصد أنها تملك ما يكفي من الثروة لتقسيمها، والقدرة المادية على أداء رسومها، ونحن نضيف إلى ذلك أن هذه الرسوم، تتجاوز قدرة الفئات الفقيرة، وحتى المتوسطة، ومن المفيد للمشرع القانوني تبسيط المساطر القانونية والرسوم الضريبية على تدابير الوصية والهبة والصدقة إلى أقصى حد ممكن، بما ييسر المهمة على كل مواطن يريد العمل بها.
هذه التسوية ليست جديدة على التشريع المغربي، فنحن نقرأ في المادة الثانية من مدونة الأسرة المغربية ما يؤسس مفهوم المواطنة المتمايزة بالنسبة لليهود المغاربة الذين تسري عليهم قوانين خاصة بأحوالهم الشخصية العبرية المغربية. علما أن بين اليهود المغاربة متدينين وليبراليين وماركسيين، ومنهم المحافظ في أحواله الشخصية، و”الحداثي” في رؤيته السياسية العامة، ولا نسمع بينهم أي ضجة أو صخب بصدد قوانين أحوالهم الشخصية، وهي محافظة جدا، بل مغرقة في التقليد تقليدا لا يقل عن تقليدانية بعض القوانين المستمدة من الشريعة الإسلامية.
هكذا نلاحظ أن المدونة القانونية المغربية تبقي على القوانين المستمدة من الشريعة اليهودية، كما هي، وتلقي مسؤولية تطبيقها على الفرد باعتباره مواطنا مغربيا، له ما لبقية المغاربة من حقوق وعليه ما عليهم من واجبات، في إطار منظومة دستورية تستوعب هذا التعدد والاختلاف، بل تقره وتعترف به. وهي تؤسس بذلك، عن وعي وقصد، أو عن غير وعي وقصد، لما يعرف في الفلسفة السياسية الأنجلو ساكسونية بمفهوم المواطنة المتمايزة الذي يتجاوز مفهومها التقليدي والمحافظ الذي نظرت له الفلسفة السياسية القارية وهو مفهوم “المواطنة المتماهية”.
تمدنا الفلسفة، والفلسفة السياسية المعاصرة خصوصا، بآليات تمكننا من التفكير خارج الأطر الفكرية التقليدية والسائدة، وابتكار حلول لمشاكلنا المجتمعية الراهنة، فالفلسفة تفكير إنساني في الإنسان وفي قضاياه القيمية والوجودية، الحميمية والمصيرية؛ ومن بينها الحق الإنساني الأصيل في أسرة قائمة على المودة والرحمة والعدل، وتتمتع بالحد الأدنى للعيش الكريم. وما من أحد يجادل اليوم، أن العمل المنزلي، بما يوفره للأسرة من خدمات جليلة، يعد خدمة عمومية، تقدمها المرأة، ربة البيت، تسهم إسهاما فعالا في التنمية المجتمعية، التربوية والثقافية والاقتصادية، وهي بذلك تتعدى حدود كوكبة الأسرة ليشمل أثرها المجتمع ككل.
وعليه، ليس من العدل، ألا يعترف المجتمع بهذه الخدمة العمومية، وألا يتحمل تكلفتها الإنسانية والمادية، فمهام الحمل والولادة والرضاعة، ووظائف الرعاية الاجتماعية المختلفة، لا تقل أهمية، بالنسبة للمجتمع، أي مجتمع إنساني، وفي كل زمن وعصر، عن بقية الوظائف المجتمعية الأخرى، كالتعليم والتطبيب والأمن وحماية الحدود وغيرها من الحرف والمهام والوظائف المجتمعية الضرورية للبناء المجتمعي.
إن تثمين العمل المنزلي، باعتباره خدمة عمومية، يتحمل المجتمع ككل، ممثلا في الدولة، تأدية مستحقاتها، بما يتلاءم مع الوضعيات الأسرية المختلفة، ومستويات النمو الاقتصادية المجالية، يعد خطوة مهمة على طريق تحقيق العدل المجتمعي والإنساني، وتجسيدا لثقافة الاعتراف وضرورة الوعي بهذا الاعتراف وتجسيده على مستوى الواقع التشريعي المغربي.
إن إطلاق المجتمع تسمية “ربة البيت” على المرأة التي يقتصر دورها على العمل المنزلي، ينم عن وعي متقدم بأهمية هذا الدور وحساسيته وخطورته، ف”ربة” البيت، هي مالكته وسيدته، والملمة بكل تفاصيله، والمرتبة لكل أركانه، لا يعقل، عقلا وشرعا، أن تنقلب وضعيتها رأسا على عقب، بعد وفاة زوجها، فتتحول من ربة البيت وسيدته، إلى ضيفة على غيرها من ورثة زوجها، من أبنائه وعصبته؟
أليس من العدل توفير نوع من الحصانة التشريعية لبيت زوجية، تحقيقا لمقاصد العدل والإنصاف التي تصبو إليها كل الأديان السماوية والقوانين الوضعية؟ ماذا لو فعل المشرع المغربي، قانون “العمرة الإجبارية” المستمد من الشريعة الإسلامية نفسها؟ ماذا لو اعتمرت المرأة بيت الزوجية، سيدة، كما كانت خلال حياة زوجها؟
وبعيدا عن المزايدات التي قد تطول هذا الإجراء التشريعي، من قبيل حرمان ورثة كانوا يعيشون مع الهالك وتحت كفالته، مثل الوالدين والأقارب في وضعيات هشة، مثل ذوي الاحتياجات الخاصة، فإن من شأن تدقيق كل حالة بما يناسب وضعيتها التي كانت قائمة قبل وفاة الهالك، وتوفير الضمانات القانونية للمحافظة على الحقوق المكتسبة للأفراد الذين كانوا يتقاسمون العيش المشترك في بيت الزوجية من شأنه أن يدلل العديد من المصاعب الممكنة والمشاكل المحتملة.
ولعل من بين القضايا التي تتطلب معالجتها الكثير من روح الانسجام التشريعي، مسألة إثبات النسب، وما يترتب عليه من حقوق وواجبات؛ فنحن نعترف بالنسب للمغربيات المتزوجات من أجانب، ولا نفرق في ذلك بين أن يكون هؤلاء الأجانب على ملة الإسلام أو على ملل أخرى، ونحن لا نحقق في كل حالة هل نتيجة زواج “شرعي” أو “مدني” أو “توافق رضائي” أو “اغتصاب”، كل ما نعرفه أنه يحق للمواطنين المغاربة من أبناء مغربيات العالم، ما يحق لكل المواطنين المغاربة، فكيف نتردد فيما يخص مسألة إثبات النسب لآباء مغاربة؟
إن التفكير في المصلحة الفضلى للطفل المغربي، أيا كانت وضعيته الإنجابية، ينبغي أن تكون مقدمة عند المشرع على ما عداها، سواء من باب “ولا تزر وازرة وزر أخرى” إذ ليس من العدل معاقبة طفل لا ذنب له، طيلة حياته، على ذنب اقترفه أحد والديه البيولوجيين أو كلاهما؛ أو من باب “دفع مفسدة كبرى بمفسدة صغرى”، ولا أحد يقبل على نفسه أن تبقى شريحة من المواطنين المغاربة بلا نسب أو هوية، فتلك مفسدة نفسية واجتماعية كبرى، نعتقد أنها لا تنسجم مع أول ثوابتنا الدستورية وهو “الإسلام السمح”، فضلا عن مخالفة ذلك للمواثيق والمعاهدات الدولية التي يقر الدستور المغربي بسموها.
أخيرا، وليس آخرا، هذه وتلك بعض المقترحات التي نضعها على طاولة المشرع المغربي، قصد مراجعة قوانين الأحوال الشخصية، المعروفة بمدونة الأسرة، وفق مقاربة جديدة، تنسجم مع الوضعية الدستورية المغربية، التي عرفها المغرب بعد سنة 2011، والتي من المفروض أنها قد قطعت مع أنماط المقاربات التوفيقية التي عرفتها المراجعات السابقة، سواء خلال بداية الاستقلال أو خلال عقد التسعينيات من القرن العشرين أو خلال بداية الألفية الثالثة. وهي ذاتها المقاربة التي يمكن تطبيقها على بعض القضايا الخلافية المتعلقة ببعض القوانين الجنائية، والتي قد نعود إليها في مناسبة قادمة.
لقد وضعنها دستور 2011، على كل ما يمكن أن يسجل عليه من ملاحظات نقدية، في وضعية دستورية وديمقراطية متقدمة، من شأن أخذها بعين الاعتبار أن يعفينا من الكثير من هذا الجدل والصخب، الذي لا طائل من ورائه، وأن يضع حدا للكثير من المزايدات والمغالطات، سواء التي ينطلق أصحابها من مرجعيات “محافظة” أو مرجعيات “متحررة”، مادامت الوثيقة الدستورية المغربية تحتوي كل هذه المرجعيات وتمزج بينها في إطار تشريعي قابل، في نظرنا، للتأويل الديمقراطي التعددي، والمؤسس لنموذج المواطنة المتمايزة. مع الاعتراف أن مسألة التأويل هذه هي موضوع صراع ونضال مجتمعي، ينبغي أن تخوضه القوى المؤمنة بالديمقراطية والتعددية، أيا كانت مشاربها وخلفياتها، ضد قوى النكوص والردة الحقوقية والديمقراطية.