“بوحمرون” في الموروث الشعبي المغربيّ منذ القرن 18.. الداء الذي ارتبط بـ”الغضب الإلهي”
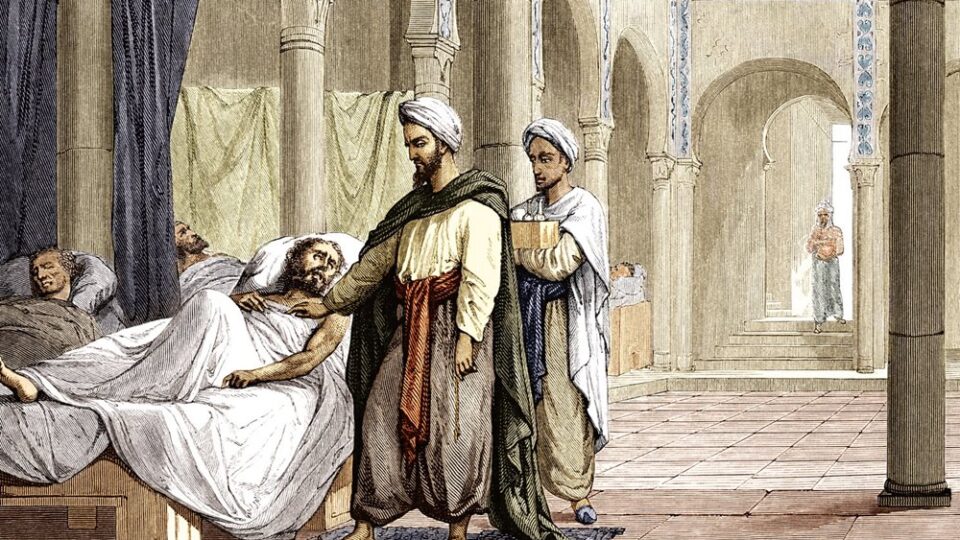
يُواجه المغرب، في الفترة الراهنة، تحديا صحياً جديداً، سنوات قليلة عن دوامة فيروس “كوفيد 19” التي أدخلت العالم في وضع الحجر الصحيّ الشامل.
ويتمثل هذا التحدي الصحي في انتشار داء الحصبة، المعروف شعبيا باسم “بوحمرون”، في عدد من مناطق المملكة في الشهور الأخيرة، بحيث أفادت معطيات حديثة أن حالات الوفيات جراء هذا الداء ارتفعت إلى 120 حالة، إلى غاية الأربعاء 22 يناير 2025، أغلبها أطفال دون الخمس سنوات وأشخاص بالغون أكثر من 37 سنة.
كما أن مدير مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي، صرّح للزميلة “هسبريس” بأن هذه الوضعية غير العادية منذ شتنبر 2023 تندرج بالفعل في إطار “الوباء”. بحيث تم تسجيل 25 ألف حالة منذ ذلك الحين، في مقابل تسجيل حالات قليلة سنويا لا تتجاوز 3 أو 4 حالات في السابق.
وتُعرّف منظمة الصحة العالمية الوباء بأنه “حالة انتشار لمرض معين، بحيث يكون عدد حالات الإصابة به أكبر مما هو متوقع، في مجتمع محدد أو مساحة جغرافية معينة أو موسم أو مدة زمنية”.
في هذا التقرير، سنتطرق إلى جانب من تاريخ المغاربة مع داء الحصبة، وكيف كانت أوضاعهم المجتمعية خلال هذه الفترات التي مسّ خلالها “الداء الأحمر” الأجساد دون أن يدخل الخوف في القلوب. وسننفتح، لهذه الغاية، على مؤرخة لها إسهامات مرجعية في التأريخ للأوبئة بالمغرب، وعلى سوسيولوجيّ سيقربنا من كيفية عيش المواطنين هذه الفترات الصعبة.
الحصبة منذ القرن 18
البيضاوية بلكامل هي مؤرخة مغربية اهتمت بشكل كبير بالتأريخ للأمراض خلال فترات الدولة المغربية منذ القدم. لها إسهامات مرجعية في هذا الباب، ومن بينها كتاب “الأوبئة عبر تاريخ المغرب: أنواعها وأسبابها وإدارتها”. وتشير فيه إلى أن المغرب اتسم بانتشار الأوبئة وذلك منذ القرن التاسع إلى بداية القرن العشرين.
وبالنسبة لداء الحصبة، “بوحمرون”، تبقى الإشارات التاريخية بشأنه شحيحة إلى شبه منعدمة.
ولعل أقدم إشارة لهذا الداء، تقول الباحثة بلكامل في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، تعود للقرن 18، وذلك من خلال الطبيب أبو عبد الله سيدي محمد الشبي السوسي الذي يعد من أعلام هذه المرحلة التاريخية المشار لها. وله مخطوطات طبية عديدة من بنيها مخطوط “راحة الإنسان في طب الأبدان”. وهو من مجايلي السلطان مولاي عبد الرحمن، وتوفي بمراكش سنة 1854م.
تقول بلكامل بهذا الخصوص: “هو من أقدم المؤلفين الذين أشاروا للحصبة في سياق حديثه عن الطاعون، بحيث أدرج الداء ضمن الأمراض الوبائية؛ مثلها مثل الجرب والجذام والحمى الحارة”.
وتضيف: “تنجم عن هذه الأدواء (جمع داء) وفق نفس المؤلف بثور في ظاهر البدن كالعدس بلون أسود أو أحمر أو أبيض، وأرجع سبب هذه الأوبئة -ولا سيما الطاعون الذي يتساقط من جرائه اللحم- لعوامل مختلفة، ومنها فعل الجن أو “خمر الهواء بسبب سماوي أو مجاورة أرضية كالمياه والكهوف والأزبال أو العدوى بمقاربة المرضى والموتى…”.
ويَعتبرُ أبو عبد الله، حسب نفس الباحثة، “الحمية أفضل علاج، ويدعو لتفادي الدخول للأرض الموبوءة، فهو معلل بإلقاء النفس للتهلكة. بذلك فالخلوة ولزوم البيت والانقطاع عن الناس أمور مطلوبة. وينصح بتجنب أكل الفواكه الفاسدة ولحوم المرضى من الحيوان وشرب الماء الفاسد”.
علاج “بوحمرون” في الموروث الشعبي
ومن منظور سوسيو-أنثروبولوجي، يقول السوسيولوجي، زهير البحيري: “كيفية تعامل المغاربة مع داء الحصبة أو ما يعرف ببوحمرون لدى عامة الناس ارتبطت بطبيعة المجتمع حينها، أي السياق الاجتماعي والتاريخي للوباء، حيث نجد أن بنية المجتمع المغربي حينها كانت بنية تقليدية، وكان يغلب على المجتمع طبيعته القروية وبنائه القبلي، وهو ما يعد محددا أساسيا في كيفية استجابة السكان للوباء”.
ويضيف أستاذ علم الاجتماع، ومدير مختبر التخصصات البينية في العلوم الاجتماعية بجامعة ابن زهر بأكادير، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب” أنه من الناحية الثقافية “كان يعتمد المجتمع المغربي حينها على العلاجات التقليدية والأعشاب والنباتات لتخفيف أعراض الوباء، وكان يتم أيضا استخدام أغطية ومشروبات ساخنة للتعامل مع الحمى والطفح الجلدي”.
وتعد العلاجات التقليدية، في هذا السياق، جزءا من التراث الطبي للمغاربة، والذي لا يزال يحظى باحترام لدى فئات متعددة من المجتمع المغربي ليومنا هذا. ومن الأكيد بأن الاعتماد على الطب التقليدي يؤدي إلى بناء نوع من الثقة والمشروعية خصوصا عندما تكون الخيارات الطبية الحديثة غير متاحة”.
وكان المجتمع يقوم أيضا بعزل الأفراد المصابين عن بقية السكان للحد من انتشار العدوى، يُواصل البحيري، ليُردف: “معناه أن المجتمع كان يدرك الطبيعة المعدية للوباء، فهذا العزل كان يتم داخل المارستانات (اسم المستشفى قديما) أو في أماكن يتم تخصيصها لهذا الغرض”.
كما كان يتم منع الدخول أو الخروج من الأحياء التي عرف أنها أصيبت بالعدوى، وهو ما نجده عند السلطان أحمد المنصور الذي أمر بإغلاق حدود الإيالة الشريفة وحظر أي اتصال بالأجانب بعد تفشي داء الطاعون بإسبانيا والجزائر خلال القرن 16، كما سُجل أيضا إغلاق المساجد وتعليق الصلوات الخمس خلال ما يعرف بعام الجوع الكبير سنة 1956″.

رسم يوضح جانب من سبل عيش المغاربة خلال القرن 19.
ويُبرز أستاذ علم الاجتماع أنه بحكم افتقار تلك الفترة إلى أنظمة صحية متقدمة أو حملات تلقيح هو ما جعل المجتمع يعتمد بشكل أساسي على تجاربه المكتسبة وتناقلها الشفوي، معتمدين على البنيات التقليدية المتوفرة آنذاك، كالأسواق والمساجد وغيرها، بغرض توعية الناس بخطورة الوباء والحد من انتشاره.
ولأن الوباء ارتبط في المخيال الاجتماعي للمغاربة بالغضب والعقاب الإلهي، بفعل كثرة ارتكاب المعاصي والابتعاد عن تعاليم الدين، “فذلك كاف لتوجيه تمثلات الفعل الاجتماعي نحو بعد غيبي، سواء على مستوى التفسير أي أسباب ظهور وتفشي الوباء، أو على مستوى البحث عن العلاج، وبالتالي فالوباء هو بمثابة معطى ميتافيزيقي يفوق قدرات الإنسان والعلم، والسبيل الأوحد يكمن في الرجوع إلى الدين والتمسك بتعاليمه”، يخلُص البحيري.
2008 سنة مُحاربة الداء
في ماي ويونيو من سنة 2008، تم إجراء حملة تلقيحات ضخمة للأطفال بين 9 أشهر و14 سنة. وقد كانت التغطية المتوقعة لهذه الحملة تصل إلى 99 في المائة من الفئة المستهدفة، حسب ما جاء في دراسة لخبراء مغاربة في الصحة العامة منشورة في ماي 2014 بـ”European Scientific Journal”.
وفي 2010 أُجري بحث مخبري تم بموجبه تحديد التعريف الوبائي للحالات المشتبه فيها. وتم تقييم النظام وفق مؤشرات منظمة الصحة العالمية. بحيث تم حساب الإصابة بناءً على بيانات الترصد الوبائي، ومقارنتها بمعدلات منظمة الصحة العالمية وهي حالة واحدة لكل مليون سنويا.
وتم الإبلاغ هذا العام عن 1083 حالة حصبة مشتبهة، إذ تم تحليل العينات الخاصة بها وتأكدت نسبة الإصابة في حدود 45 في المائة عن طريق تحليل عينات من الدم (491/1083). و115 حالة مؤكدة بالارتباط الوبائي.
وبحسب الورقة البحثية المشار لها، فإن البيانات الوبائية للبحث المخبري الذي تم إجرائه في 2010 أشارت إلى أن معدل الإصابة بالحصبة أعلى من تلك التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية.
“الداء الأحمر”
يُطلق المغاربة اسما شعبيا على الحصبة، وهو “بوحمرون”، بسبب البقع الحمراء التي يتسبب فيها على مستوى الجلد. لكن هذا ليس كل شيء. فهناك عدة أعراض لهذا الداء كالحمى والسعال الجاف والزكام وإفرازات مخاطية غزيرة من الأنف، وحساسية زائدة للضوء، وظهور نقاط صغيرة بيضاء اللون ذات مركز أبيض، وظهور طفح في الجلد يتكوّن من بقع كبيرة حمراء اللون تتداخل أحيانًا في بعضها البعض، وتهيّج العينين واحمرارهما، وأوجاع في الحلق.
هذه الأعراض التي أدرجها الموقع الطبي المتخصص “ويب طب” تبدأ “غالبًا بظهور حمّى بسيطة حتى متوسطة ترافقها أعراض أخرى مثل: سعال متواصل، زكام، تهيّج في العينين واحمرارهما وأوجاع في الحلق، بعد يومين أو ثلاثة تبدأ بقع كوبليك (حمراء) بالظهور وهي العلامة الأكثر وضوحًا على الإصابة بداء الحصبة”.
وبعد ذلك “ترتفع درجة حرارة الجسم أكثر، حتى تصل أحيانًا إلى 40 أو 40.5 درجة مئوية، وبالمقابل يبدأ الطفح المتمثل بالبقع الحمراء الكبيرة بالظهور عادةً في منطقة الوجه على طول خط الشعر وما وراء الأذنين”.
ثم “يثير الطفح حكّة بسيطة تبدأ بالنزول إلى أسفل منطقة الصدر والظهر وفي النهاية إلى ما تحت الفخذ وحتى أخمص القدم، ثم بعد مرور أسبوع تبدأ الحساسية بالاختفاء بنفس المسار الذي بدأت به”.

صورة توضح أعراض “بوحمرون” على طفل رضيع
وقد تعرف المغاربة لأول مرة على اللقاح المضاد للحصبة ابتداء من سنة 1981. وتلى ذلك تراجع عدد الحالات المسجلة من 120 ألفا خلال السنة المذكورة إلى 4216 سنة 1984. ولكن ذلك لم يمنع من حصول انتكاسة ابتداء من سنة 1987، السنة التي سُجّلت خلالها 26 ألفا و621 حالة، بحسب أرقام أدرجتها منظمة الصحة العالمية سنة 2005.
وبناء على ذلك، أطلقت الحكومة المغربية أيام التلقيح الوطنية ضد الحصبة، لزيادة نسبة التغطية الشاملة. وتطورت، بهذا، النسبة من 73 في المائة في عام 1987 إلى أكثر من 90 في المائة منذ عام 1996.
وفي عام 1997، انضم المغرب إلى منظمة الصحة العالمية/المكتب الإقليمي لشرق المتوسط للتخلص من الحصبة واستمر البرنامج في تحسين نسبة التغطية بالتطعيم بجرعة واحدة (التطعيم عند عمر 9 أشهر).
واستنادا إلى الورقة العلمية المنشورة في “الدورية العلمية الأوروبية”، ماي 2014، تم اتباع استراتيجية التطعيم بجرعة واحدة طيلة 23 عاما، وظلت الحصبة مرضًا متوطنًا في المغرب مع دورات وبائية، إذ يحدث كل 4 إلى 5 سنوات.
وتراوح عدد الحالات المبلغ عنها سنويا بين 1324 حالة في عام 1996 إلى 11000 حالة في عام 2003، مع تسجيل أعلى معدلات الإصابة في صفوق الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 9 سنوات.
واستجابة لتوصيات منظمة الصحة العالمية، تم اتخاذ قرار الاعتماد على جرعة ثانية من اللقاح المضاد لـ”بوحمرون”، وذلك منذ عام 2003، بحيث يشمل اللقاح جميع الأطفال عند دخول المدرسة (6 سنوات).
وأظهرت المؤشرات انخفاضًا كبيرًا في حالات الإصابة خلال السنوات الثلاث التي تلت هذه الخطوة. وانتقلت من 10841 حالة في عام 2003 إلى 1217 في عام 2006. ولكن وفي العام 2007، عاد الإبلاغ عن حالات الحصبة إلى الارتفاع ليصل إلى 2248 حالة.
وخلُصت الدراسة التي أنجزها الباحثون المغاربة إلى وجود إكراهات مستمرة أمام القضاء على الحصبة. بحيث أن التغطية الشاملة للقاح تحسّنت بمرور الوقت، وهي استراتيجية لا مفر منها عند فئة الأطفال لتجنب انتشار الفيروس.
كما أنه من الضروري أيضًا “الحفاظ على مستوى عالٍ من التطعيم في كل مجموعة ولادة لتجنب ظهور خزانات جديدة لإصابة الأشخاص”.




















