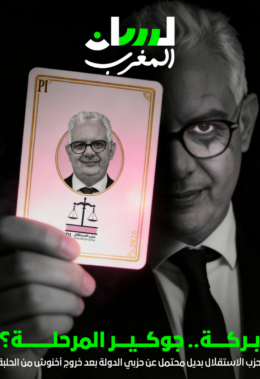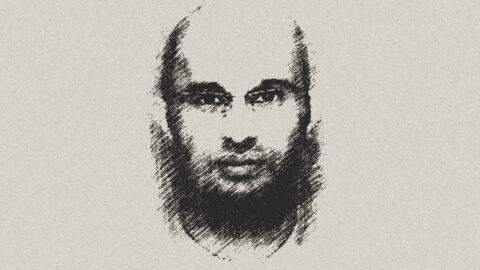المسرحي الفلسطيني تامر طافش: في المسرح كما في الحرب يجب أن نسند بعضنا – حوار

المسرحي الفلسطيني قدّم عرضا مسرحيا بعنوان “جسد يتذكر.. مساحة تتكلم”
- ما الفرق بين العرض كما تخيلته قبل الورشة والعرض كما شاهده الجمهور؟
أول ما جئت إلى مرسيليا بدأنا الورشة قبل ثلاثة أشهر، لم يكن مشروعي المُسبق أن نُقدم مسرحية للجمهور. صراحة لم تكن آمالي بهذا الكبر. أن نُقدم بناءً على الورشة مسرحية بهذه القوة والجمهور أحبّ النتيجة وعبروا على ذلك عبر ردودهم وتعليقاتهم والرسائل التي تصلني، هذا شيء صادم بالنسبة لي وليس مفاجئ فقط.
الاختلاف كان كبيراً جداً بين مشروعي في البدء للقيام بتنشيط ورشة مسرح عن الذاكرة، وما وصلنا إليه في النتيجة. ثم إن المسرحية عُرضت مرتّين وليس مرة واحدة ! في المرة الأولى أمام جمهور محدود، وفي المرة الثانية أمام جمهور أوسع. أحّس أن الفجوة كبيرة بين مشروع كما تخيلته أول الأمر وما وصلنا إليه في الأخير.
- هل سبق أن اشتغلت على موضوع “الذاكرة” كتيمة في المسرح؟
نعم، سبق أن عملت على مشروع أو مشروعين عن الذاكرة. هي عبارة عن أعمال فنيّة وليست ورشة أدّت لعمل فنّي كالتي عرضنا هذه المرة. أحد الأعمال الفنية عنوانه “ستون دقيقة من الذاكرة” يحكي عن ذاكرة الأسرى في سجون الاحتلال. العمل الآخر كان “خط التين” وهي مسرحية أخرجتها في عمان، وهي عن رحلة لاجئ فلسطيني، ونخوض عبر العمل في ذاكرته وذاكرة أجداده.
لكن هذه المرة الأولى التي نقوم بورشة تُنتِجُ مسرحية بناء على ذاكرة المشاركين فيها.
- كيف انتقيت المشاركين في الورشة؟
جزء من المشاركين في الورشة كانوا من محترفي المسرح والتمثيل قبل التجربة، وجزء منهم كانوا هواة ويخوضون التجربة للمرة الأولى. المميّز أن الفجوة لم تظهر كبيرة بين المجموعتين في العرضين النهائيين. هذا يدل أيضاً على التزام الأفراد المحترفين الذين أدمجوا البقية معهم وقاموا بالمشاركة في تدريبهم. هناك نوع من المهنية والالتزام فاجئني وأحببته صراحة في هذه التجربة.
- تبدو شديد التنظيم…
حاولتُ أن أضع خطة أولية لكل اللقاءات. أحاول أن أنظّم الأمور مسبقاً أغلب الوقت. لكنّي رغم ذلك أبقى ابن التجربة كما أحبُّ أن أوصف نفسي.هي التي تسير بي وتجعلني أمشي معها. لأعطي مثلاً على ذلك أنا جئت إلى مارسيليا كما أخبرتك بهدف أن أعطي ورشة عن المسرح، لكن التجربة أنتجت المسرحية التي عرضنا البارحة للمرة الثانية. فمن رد فعل المشاركين والممثلين والمتفاعلين نمّر لأشياء جديدة لم نكن وضعناها في الحسبان.
إذن التجربة هي التي أخذتنا لهذه النتيجة التي أنا سعيد بها وأتحدث عنها وسأذكرها بالخير والرضى.
- كيف تجاوزت حاجز اللغة؟
كان عندي تخوف من البداية من هذا العنصر، حتى شاركته مع فابيان وهي السيدة المشرفة على برنامج الإقامة الذي استضافني هنا. كان عندي سؤال عن ماذا بوسعي فعله مع أشخاص بيني وبينهم حاجز لغة كبير. هم يتحدثون فرنسية وأنا أتحدث عربية وليس بيننا أي لغة مشتركة. لكن من تجاربي السابقة سواء تلك التي عشتها في إيطاليا أو دابلن أو تركيا، كنت أحاول أن أكسر باستمرار كسر هذا الحاجز والبحث عن طرق للتواصل مع الآخرين بأدوات مختلفة: أن تكون قريباً من الناس، أن تكون لطيفاً، ثم أن تتواصل بالحركات معهم. ربما المسرح يُمكننا من تعبيرات جسدية مختلفة غير اللغة.
هنا ساعدني أيضاً لمّا علمتُ أن من المشاركين أشخاص عرب ويتحدثون اللغة العربية بوسعهم أن يُسهّلوا التواصل ويحملوا البقية معهم بالأفعال أو بالترجمة.
أفترض أن الحاجز اللغوي ليس حاجزاً كافياً في عمل الممثلين. علينا تحاشيه والقفز عليه لإدراك العمل ومتابعة الإبداع.
رغم أن الثلاثة أشهر قد تبدوا مساحة زمنية محدودة، لكن قمنا بإنجاز تمارين لخلق راحة عند المشاركين وثقة بين بعضهم البعض. ما يجعلني أفكّر أن الوقت ليس معياراً محتكماً بطريقة مُحكمة. لقد استطعنا أن ننتج في هذه المساحة الصغيرة فضاء مميز استطاع المشاركين أن يفكروا فيه بصوت عال.
المنهج الذي اعتمدته يضم تمارين لكسر الحواجز بين المجموعة. منذ بداية هذه الورشة وغالباً سأتابع استعمالها في بقية الورشات. ابتداءً من تمرين ذاكرة الأسماء قبل الولادة، وانتهاء باللعب بين أعضاء الفريق. وبينهما نُوجّه العمل المتراكم نحو هدفنا الذي كان في هذه المرة مرتبطاً بالذاكرة.
رغم وجود خطة مسبقة غالباً ما نرتجل. أحبُّ أن أوازي بين المستويين. أحاول أن أستمع للناس حولي وأرى كيف تتفاعل الأمور.
كثيرة هي المناهج التعليمية المسرحية التي استعملها. لقد درستُ المسرح في “عشتار” لمدة خمس سنوات، وكنا نأخذ دروس كثيرة من أساتذة مختلفين درسونا وراكمتُ خبرة بفضل ذلك، وأيضاً الأسفار في الخارج، راكمتُ تمارين مختلفة أستعمل جزءاً منها حسب كل تجربة.
- تُغادر المدينة بعد تجربتك فيها لثلاث شهور. أخبرني كيف وجدت مدينة مارسيليا ؟
أغرمتُ بالمدينة كثيراً وأناسها. في الصباح سألوني في اجتماع عن انطباعاتي عن المدينة فقلت لهم أنها “قريبة على قلبي”. كل يوم تُحّس بشيء متجدد يأخذ قلبك سواء للناس أو للتجارب الجديدة. الصدق أنّي لم أحب باريس. باريس كبيرة وتحتاج قضاء وقت طويل لتتحرك بين مناطقها. بينما هنا الأمور أصغر بشكل إنساني يجعلك قادر على الاستمتاع بالحياة وفضاءات المدينة دون أن تقضي نصف وقتك في وسائل النقل.
هنا في مارسيليا يوجد تنوع وعشوائية لكنها عشوائية جميلة وشارحة للنفس. الصدق أنّي لا أرغب في ترك المدينة، لكنّي أنوي العودة إليها مرات أخرى.
- ما الذي دفعك للمسرح؟
قصة فشل عاطفي هي التي جاءت بي للمسرح (يضحك)
أولا كنتُ درستُ الصحافة والإعلام بالجامعة في مدينة الخليل. لكن ظروف ممارسة الإعلام في فلسطين جعلتني غير قادر على تخيل نفسي كإعلامي هناك في الأخير. ما جعلني أتوقف عن المحاولة والاشتغال في أعمال متعددة، منها أني صرتُ أبيع فرش منزلية لسنتين أو ثلاثة في رام الله.
لمّا جاءت الكورونا، حصلت القصة العاطفية التي أدخلتني للمسرح. لمّا بدأت الدنيا في الإقفال حينها زاد أهلي وتحديداً أمي وأبي في تحديثي عن ضرورة الزواج، خاصة أنّي كبير إخوتي. بعد اصرار منهم وافقتهم وذهبنا لخطبة آنسة، لكنها رفضتني في الأخير.
زعلتُ حينها لكنّ ذلك الرفض صار مبرر لتحريري من ثقل التحريض المتواصل على الزواج من أهلي. حينها صادفتُ إعلان لتكوين في المسرح أثار شهيتي. وكان شرط التكوين أن يكون المتقدم أقل من 24 سنة.
وكان يفصلني شهرين فقط للوصول ل24 سنة، فراسلتهم برغبتي في المشاركة وحبي لمتابعة التكوين المسرح، وردوا عليّ أنّي سبق وطلبتُ التكوين طيلة الثلاث سنوات وأنّي يجب أن أكون متأكداً هذه المرة لأنها آخر مرة عندي الحق في التكوين، فعزّ عليّ ردّهم، وقررت أن هذه المرة سآخذ الأمور بجدية. فصار الرفض والرد على رغبتي في الخطوبة بعدم الموافقة أستوعب أنّي يجب أن أنتبه على الخشبة والتكوين فيها، وهو ما جعلني أصل إلى هنا اليوم، وأنتبه لنفسي وتجربتي، وأن أعرف أن أميّز بين ما أريد وما لا أريد… وجعل يفتح لي آفاق أكبر من تلك التي تخيلتها أول التجربة.
قبل هذه التجربة ما كنتُ أعرف حتى ما إن كنتُ سأستطيع أسافر أو قدرتي على مغادرة المخيم (مخيم العروب).
منذ اللحظة الأولى لدخول المسرح فتح أمامي عالم جديد، رام الله بانفتاحها مقارنة مع الأجواء في المخيم. جعلني ذلك الانفتاح الفاتن أفكر في لحظة معينة أن لا أرجع للمخيم. عندي صديق لمّا رأى تأثري في بداية أيام بمسرح “عشتار” وضع يده على كتفي، وطمأنني، أن الأمور ستسير على خير إذا بدلتُ مجهودي وهدأتُ تأثري. وهو ما وقع فعلا. الصراحة كان يغلبني شيء بين الخجل والحياء. هناك مدرس لما رآني قال : « أنصحك بأن تُجرّب كل شيء. أنت لن تندم على شيء عملته. سافر عيش دخّن تزوج… قم بتجريب كل شيء في الحياة. إلا الموت هو الذي سيأتيك ولست مضطراً للرغبة في تجريبه. جعلني ذلك أنجز مشهداً عن الموت. بالاعتماد على كتاب للكاتب ممدوح عدوان عنوانه “حيونة الإنسان”. يتحدث المشهد عن موضوع ترويض الحيوانات في افريقيا. ولمّا أنهيتُ المشهد أمام الأصدقاء، وانارت القاعة ونظرتُ للجمهور، رأيتُ أن أغلب المشاهدين بدؤوا يبكون متأثرين. نظر إلي ّ المدرب بفخر وقال : « هل رأيت؟ كما قلتُ لك، عيش وجرّب كل شيء” .
من يومها وانا أجرّب الأشياء وأعيش بين التجارب واحدة تأخذني لأخرى. منذ 2020 أحاول أن أجرب وهذه التجارب هي التي صنعتني اليوم. ذلك جعلني أكسر الخوف. ومن ذلك ما فعلناه في الأشهر السابقة، أن أعطي ورشة مسرح في فرنسا رغم أنّي لا أحكي حتى بالإنجليزية ! أسافر في بلدان مختلفة وأحاول أن أقفز على الحواجز المفترضة. سعيدٌ أنّي سأزور المغرب لإقامة هناك ست أشهر إذا تمت الأمور على خير. بعد ذلك عندي موعد مهم في اليابان ثم أعود إلى إيطاليا. كلّ ذلك نتيجة التجربة التي صنعتني وأحبّ أن أكون ابن لهذه التجربة.
- تحدثت عن كتابات ممدوح عدوان، لكن ما الكتب الأخرى التي تسند إليها أعمالك؟
هناك عدة كتب عن المسرح ساهمت في تطويري كممثل. مثلاً “إعداد الممثل في المعاناة الابداعية” لستانسلافسكي مثلا، هو يمشي معك خطوة خطوة لتصير ممثلا. هناك أيضاً كتاب لمسرحي عظيم فقدناه منذ سنة -أثناء الحرب- اسمه إدوارد بوند، وهو بريطاني كتب عن الأدوار الاجتماعية للمسرح، فكتب عن المسرح والتعليم، ثم المسرح والسياسة. لمّا درستُ كتاباته جعل يختلف في عيني لماذا أشتغل في المسرح، خاصة أنّ منذ السابع من أكتوبر اختفلت بشدة على الأقل على الصعيد الشخصي.
- كيف اختلفت الأمور بعد السابع من أكتوبر في المسرح؟ !
سابقاً كان المسرح يبتغي طُرق كلاسيكية أنت مضطر لمتابعتها حتى تدخل معايير معينة وتتبع قواعد الصحة والخطأ. تحّس قبل ذلك التاريخ كانت جدوى المسرح محدودة، والتاثير المسرحي كان بسيطا في ذلك الوقت، ويفترض ضائقة معينة ومواضيع معينة. مواضيع نسوية وسياسية بطريقة معينة وقواعد معينة. أما بعد الحرب صارت عندنا قدرة أكثر عن التجريب. مثلا أن تتخلى عن القواعد الجمالية التقليدية مقابل أن تشرح قصدك من المسرحية. أحس أن قبل سبعة أكتوبر لم تكن عندنا هذه الإمكانيات. كنت قبل ذلك التاريخ لما تُنجز عمل ترغب في العمل الذي سيُقيم الدنيا ويُحدث ضجة. اليوم خفّت هذه الجماليات وصار التركيز أكثر على القضية. مثلا “ستون دقيقة من الذاكرة” الذي يشتغل على قضية المعتقلين الفلسطينيين بالسجون الاسرائيلية كان بحد متقشف من الديكور والسينوغرافيا. فقط لصاق على الأرض تمثل زنازين، وكراسي منثورة في وسط المربعات. صار أنك تتخلى أو تهدئ التركيز على العنصر الجمالي في سبيل أن يسمع الناس قضية وقصص وتجارب. وهذا شيء مكنّنا من أن نشتغل بشكل جيد بإعادة بناء المسرح.
التجربة التي خضنا هنا في مارساي يُشبه ما أحدثك عنه، عند المشروع قضية يطرحها للناس، بدون بهرجة ديكور. وضعنا لصاق على الأرض بمربعات صغيرة على الأرض وقلنا للناس تعالوا شوفو ! حتى الإضاءة أو الديكور كان بدرجة محدودة الاتقان إلى منعدم، لكن في سبيل أن الناس تسمع وتركّز في القصة. لما جاءتني ردود أفعال من الحضور أنّ جزء أو أجزاء من المسرحية جعلتهم يبكون أو يضحكون أو يتأثرون، أحس اننا أنجزنا شيئاَ كامل التوفيق. هنا جدوى المسرح. أن تؤثر بشخص ما وتجعله يُفكّر بعدما غادر القاعة بما سمع وبما رأى و بالأسئلة والقصص التي تثير في نفسه. أكثر من الصورة الجمالية التي بعد سبعة أكتوبر في تقديري الخاص تقلّص دورها.
- هل تتحدث على تأثير سبعة أكتوبر على تجربتك الخاصة أم تقصد أنّ هناك تأثير جماعي على المسرح الفلسطيني والعربي؟
الأمر على الأقل يتعلق بتجربتي وبتجربة الناس الذي أعمل معهم، ولكن بعد سبعة أكتوبر هناك تأثير جماعي يمكن أن نجعله ملموساً لما نتذكر أنّ أغلب المؤسسات الأجنبية غادرت البلد. صار المسرحي الفلسطيني لوحده بعدما غادرت المؤسسات التي كانت تعطيك تمويلات، سواء الفرنسيين أو الألمان أو غيرهم، خاصة الألمان، غادروا.
هذه الحالة جعلت الفلسطنيين الذين يشتغلون بالمسرح يكتشفون أنهم لوحدهم، وأن رغم تلك الوحدة وغياب التمويلات هناك إمكانيات أولها حب المسرح. وبدأنا نجتمع ونخوض نقاشات، سمحت بتكوين نواة، للتفكير بطريقة جماعية. لمناقشة إمكانيات العمل من دون التمويلات الأوروبية، بل -أكثر من ذلك- مع رفضها وعدم الرغبة فيها.
- هل يمكن أن تخبرنا عن تلك الاجتماعات؟
للأسف لا، جزء من القائمين هم اليوم في سجون الاحتلال وأخاف أن يُستغل كلامي ضدهم. لكن يمكن أن أذكر لقاء مع كاتب فلسطيني اسمه غسان ندّاف، عرضتُ عليه نص مسرحية وأخبرني أنها تفتقد لعناصر الكتابة. فلمّا سألته المساعدة عرض عليّ ورشة في أساسيات الكتابة المسرحية ووافقته. كانت صديقة معنا في اللقاء لمّا سمعت الاقتراح أخبرتني أنها تريد الانضمام، ورحبنا بها، ثم غيرها وغيره، إلى أن صرنا عشرين شخص في الورشة، لنكتب مسرحيات لغزة. رجعنا لندرس منهجيات الكتابة وأعطانا غسان الأمور الأساسية . وفي الأخير كتب ستة أشخاص ست مسرحيات في مواضيع مختلفة. هذا الشيء الجمعي والرغبة في إنتاج المعنى والتنسيق صار أقوى من السابع من أكتوبر. وبناء عليه صرنا نُطوّر المشاريع ونفتحها مع الناس. والمميز في هذه التجربة أنها ما زالت تُكتب مع الناس. اليوم نُكمل مشهد من مسرحية، من خمس عشرة صفحة ونقرأها قدام الناس، ثم نسألهم رأيهم، ويبدأ نقاش كبير.
أتذكر ست مواضيع مختلفة: نص مرتبط بمعاناة النساء في الحرب . نص في علاقة الأب والابن في الحرب، وكيف يصير الابن أبا لأبيه في رحلة الكفن مثلا. أيضاً موضوع رحلة الجواز الفلسطيني لأنّ الأطفال في غزة لا يولدون بجوازات سفر. موضوع آخر عن كيف يصير المهادن مُقاوماً، ثم الموضوع الذي كنتُ أنجزتُه، وهو عن الرأسمالية والحرب، حكيتُ في مسرحية عن قصة شخص يضطر للمتاجرة في أعضائه حتى يستطيع المغادرة والهجرة.
لمّا عرضنا النُصوص قُدام الجمهور تمّ “تقطيعنا” نقاشاً، وكانت التجربة شديدة التأثير علينا كمُشاركين وفاعلين.
- ماذا يستطيع الفنان أمام الإبادة ؟!
هذا سؤال صعب ولا توجد إجابة مباشرة له.
منذ السابع من أكتوبر كُنّا في وضعية صدمة استمرت لعدة أشهر، غير قادرين على فعل أي شيء تقريباً. المؤسسات أقفلت أبوابها، القائمون على بناية المسرح أخبرونا أن علينا المغادرة، وغادرنا فعلا. كل الداعمين والمؤسسات الثقافية في البلد. الأوروبيون والأمريكان غادروا إلى بلدانهم. ومع إقفال الحواجز بين المناطق زاد الإقفال علينا. صار الفاعلون بعد ثلاثة ، أربعة أشهر يجتمعون بامكانياتهم الذاتية. صار دور الفنان هنا أن يبحث عن البيئات الحاضنة التي قد تُعطيه حيزاً يسند عليه ليقف. لأن على الصعيد الشخصي صارت ورطة. واكتشفت شخصياً أن دوري في المجموعة أقوى من دوري وأنا جالس في المخيم. صرنا ننضم ونُنظم مجموعات للشغل الجماعي مثل المجموعة مع غسان التي تعمل على الكتابة المسرحية. وبدأنا نضع ما يمكن أن نُطلق عليه دليل لكيف يمكن أن تشتغل داخل الإبادة؟ ما تعريف الفنان؟ وغيرها من الاسئلة التي تغيرت بعد سبعة أكتوبر. تصيرُ أيضاً راغباً في إنجاز أرشيف لهذه المرحلة. كل فنان يُجيب بطريقته صراحة. المسرح يكون دوره أن يكتب ويحكي ويلعب مسرحيات. المُصور له صياغة مختلفة أو الرسام وغيرهم. اختلف تعريف الفنان بنسبة كبيرة. طريقة التفكير والطرح كل ذلك اختلف ما قبل سبعة أكتوبر وما بعد سبعة أكتوبر.
- تريد إضافة عناصر عن تجربتك في مارساي؟
أنا استمتعت وانبسطت بالاختلاف الكبير بين القصص والعروض التي انجزناها. هي كانت مثل التحدي لي. أن أكون في بيئة غير بيئتي الاعتيادية وأن أعمل شيء مختلف عمّا تعودت انجازه.
لقد اشتغلنا في عرض المسرحية عن فكرتي “الذاكرة” و”المساحة”. أريد أن أخبرك عن كيف جاءت أول الأمر:عندي أخ أصغر منّي في سجون الاحتلال، في يوم كنا نتواصل.
اسمه آدم طافش وعمره عشرون سنة. قضى سنتين لمّا كان عمره ستة عشر سنة. وهذه المرة الثانية، سُجن قبل سبعة أكتوبر وسيُكمل سنتين قريباً.
مرة اتصل بي من السجن، وأخبرني أنه عرض مسرحية لزملائه في مساحة شديدة الصغر. في الزنزانة، قام بعرض مسرحية في حيّز أقل من متر طولاً ومتر عرضاً. شهادته هذه جعلتني أفكر، خاصة لمّا بدأت الحرب، طرقت رأسي، أنه في هذا الحيّز الصغير استطاع أن يلعب مسرحية لشكسبير لزملائه، وكنتُ معجباً بإنجازه، ومن هنا فكرتُ في تيمة “المساحة” أن نجعل منها فكرة العرض، نخوض فيه الذاكرة.
عنصر آخر ربما من المهم ذكره : أنا أعيش في رام الله، و رام الله مدينة فلسطينية مُنفتحة إلى حد ما. وأهلي يعيشون في المخيم، وفي المخيم الأجواء محافظة أكثر.
النزول إلى المخيم يؤثر فيّ بطرق مختلفة إلى درجة أنه يجعل مني شخصاً مختلفاً كلياً. في المخيم يختلف الأمر. أشعر كأنني شخصان مختلفان في رام الله عن المخيم. ثُمّ عن ذلك الذي يجلس أمامك هنا في فرنسا. طريقة اللباس، طريقة الحركة، الكشف والحجب من الجسد مثلاً في الوشم على الجسد.
كنتُ قُمتُ ببحث في المسألة، لكن، لمّا جئتُ الى فرنسا، صار عندي فضول للتعرف على الناس وكيف يُعبرون عن أجسادهم، كيف تُعبر عن نفسك من خلال جسدك. ورغبتُ في أن أقحم ذلك في عملنا. لذلك صارت العنصر الثالث في العمل الذي أنجزناه وهو الجسد. فصارت “مساحة وذاكرة وجسد”.
تجربة المسرحية التي عرضناها مميزة اللطف، تعلمتُ فيها وعلمت. أعتقد أنّي تعلمتُ فيها أكثر مما علمت. حول الذاكرة والجسد والمكان. وأتمنى أن تظل الأمور تستمر لما بعد. ليستمر المشاركون في العمل على ذاكرتهم ومواضيعهم بأشكال مختلفة. وإذا عندي نصيحة للناس فأنا أنصحهم بأن يُجرِّبوا وألا يخافوا من التجربة. إن التجربة التي تُغامر فيها هي تحديداً التجربة التي ستنقلك من شيء إلى شيء آخر مختلف تماماً. وهذا ما حصل معي كفرد، نشأ في المخيم، لآفاق رحبة ما زلتُ أكتشفها.
أيضاً أنا مسرور بالتنوع الذي كان في العمل. العمل مكنني أول مرة من التفكير في الأمازيغ الذي أثارتها ياسمين (أحد المشاركات في الورشة والعرض)، قصة نور وتجربته كلاجئ في بيروت. قصة ذكريات الطفل وعلاقته بعصفوره في عرض مشارك آخر. قصة سونيا وأصولها الجزائرية وهجرة أهلها الى فرنسا. وحتى قصص الفرنسيين الذين شاركوا قصصهم الذاتية من ذاكرته وتشجعوا أن يفتحوا الباب نحو أشياء شديدة الحميمية والقرب… خلقت تحدي وجعلتني أفكر في دور الفن وقدرته على جعل الناس المختلفين عبر القصص يهتمون ويُتابعون.
- كيف ترى في العودة إلى فلسطين خاصة مع امكانية بقاءك هنا في سياق ما يحدث هناك؟
أحس أن من حق كل واحد أن يطمح للأمان والشغل والشهرة. أحب أن أرجع مرات لأشتغل وأعود. هذا عندي طموح. لكن أفكر أيضاً أنّي بحاجة لفلسطين وأن فلسطين بحاجة لي. لأنّ في الآخر إذا طلعنا أنا والآخر من يحمل هذه الأمانة.
نحنُ نحملها ليس رفاهية بل مُجبرين. القطاع الفني والثقافي يجب أن يحمل هذه الأمانة. دوري هناك ليس فقط كفنان يُقدم مسرحية، لكن كفرد أيضاً يُساعد أشخاص على انجاز أعمالهم وحمل رسائلهم والتعبير عن قصصهم وهمومهم والأرشيف.
هذا مثلا كان دورنا منذ سبعة أكتوبر. اشتغلنا على ذاكرة السجون في مسرحية بعنوان “ستون دقيقة من الذاكرة”. لمّا عرضنا المسرحية كان الناس يخرجون محملين بغضب وبكاء ودراما، لكن وفي نفس الوقت لمّا تذهب تهتم وتسأل. بهذا المنهج أحسُّ أني ما زلت قادراً على الخدمة لسنوات طويلة في المستقبل. وأن البلد بحاجة لي وأنا بحاجة لها. بالنسبة لي ذلك شيء جيد ولستُ خائفا.
اشتقتُ بالاضافة إلى أهلي وأصدقائي إلى سيرورة الشُغل التي ليست فيها الرفاهية التي أجدها هنا، أحسّ أنّي مرفه بجانب الفنانين هنا، هناك رفاهية في الحركة وفي الراتب وفي الوقت. كل ذلك غير موجود في فلسطين. نحنُ هناك نعمل غالبا مجانا إذا لم تستطع أن تجلب له تمويل أو دعم. أنتَ هناك تتعامل مع الفن كمُقاومة وليس كرفاهية. أتمنى أن نصل لتلك الرفاهية، لكن ما دام هناك احتلال فليس بوسعنا العيش فيها. انبسطت كثيراً بحضوري ورأيتُ عروض، أغلبها “عادي”. وفكرتُ بعد رؤيتها أن أغلب العروض في العالم “عادية” وليست مُطالبة بأن تكون رائعة. لأن أغلب الناس لا يعيشون تحت الاحتلال، بينما نحنُ- في فلسطين، مطالبين بمستوى أكبر، لأننا نُواجه، ولأن حالة الفن مطالبة بأن تبقى موجودة و مُشتبكة ومُقاومة. ما دام هناك احتلال فنحنُ مطالبون بتلك المقاومة وأن هناك دور للفنانين والمثقفين بمُختلف تعبيراتهم بأن يقودوا أو على الأقل يُعبِروا عن ذلك الحراك.
*حواره: حمزة محفوظ