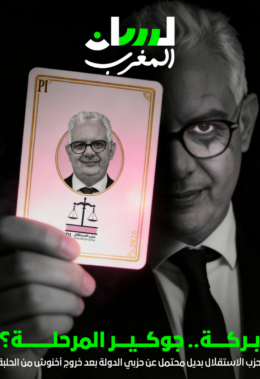السياسة وعلم السياسة في الوطن العربي

عند مشاركتي في الندوات “العلمية” التي تنظم في إطار الأنشطة العلمية للمختبرات ومراكز البحوث الأكاديمية في المغرب وفي بعض بلدان “الوطن العربي”، أجد نفسي محرجا من بعض الأسئلة والملاحظات التي توجه لي بعد تقديمي لورقة علمية تتطلب جهدا من البحث النظري، وجمع المعطيات الميدانية والقراءات المتعددة، فضلا عن تعزيز التحليلات بتمرين يومي عنوانه “قراءة في الصحف”.
كل هذا يتطلب على الأقل ستة أشهر من العمل بغية إنتاج ورقة قابلة للتحكيم والتقييم من طرف باحثين متخصصين. لكن المفارقة هو بعد تقديمك للورقة يتقدم إليك أحدهم بسؤال له دلالات تعبر عن الرغبة السريعة في التوصل إلى نتيجة عملية بهدف تحقيق نوع من “الخلاص” لأزمات الوطن العربي: ما الحل؟
هذا السؤال الذي أضحى يقدمه المواطن “المثقف” كما المواطن “العادي” وفي جميع الفضاءات، بما فيها فضاء العائلة، يمكن تفسيره بالخلط الشديد الذي يوجد لدى بعض المتتبعين، بل حتى الباحثين، بين السياسة وعلم السياسة، بين الفاعل والملاحظ، بين الممارس للفعل العمومي والدارس الذي يدرس ويحاول فهم فعل وعمل هذا الأخير وعمل المؤسسات الاجتماعية والسياسية.
ومن الطرائف أنه وفي كل مرة يأخذ فيها الباحث في العلوم الاجتماعية الكلمة ينتظر منه المستمع التصرف كما لو أن بيده الحل، ويجب عليه أن يتماشى مع انتظارات الجمهور. هذا يذكرني بما قاله عالم الاجتماع الفرنسي بيير بورديو: “إذا كان على كل كميائي أن يحذر الخميائي الذي يسكنه، فعلى كل عالم اجتماع أن يحترز من المصلح الاجتماعي الذي يسكنه والمطالب بتجسيده من طرف جمهوره”.
إن الخلط بين وظيفة الباحث في العلوم الاجتماعية وبين الفاعل العمومي والمدني، تشكل عائقا أمام تطور هذه العلوم في وطننا العربي.
هذا المزج بين علم السياسة والمصلح السياسي أو بين التحليل والموقف تعتبر، في نظري، من بين الإشكالات التي تعرفها الفضاءات الجامعية في “الوطن العربي”. إذ هناك خلط بين التحليل الموضوعي والرأي الشخصي الذاتي.
أتذكر عندما كتبت مقالا تحليليا، في مجلة شهرية، حول إمكانية العودة إلى دولة الرفاه الاجتماعي في سياق ما بعد أزمة كوفيد-19، قال لي أحدهم: “أنت تنتمي إلى اليسار”، لسبب بسيط وهو استعمالي لعبارة “دولة الرفاه الاجتماعي”.
ذات مرة قلت في إحدى الندوات المستديرة، نظمت على شكل قراءة في كتاب -قلت-:”الربيع الديمقراطي حتى لا نقول الربيع العربي”، تقدمت نحوي، في نهاية الندوة، إحدى المشاركات، وقالت بلغة يقينية: “أنت مع الحركة الأمازيغية”.
وذات يوم في محطة الحافلات بالقامرة “القديمة” بمدينة الرباط استأذنت أستاذا باحثا لكي أصلي صلاة العصر في المسجد الصغير للمحطة، وبعد عودتي من قاعة الصلاة قال لي صديقي “الباحث”: “أنت مع الإسلاميين”.
واعجباه! في ثلاثة مواقع مختلفة، وبين التعبير والسلوك، تجهز لك تصنيفات لا ترتكز على الموضوعية بقدر ما هي أحكام قيمة جاهزة، توحي بتأثير التخمين على التحليل العميق والموضوعية المطلوب توفرها في الباحث.
وفي بعض الأحيان يمكن أن تصنف أيضا من طرف بعض الفاعلين العموميين والمدنيين بناء على نتائج بحث توصلت إليها، إذ يعتقد هؤلاء بأن نتائج بحثك تمس عملهم وسياساتهم. ويعتبرون “خطابك” هو بمثابة تنقيص من عملهم أو يتقاطع مع خطاب حزب أو تيار سياسي، سبب ذلك هو عدم فهمهم بأن وظيفة الباحث ليست ممارسة السياسة بقدر ما هي محاولة لفهم وتفسير الظواهر السياسية والاجتماعية بناء على مناهج تسمى بالمناهج الكمية والكيفية للعلوم الاجتماعية، ولا يعرف هؤلاء بأن النتائج التي يتوصل إليها الباحث في بحوثه تبقى نسبية، وهي بمثابة فرضيات قابلة للنقاش والنفي عبر أبحاث أخرى، وليست أحكام أو نتائج تصنف من المسلمات.