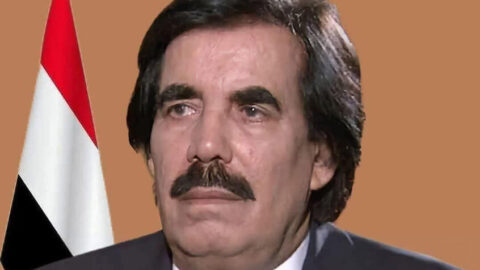الثعالب الشنّاقة!

أعادتني حالة الغلاء الفاحش وتوالي تصريحات السياسيين، “حاكمين” و”معارضين”، التي تشكو سطوة المضاربين والمحتكرين، إلى فتح بعض الكتب والمراجع العلمية لمحاولة الإمساك بخيط الأحداث، خاصة أن التاريخ علّمنا كيف كان لفئة التجار دور حيوي، ويكاد يكون حاسما، في كل ما عاشه المغرب منذ القرن التاسع عشر على الأقل.
عدت تحديدا لأبحث عن كتاب كنت قد قرأته ووظّفته في كتابة ملفات صحافية، حول النخبة الاقتصادية المغربية، وهو عبارة عن دراسة ميدانية حول الجيل الجديد من المقاولين المغاربة، أنجزها كل من الأستاذ الجامعي والرئيس السابق لمجلس المنافسة، إدريس الكراوي، وصديقه المفكّر والفيلسوف نور الدين أفاية.
بالفعل، وجدت الكتاب يذكّرني في بابه الأول بقراءاتي التاريخية، حول الدور الخاص الذي لعبته فئة التجار في حسم مصير المغرب أمام المناورات والمؤامرات الاستعمارية، وكيف كانت التجارة دائما شأنا خاصا بالسلطان الشريف، يحتكره ويشرف على ممارسته ويتقاسمه مع نخبة منتقاة بعناية وحذر شديدين، وكيف جعل المخزن أمر تشكّل الثروات ونموّها قراره الحصري، من خلال توزيع الامتيازات التجارية والأراضي، حيث كان السلطان ينعم على خدام المخزن، من شيوخ قبائل وشيوخ زوايا، بمجموعة من الأراضي سواء على شكل هبات أو حسب الأحوال والمواقف.
وذكّرني الكتاب أيضا كيف برزت في نهاية القرن التاسع عشر جدلية قوامها تحصين المواقع السياسية والإدارية بفضل الثروات، وتنمية هذه الثروات اعتمادا على تلك المواقع؛ وكيف استطاع المخزن التعامل مع الطبقة التي كانت تتكون أساسا من النخب الدينية والعلمية المؤلفة من الشرفاء وكبار الفقهاء والعلماء، ومن النخب الإدارية المشكلة من كبار موظفي المخزن كالوزراء والعمال والقواد والباشوات ومن الطبقة الأرستقراطية المهيمنة على المجال التجاري، والتي عرفت كيف تستغل قربها من السلطة السياسية لتلعب دورا مهما في الحياة الاقتصادية للمغرب…
كل ذلك لم يمنع تسلّل الخطر الاستعماري عبر تقنيات يعرفها جل الدارسين، مثل زرع بعض التجار والوكلاء الأجانب في البوابات الرئيسية للتجارة داخل ومع المغرب، عبر استغلال لحظات ضعف وانهزام المغرب كما كان الحال في إيسلي وتطوان، وظهور فئة المحميين من التجار المغاربة…
وكما لو أن المصادفات تلعب دورها حتى في قراءاتنا، وجدتني وأنا أقرأ فقرة من الكتاب تحيل على نظرية عالم الاجتماع والاقتصاد الإيطالي الشهير، فيلفريد باريطو، أصادف حلقة “بودكاست” غنية ومبسّطة، هي الرابعة ضمن حلقات بودكاست جديد يقدّمه رشيد العشعاشي، وحاول من خلالها تفسير دينامية النخب، وكيف يتقاطع تطوّرها الطبيعي والصحي، أي تجديد دمائها وجعلها تستجيب لتطلعات المجتمع، مع مقتضيات الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير، ومن ثم كشفه أهمية دور “النخبة المعادية” التي يمثلها الصحافيون والمثقفون، والتي تلعب دور “الحَكم” بين النخبتين الحاكمة والمعارضة.
وجدت اختيار العشعاشي موفقا للغاية، وهو يعود إلى نظرية باريتو لتفكيك وفهم ما يجري لنا حاليا، ذلك أن عالم الاجتماع الإيطالي قدّم واحدة من أشهر النظريات في دراسة النخب وتداولها، حيث استخدم مفهومي “الثعالب” و”الأسود” لتفسير كيفية تشكل النخب الحاكمة وكيفية انتقال السلطة بينها.
يرى باريتو أن المجتمعات ليست ديمقراطية في جوهرها، وأن السلطة والنفوذ محصوران دائما في يد أقلية مسيطرة تتحكم في باقي المجتمع.
لكنه يؤكد أن هذه النخبة ليست ثابتة، بل تتغير عبر عملية مستمرة من تداول النخب، حيث يتم استبدال نخب بأخرى أكثر قدرة على التكيف مع الظروف الجديدة.
ويُقسّم باريتو النخب إلى فئتين رئيسيتين، بناء على أنماط تفكيرها واستراتيجياتها في الحكم: فئة النخب “الثعالب”، وفئة النخب “الأسود”.
يمثّل “الثعالب” النخب الذكية، والماكرة، والمراوغة، والذين يعتمدون على المناورة، والدبلوماسية، والخداع السياسي أكثر من القوة المباشرة. وهم غالبا ما يكونون إصلاحيين، يميلون إلى التكنوقراطية، أو رجال أعمال، ويعتمدون على المؤسسات والقوانين بدل القوة الغاشمة.
وبينما يكون دور “الثعالب” سلبيا في مراحل الانحطاط والانغلاق، فإنهم يلعبون أدوار إيجابية في فترات الازدهار والتغيير، حيث تكون الحاجة ملحة للحلول المبتكرة والتسويات السياسية.
أما “الأسود” فيمثلون النخب المحافظة، والقوية، والصارمة. ويعتمدون على القوة، والعنف، والسلطة، بدل المفاوضات والمراوغة. وغالبا ما يكونون قادة عسكريين وأمنيين، ورجال دين، أو زعماء تقليديين، ويفضلون السيطرة المباشرة على المجتمع بدل النقاش والتفاوض.
بدورهم، تكون مساهمة “الأسود” إيجابية في لحظات الازدهار والتطوّر، حيث يحافظون على الاستقرار ويمنعون الفوضى ويحمون الوطن من التهديد الخارجي، فيما ينقلب دورهم إلى السلبية في فترات الأزمات والصراعات، حيث تكون الحاجة ماسة إلى الحزم والاستقرار، وهم دائما في خدمة “الثعالب” الماسكين بزمام السياسة والاقتصاد.
في الظروف العادية، تُسيطر “الثعالب” على الحكم، حيث تُدار الأمور بالدبلوماسية والتسويات السياسية. ومع مرور الوقت، يضعف حكم “الثعالب” بسبب فسادهم أو ميلهم للمراوغة الزائدة، مما يؤدي إلى أزمة ثقة.
وعند حدوث أزمة كبيرة، يصعد “الأسود” إلى السلطة، عبر الانقلابات العسكرية أو الثورات، حيث يفرضون سيطرتهم بالقوة. لكن بمجرد أن تستقر الأوضاع، يعود “الثعالب” مجددا إلى المشهد، لأن المجتمع لا يمكن أن يبقى في حالة صدام دائم مع الوجه الخشن للسلطة، ويحتاج إلى سياسات أكثر ذكاء وتكيفا. وهكذا تستمر عملية تداول النخب بشكل دوري بين “الثعالب” و”الأسود”، في دورة لا تنتهي.
الجميل في نظرية باريتو هذه، أنها تُبعدك عن ثنائية الخير والشر، وتقرّبك من فهم أكثر واقعية لكيفية تطوّر السلطة داخل المجتمعات الحديثة. وأنا شخصيا أجدني أقرب إلى فهم وتفسير ما يجري في حقل السياسة بالاستناد إلى ديناميات وتحولات النخبة أكثر من المقاربات الأخرى التي تعتمد التفسير الطبقي وديناميات المجتمع.
وتقدّم الحالة المغربية دليلا على صحة هذا الاختيار، لأن أدوار النخب كانت حاسمة، سواء في إضعاف وسقوط المغرب في الاستعمار، أو في طريقة أنهاء هذا الأخير، حيث كانت مقاربة النخبة الوطنية أكثر قدرة على التأثير من ديناميات المقاومة الأخرى التي أفرزها المجتمع.
ما نعيشه اليوم إذن لا يمكن أن يفسّر خارج انحراف سلوك فئة من “الثعالب”، وجنوحهم إلى الافتراس والأكل بنهم شديد. وسلوك “الأسود” في هكذا سياق يصبح نتيجة طبيعية وتلقائية، لأنهم حسب صاحب النظرية، قد لا يكونون متفقين مع انحراف الثعالب هذا، لكنهم يعتبرون أنفسهم مطالبين باستعمال البطش والقوة لحفظ ما يرونه استقرارا.
وبالعودة إلى بعض خلاصات الدراسة التي أنجزها الكراوي وأفاية، والتي شملت 100 مقاول ومقاولة ممن يعتبرون نخبا اقتصادية شابة وصاعدة في لحظة إنجاز الدراسة (قبيل انطلاق ثورات الربيع العربي)، وبالتالي يمكننا القيام بإسقاط يجعل هذه النخب الاقتصادية المشمولة بالدراسة هي الفئة المسيطرة حاليا على الحقل الاقتصادي؛ فإننا سنجد بعض عناصر الفهم والتفسير.
فأكثر من 86 في المئة من أعضاء هذه النخبة الاقتصادية الجديدة التي طوّرها المغرب في هذا الربع الأول من القرن 21، قالوا إنهم لا يحملون أي التزام سياسي. وبرّروا ذلك بعدم اقتناعهم بفائدة الانخراط في الميدان السياسي، وقلة اهتمامهم بالشؤون السياسية، أن الأحزاب السياسية تتسم بغياب الديمقراطية وضياع المصداقية…
بل إن كبيرهم وممثّلهم الأول اليوم، أي رئيس الحكومة وصاحب إحدى أكبر المجموعات الاقتصادية في المغرب، عزيز أخنوش، والذي كان من بين المقاولين الذين شملتهم الدراسة، قال للباحثَين إن المرء لا يحتاج إلى الاعتماد على السلطة السياسية كي ينجح في تسيير مقاولته، و”كلّما ابتعدت المقاولة عن السياسة ازداد تركيزها على مهامها”.
ورغم أن الدراسة عادت لتقول إن المقاولين الصاعدين يحملون حسا وطنيا عاليا بدليل انخراطهم في أنشطة جمعوية ومدنية عديدة، إلا أن أجوبة هؤلاء المقاولين تضمنت بعضا من عناوين العطب الذي رافق تشكيل هذه النخبة الاقتصادية، حين أكدوا بأغلبية واضحة، هيمنة منطق الريع والامتيازات غير المشروعة في الاقتصاد المغربي، وقالوا إن الرشوة عائق أساسي أمام تطوّر المقاولة.
من هنا يمكننا أن نعثر على بداية فهم مقنع لما انتهينا إليه حاليا من شعور جماعي بالسقوط تحت سطوة ثعالب تفترس بدون رحمة، وتلهب الأسواق وتستنزف الخيرات.
فالمقاولون الذين لم يكن لديهم أي شغف أو اهتمام بالسياسة، ويعرفون جيدا أن الريع والرشوة هما الأساسان اللذان يقوم عليهما قانون السوق المغربية، باتوا فجأة مدعوين لتصدّر المشهد السياسي، والإمساك بزمام الأمور التدبيرية، وهو ما أفرز لنا مؤسسات منتخبة تنخرها المتابعات والمحاكمات القضائية، يتقدّمها البرلمان، و”شنّاقة” يستبدون بالأسواق ويفرضون جشعهم على الجميع.
حفظنا الله من الثعالب الجائعة.. وتحية للأسود!