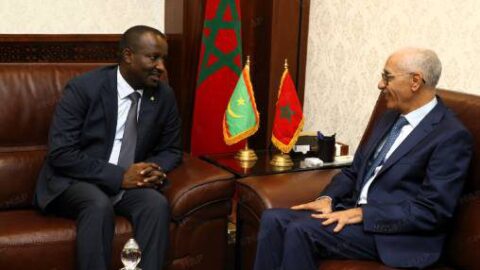الترابي: هناك تحولات في تدين المغاربة لكنها ليست دليلًا على ضعف إمارة المؤمنين

س: كيف ترى الدور الذي يلعبه الإعلام، بنوعيه التقليدي والرقمي، في تضخيم أو تهميش قضايا مرتبطة بإمارة المؤمنين مثل مدونة الأسرة أو الخلافات داخل الزوايا؟ هل نحن أمام إعلام يصنع أجندة أم مجرد مرآة تعكس المزاج المجتمعي؟
ج: الإعلام، بنوعيه التقليدي والرقمي، يسير على “البيض” عندما يتعلق الأمر بالقضايا الدينية أو تلك المرتبطة بـ “حقل إمارة المؤمنين”. هذا الحذر نابع من الدور المركزي الذي تلعبه المؤسسة الملكية في هذا المجال، إضافة إلى الحساسية المفرطة لدى المجتمع تجاه ما يعتبره مقدسًا وغير قابل للنقاش.
صحيح أن الإعلام التقليدي والرقمي في قضايا مثل مدونة الأسرة وخلافات الزوايا هو مرآة تعكس الواقع بانقساماته الفكرية والأيديولوجية، لكنه بدأ في التراجع تاركًا المجال لمنصات التواصل الاجتماعي لتصبح هي الحلبة الافتراضية الرئيسية للنقاش.
هذه المنصات تعكس الانقسامات وموازين القوى، وترسم عبر تفاعلاتها الخطوط الحمراء للنقاش في هذا الموضوع أو ذاك، متجاوزة بذلك النقاشات التقليدية بين الفاعلين الحقوقيين والسياسيين.
لجدل الذي أثير حول بعض بنود مشروع قانون الأسرة على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي تحوّل إلى عنف لفظي ورمزي وتزييف للأخبار، خلق نوعًا من الصدمة لدى بعض الفاعلين الرسميين، وهو ما قد يفسر تأخر التداول التشريعي في هذا الموضوع.
منصات التواصل الاجتماعي تمنح الأفراد والمجموعات حرية أكبر في التعبير عن آرائهم، وبشراسة أكبر عندما يتعلق الأمر بالشؤون الدينية، مما أدى إلى ظهور صراعات كانت في السابق محصورة في الأوساط النخبوية أو الأكاديمية والفقهية، بل وصادرتها منها.
س: تكشف قضايا مثل قضية ابتسام لشكر وما يرافق أزمة الزاوية البوتشيشية عن تباين حاد في تمثلات الدين داخل المجتمع المغربي. هل يعكس هذا التباين ضعف قدرة إمارة المؤمنين على الاستيعاب والتأطير، أم أن التعددية الدينية والاجتماعية أصبحت أكبر من أن تُضبط من خلال نفس الآليات التقليدية؟
ج: هذه القضايا تكشف عن تحولات في التدين لدى المغاربة، ولكنها ليست دليلًا على ضعف إمارة المؤمنين. بل هي مؤشر على أن التعددية الدينية والاجتماعية في المجتمع المغربي أصبحت أكبر وأكثر تعقيدًا من أن تُضبط بالآليات التقليدية وحدها.
إن مؤسسة إمارة المؤمنين، كأداة لضبط الشأن الديني وتقنينه، وخاصة بعد دستور 2011، تظل مرتبطة بـ موازين القوى المجتمعية وتسير بإيقاعها. وظهور تيارات فكرية جديدة، وتأثير منصات التواصل الاجتماعي، والتغيرات الثقافية والقيمية العميقة، أدى إلى بروز أصوات لم تكن مسموعة من قبل، ونقاشات لم يكن المغاربة معتادين عليها.
نحن أمام صراع داخلي في المجتمع بين أجيال وتوجهات مختلفة لها تصورات متباينة للدين والهوية. تحاول إمارة المؤمنين أحيانًا استباق هذا الصراع وأحيانًا أخرى مواكبته.
هناك أيضًا أشكال تقليدية للتدين في طور التفكك والضمور، مثل التدين الصوفي أو “الطرقي”، وهو ما يكشف عنه النقاش حول الزاوية البوتشيشية حاليًا وعدم فهم الرأي العام لما يدور داخلها، بل وحتى للغة المستخدمة بين الأطراف المتنازعة في هذه القضية.
س: من خلال متابعتكم كباحث وإعلامي، هل تعتبرون أن النقاشات المثارة حول الحريات الفردية والمواضيع الدينية، تعبيرا عن صراع بين الدولة والمجتمع، أم أن الأمر يتعلق بصراع داخل المجتمع نفسه تُستثمره الدولة لإعادة إنتاج توازناتها؟
ج: النقاشات حول الحريات الفردية هي في الواقع صراع داخل المجتمع نفسه، وهي نتيجة لتحولات عميقة لم يتم دراستها بشكل كافٍ. منذ بداية الألفينيات، هناك حديث عما يُسمى “صراع القيم”، أي تدافع مجتمعي بين تيارات ليبرالية وحداثية تدافع عن الحريات الفردية كمدخل رئيسي لتقدم البلاد، وتيارات أخرى محافظة، يمثلها التيار الإسلامي، وتتمسك بما تراه هوية ثابتة وراسخة.
الدولة، والملكية تحديدًا، تلعب دور “الحكم” لضبط التوازنات ومنع هيمنة تيار على آخر، خشية وقوع ردود فعل متشنجة تهدد النظام العام واستقرار المجتمع. هكذا، تتخذ الدولة أحيانًا قرارات تدعم التوجه الليبرالي (مثل التعديلات على مدونة الأسرة)، وأحيانًا أخرى تحافظ على الوضع القائم في قضايا معينة استجابةً للرأي العام المحافظ.
هذا الدور يظهر بوضوح في كيفية تعاملها مع النقاشات حول الإفطار العلني أو العلاقات الرضائية. الدولة هنا ليست طرفًا ثابتًا، بل هي لاعب ديناميكي يسعى للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي من خلال إدارة هذا الصراع الداخلي.
*هذا الحوار، هو جزء من ملف العدد 76 لمجلة “لسان المغرب”، لقراءة الملف كاملا، يرجى الضغط على الرابط