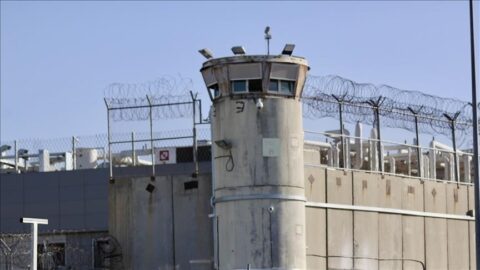اختيار قائد الحزب.. شأن داخلي أم قضية رأي عام؟

كثيرا ما يواجه أعضاء الأحزاب السياسية أي انتقاد أو نقاش يخص طريقة اختيار قائد حزبهم أو على الأًصح أمينه العام، بالقول إن الأمر شأن داخلي يقتصر على مناضلي الحزب وأجهزته، ولا يحق لأي طرف خارجي التدخل فيه وإبداء الرأي بشأنه. بيد أن هذا التبرير وإن كان في ظاهره يبدو مقنعا فإنه في الحقيقة يتجاهل بعدا أساسيا في طبيعة العمل الحزبي، حيث الأحزاب السياسية ليست مجرد تجمعات مغلقة أو نوادي تنظيمية محدودة الأفق، بل يفترض فيها أنها مؤسسات فاعلة في صياغة مجريات الحياة السياسية وإدارة الشأن العام وتوجيه النقاش العمومي، وبالتالي فإن طريقة اختيار قياداتها، وعلى رأسها الأمين العام، لا يمكن عزلها عن تأثيرها المباشر على العملية الديمقراطية وثقة المواطنين في المؤسسات السياسية والدستورية.
لذلك، فرغم أن التساؤل حول ما إذا كان اختيار الأمين العام للحزب هو مجرد شأن داخلي أم قضية رأي عام قد يبدو ذا طابع تنظيمي بحت، فإنه ينطوي في جوهرة على رهانات سياسية وأخلاقية عميقة تمس صلب العمل الحزبي ودوره في ترسيخ الممارسة الديمقراطية. فالأمين العام لأي حزب سياسي ليس مجرد مسؤول تنظيمي يشرف على الاجتماعات أو يصدر البلاغات، بل يفترض فيه أنه واجهة سياسية وفكرية تمثل الحزب السياسي أمام الرأي العام، وتجسد خطه السياسي ومشروعه المجتمعي، حتى وإن كان هذا المشروع يبدو في كثير من الحالات ضبابيا أو غير مكتمل الملامح. وبالتالي، فإن صورته، وطريقة اختياره، وشرعيته، كلها عناصر تؤثر في الانطباع العام عن الحزب، وقد تحدد حجم الثقة أو الشك الذي يحظى به في المجتمع ولدى الراي العام والناخبين على حد سواء. ومن هنا، يصبح من الواضح أن مسألة اختياره ليست أمرا داخليا محضا، وإنما شأنا عاما ينعكس على البيئة السياسية الحاضنة للحزب برمتها.
ثم إن الحزب السياسي في النظام القانوني المغربي ليس جمعية تطوعية أو خيرية أو شركة خاصة تخضع لمبدأ “من يملك يقرر” ويحدد مصيرها المساهمون والشركاء. فهو، وفق الفصل السابع من الدستور، هيئة منظمة غايتها “تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام”، والمساهمة “في التعبير عن إرادة الناخبين، والمشاركة في ممارسة السلطة، على أساس التعددية والتناوب، بالوسائل الديمقراطية، وفي نطاق المؤسسات الدستورية”. وهذه الغاية ذات طبيعة عامة تجعل الحزب السياسي جزء لا يتجزأ من البنية المؤسسية للديمقراطية، ومن ثم تخضع قياداته، بما فيها الأمين العام، لمقتضيات الشفافية والمساءلة، حتى لو جاءت القوانين الداخلية للحزب مصاغة بكيفية تخدم بقاء القيادة مدى الحياة.
من بين العوامل الأخرى التي تجعل اختيار الأمين العام تتجاوز كونها قضية داخلية فقط، مسألة التمويل. فالأحزاب السياسية المغربية تتلقى قسطا مهما من ميزانياتها من خزينة الدولة الممولة من ضرائب المواطنين، بل إن هذا التمويل العمومي هو الذي يؤمن لها إمكانية البقاء على قيد الحياة في ظل التراجع إن لم نقل الغياب التام لاشتراكات الأعضاء. وهو الأمر الذي يفرض عليها الالتزام بمعايير النزاهة والشفافية في جميع مستويات عملها، بما فيها انتخاب القيادة وتزكية المرشحين باسمها في مختلف الاستحقاقات الانتخابية. إذ من غير المعقول أن تدار موارد عامة بمنطق “شأن داخلي” لا يخضع لرقابة أو مساءلة إلا من طرف دائرة ضيقة من المناضلين. كما من غير المعقول أن تدار الأحزاب السياسية بأموال دافعي الضرائب ولا يكن لهؤلاء رأي في ما يجري ويدور داخلها.
إضافة إلى ذلك، يمنح النظام الدستوري المغربي موقعا محوريا للأمين العام للحزب، إذ يمكن أن يصبح هو رئيس الحكومة، ما دام الدستور ينص على تعيين هذا الأخير من الحزب السياسي المتصدر لنتائج انتخابات مجلس النواب. فرغم ألا شيء في الدستور يلزم الملك بتعيين الأمين العام للحزب في هذا المنصب، فهذا هو ما تكرس في واقع الممارسة. فعندما تصدر حزب العدالة والتنمية نتائج انتخابات 2011 سارعت أمانته العامة إلى إصدار بلاغ غير مسبوق تشير من خلاله إلى أن الأمين العام للحزب هو المرشح الطبيعي لهذا المنصب. وحتى عندما لجأ الملك في مارس 2017 في ظل ما عرف بـ “البلوكاج السياسي” إلى تعيين “شخصية أخرى” من حزب العدالة والتنمية رئيسا للحكومة، فقد أًصبح الدكتور سعد الدين العثماني، انطلاقا من موقعه كرئيس للحكومة، هو الأمين العام الجديد للحزب.
في الماضي، ظلت الحياة السياسية المغربية أسيرة لفكرة “القائد الضرورة”، حيث كان الموت هو العامل المحدد في تغيير القيادة الحزبية. ومع بداية الألفية الثالثة، شهدت الحياة الحزبية انفتاحا نسبيا إذ أُصبح التنافس ممكنا بين أكثر من مرشح، عندما نستحضر ما حدث وقتها داخل حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بين أحمد بنجلون وعبد الرحمان بنعمرو وحزب التجمع الوطني للأحرار بين مصطفى عكاشة ومصطفى المنصوري، بل إن هذه المنافسة وصلت في حالة الاتحاد الاشتراكي إلى حد تنظيم مناظرة تلفزيونية بين أربعة مرشحين، ما أعطى الانطباع بوجود تحول نحو الممارسة الديمقراطية الداخلية. غير أن هذه التجربة سرعان ما أخذت تتراجع، حيث عادت الأساليب القديمة إلى الواجهة من جديد في أكثر من تنظيم سياسي، وعاد معها انتخاب الأمين العام ليفرض نفسه باعتباره أشبه باستفتاء شكلي.
والمفارقة أن ذلك حدث واشتد في ظل دستور أصبح ينص صراحة على ضرورة احترام المبادئ الديمقراطية داخل الأحزاب السياسية، وقانون تنظيمي منبثق عنه أضحى يلزمها باعتماد أساليب تسيير ديمقراطية وآليات شفافة، وأيضا في ظل ممارسة قضائية أخذت تنتج أحكاما ترفض التصريح بتأسيس حزب سياسي بداع أن مشروع نظامه السياسي لا يتضمن بيانات تستمد جوهريتها من الأسس التي تتضمن تسيير الأحزاب السياسية في تلاءم مع مبادئ الديمقراطية التي من روافدها ضمان التناوب في ممارسة المسؤوليات داخل أجهزة الحزب وتجديد النخب فيه (أنظر حكم المحكمة الإدارية بالرباط في قضية تأسيس حزب التجديد والتقدم الصادر بتاريخ 20/2/2025).
وعليه، فإن التذرع بفكرة أن اختيار الأمين العام شأن داخلي، وبالتالي من حق المناضلين تعديل القوانين الداخلية لتخليده في القيادة، أقل ما يقال عنه إنه “كلام حق يراد بها باطل”. صحيح أن القوانين الأساسية والداخلية للأحزاب السياسية تحدد آليات انتخاب أجهزتها وهياكلها، وأن قواعد الممارسة الحزبية تمنح الأعضاء سلطة التصويت، وأن من يقرر في النهاية هم هؤلاء الأعضاء، لكن حصر المسألة في هذا الإطار دون الانتباه لما قد يخلفه ذلك القرار من انطباعات سلبية لدى الرأي العام، يختزل البعد الوطني لوظائف وأداور الأحزاب السياسية، ويغفل أن الديمقراطية الحزبية ليست هدفا في ذاتها، بل وسيلة لضمان ديمقراطية النظام السياسي والمجتمع ككل.
لذلك، فإن اختزال المسألة في بعدها الإجرائي ـ أي منح المناضلين حق التصويت حتى لو أفضى الأمر إلى إعادة انتخاب نفس الشخص لعقود ـ يحول جوهر الممارسة الديمقراطية إلى مجرد وعاء فارغ من المحتوى. فالديمقراطية الداخلية لا تعني فقط السماح بالتصويت، بل تقتضي إتاحة كل الفرص الممكنة لمنافسة حقيقية، وضمان إمكانية التداول على القيادة، وبناء الشرعية على الكفاءة والمشروع السياسي، لا على الولاءات الشخصية أو التحكم في الأجهزة.
وعليه، فإن الإصرار على تصوير اختيار الأمين العام للحزب، أو الكاتب الأول بحسب اختلاف التسميات المتداولة من حزب لآخر، كقضية داخلية محضة، هو في الواقع محاولة لإخفاء بعد أساسي في كل نظام ديمقراطي، وهو أن الأحزاب السياسية أدوات لخدمة الشأن العام وليست ملكية خاصة أو ضيعة شخصية يتوارثها الزعماء. فالديمقراطية، سواء داخل الحزب السياسي أو في مؤسسات الدولة، تقوم على مبدأ التداول، وعلى الاعتراف بأن السلطة ليست غاية في ذاتها، بل وسيلة لخدمة الصالح العام. وعندما يغيب هذا المبدأ، تتحول الحياة الحزبية إلى مسرح مغلق يعيد إنتاج نفس الوجوه ونفس الأساليب، ويوصد الأبواب في وجه “الهواء النقي” القادم من الرأي العام، مما يضعف الثقة في السياسة ويعزز عزوف المواطنين.
على هذا الأساس، يصبح من المشروع القول إن الاحتماء بمقولة “الحياة الخاصة” للأحزاب السياسية لا يمكن قراءته إلا كمحاولة لإعادة إنتاج أنماط التسيير التقليدية التي كان من المفترض أن يؤدي التطور الدستوري والقانوني والسياسي إلى تجاوزها. ومن ثم، فإن الرهان الحقيقي أمام الأحزاب السياسية هو إدراك أن قوتها وشرعيتها لا تستمد فقط من عدد المقاعد التي تحوزها أو من حجم مواردها المالية، بل من قدرتها على تجديد نخبها وإفساح المجال أمام قيادات جديدة تجسد تطلعات المجتمع وتعيد بناء جسور الثقة المقطوعة بين السياسة والمواطن. وعندما ينظر إلى منصب الأمين العام باعتباره منصبا وطنيا بمعناه السياسي، لا مجرد موقع تنظيمي داخلي، يصبح من الطبيعي أن يخضع مسار اختياره لمعايير الشفافية والشرعية الديمقراطية، وأن تتحمل الأحزاب السياسية مسؤوليتها أمام عموم المواطنين، لا أمام أعضائها ومؤيديها فقط.