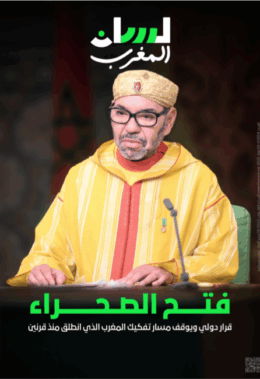وهم التحالفات والأمن المستعار.. كيف سيُبنى الأمن العربي والإسلامي في عالم ما بعد المظلة الأمريكية؟

ظلت شبكة التحالفات التي نسجها العرب والمسلمون مرآة صافية تعكس وضعهم الحضاري والسياسي عبر التاريخ. ففي عصور القوة والازدهار، غدت قبلة للحلفاء والساعين إلى الاستظلال بظلها أو الانخراط في نفوذها المتسع. وفي لحظات التراجع والانقسام صارت في موقع المستجدي للتحالف الخارجي، بحثا عن حماية أو سند يعوض فراغ القوة الذاتية. ومنه أثبتت التجربة التاريخية أن مفهوم “الحليف” لم يكن يوما ثابتا أو مطلقا، بل ظل متحركا يتشكل تبعا لتحولات موازين القوى، صعودا أو انكفاء. فكان التحالف تعبيرا عن قوة مركزية جاذبة في لحظة ازدهار الحضارة الإسلامية، بينما أصبح ضرورة يفرضها واقع الانكشاف الاستراتيجي في عصور التشرذم أو الاحتلال.
واليوم، حين نعيد قراءة هذا الإرث في ضوء تحولات الحاضر، ندرك أن التحالف لم يكن خيارا عاطفيا أو أخلاقيا، بل أداة جيواستراتيجية خاضعة لمعادلات المصالح والتهديدات. وهكذا ظلت مسيرة العرب والمسلمين تتأرجح بين لحظات قوة وهيمنة جعلتهم مركز ثقل في النظام الدولي، وبين فترات ضعف وانكماش أفقدتهم القدرة على المبادرة. ومع مجيء حقبة الاحتلال والاستعمار الحديث، تهاوى ما تبقى من عناصر القوة الذاتية، ليتحول الاستقلال السياسي لاحقا إلى استقلال منقوص، عنوانه العجز عن بناء وحدة داخلية أو صياغة جبهة مشتركة في مواجهة التهديدات الخارجية. بل إن الانقسامات البينية سرعان ما تحولت إلى صراعات ومؤامرات متبادلة عمقت الشرخ الاستراتيجي.
والمفارقة الكبرى أن اللحظة الوحيدة التي بدا فيها شبه إجماع عربي–إسلامي على مواجهة قوة خارجية، تجلت في الحرب الأفغانية ضد الاتحاد السوفيتي، غير أن هذا الإجماع جرى تحت الرعاية المباشرة للولايات المتحدة، وبأدوات واستراتيجيات صُممت في مكاتبها. لكن التجربة لم تلبث أن كشفت عن دروسها القاسية؛ إذ تحوّل “النصر” على موسكو إلى مدخل لأكبر عملية إعادة اختراق أمريكي للمنطقة.
فمع انقضاء الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفيتي، دخلت المنطقة طورا أكثر تشظيا وتعقيدا. فقد جاء غزو العراق للكويت كمنعطف تاريخي حاسم، لتجد دول الخليج نفسها أمام سباق محموم لعقد اتفاقيات دفاعية ثنائية مع الولايات المتحدة، بحثا عن مظلة أمنية تضمن لها الحماية من أي تهديد محتمل. غير أن هذه المظلة لم تكن سوى بداية مسار من الارتهان الاستراتيجي، تجلى في اتفاقيات غير متكافئة فرضت تبعية سياسية وأمنية، وتوازى مع مسارات تسوية سياسية –أوسلو ووادي عربة– انتهت بتنازلات استراتيجية عميقة.
وبعد أحداث 11 سبتمبر 2001، اندفعت دول عربية وإسلامية إلى الانخراط في ما سُمّي بـ”الحرب على الإرهاب”، معتقدة أن مسايرتها لأولويات واشنطن ستؤمن لها مظلة أمان. ففتحت القواعد العسكرية، وقدمت التسهيلات اللوجستية والاستخباراتية، بل وأعادت صياغة سياساتها الداخلية والخارجية على مقاس الاستراتيجية الأمريكية. ومع ذلك، لم يكن الحصاد سوى انكشاف أمني غير مسبوق. فقد راهنت هذه الدول على أن تبنيها خطاب واشنطن، أو ابتعادها عن موقع “محور الشر” بتعبير جورج بوش الابن بعد غزو أفغانستان ثم العراق، سيمنحها ضمانات صلبة للأمن والاستقرار.
لقد كشف الواقع أن ما اعتبرته دول الخليج لعقود “مظلة حماية” لم يكن سوى شبكة ارتهان جديدة عمقت التبعية وأضعفت ركائز الأمن الوطني والإقليمي، لتبلغ ذروتها مع الضربة الإسرائيلية على الدوحة التي تحولت إلى زلزال استراتيجي أعاد رسم الأسس التقليدية للأمن الخليجي. فلم تكن مجرد حادث عسكري عابر كما اعتادت المنطقة مع لبنان أو سوريا أو حتى إيران، بل لحظة سقوط القناع عن “المظلة الأمنية” الأمريكية، التي تبين أنها ليست ضمانة وجودية بقدر ما هي أداة براغماتية متقلبة، حاضرة حين تخدم مصالح واشنطن، وغائبة عند لحظة الاختبار. وهكذا برز إلى السطح ما كان خافيا من أن العلاقة مع الولايات المتحدة لم تبن يوما على شراكة متكافئة، بل على معادلة تبعية تدار بأدوات استعمارية جديدة، جعلت من الخليج خزان موارد وسوق سلاح أكثر منه فضاء لشركاء استراتيجيين. وزادت تحولات سوق الطاقة من تعميق هذا الانكشاف، فمع تحول أمريكا إلى أكبر مصدر للغاز والنفط عالميا تراجعت حاجتها الاستراتيجية إلى الخليج، وأعيد ترتيب أولوياتها بعيدا عن المنطقة، ليكتشف الخليجيون أن المظلة التي ارتهنوا لها لعقود لم تكن سوى سراب سياسي.
لم يعد جوهر الردع في العصر الحديث مرهونا بامتلاك القدرة على خوض حرب شاملة، بل بامتلاك ما يكفي من عناصر القوة لرفع كلفة أي عدوان محتمل إلى مستوى يردع الخصم قبل أن يطلق رصاصته الأولى. هنا يبرز النموذج الباكستاني كدرس عملي بالغ الدلالة. دولة وُوجهت بتهديد وجودي من جار أكبر، فاختارت بناء منظومة ردعية مستقلة لا تقتصر على النووي، بل تشمل الصواريخ والطائرات المسيرة وتقنيات الحرب الإلكترونية، بما منحها استقلالية القرار وأدوات موازنة القوة. هذا المنطق ذاته يجد صداه اليوم في التحولات الدولية، حيث جاء الموقف الصيني الأخير – بإعلان وزير الدفاع استعداد جيش بلاده للتعاون مع جيوش الدول الأخرى للحفاظ على السلام العالمي – ليشكل منعطفا تاريخيا غير مسبوق في تقاليد بكين الممتدة لقرون، ويضيف بعدا عالميا جديدا لمعركة إعادة صياغة معادلات الضمان الأمني في الشرق الأوسط، في وقت يتراجع فيه الاعتماد على المظلّة الأمريكية وتتسارع ديناميات التعددية القطبية.
في ذات السياق أعلنت تركيا، مباشرة بعد الحرب الإسرائيلية–الإيرانية في يونيو 2025 وما خلفته من ارتدادات عميقة على معادلة الأمن الإقليمي، عن سلسلة خطوات عسكرية استراتيجية (خارج منظومة الناتو) شملت الصواريخ بعيدة المدى ومنظومات الدفاع الجوي والملاجئ المحصنة ووشبكات اتصالات مستقلة، في رسالة واضحة بأنها دخلت سباق الردع كفاعل مركزي سيعيد موازين القوى في الشرق الأوسط. ولم تقتصر التحولات على تركيا، فقد جاء الإعلان السعودي–الباكستاني عن اتفاقية دفاع مشترك، تنص على أن أي اعتداء على أحد البلدين يعد اعتداء على كليهما، ليشكل لحظة فارقة في بلورة محور ردع إسلامي عملي، تعزز أكثر مع استئناف مناورات “بحر الصداقة” بين تركيا ومصر بعد انقطاع دام 13 عاما.
هكذا يتبدى المشهد الجديد، من ارتهان خليجي طويل لواشنطن، إلى سباق متسارع لبناء معادلات ردع مستقلة تستند إلى شراكات إسلامية–إقليمية، وتستحضر في الوقت ذاته أدوار قوى دولية منافسة للولايات المتحدة. إنه تحوّل بنيوي يشي بأن الشرق الأوسط يقف على عتبة إعادة هندسة أمنية قد ترسم مسارات العقود المقبلة، حيث دخلت المنطقة مرحلة انتقالية حساسة أعادت طرح سؤال: كيف يُبنى الأمن العربي والإسلامي في عالم ما بعد المظلة الأمريكية؟