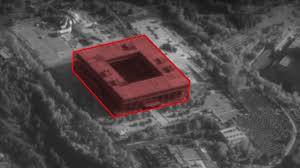“موتور” أخنوش

لم يكن أحد يتوقع أن يتحول جهاز صغير لقياس سرعة الدراجات النارية إلى شرارة جدل وطني، يضع الحكومة في قلب عاصفة سياسية واجتماعية.
فبمجرد ما أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية عن شروعها في تفعيل مسطرة قانونية معلومة وواضحة، تقضي باعتبار كل دراجة تتجاوز سرعتها القصوى 58 كيلومترا في الساعة «معدلة» وتخضع للحجز، انفجر النقاش وتحوّل إلى ترند يكتسح المنصات.
بين لحظة وأخرى وجد وزير النقل عبد الصمد قيوح نفسه في موقع دفاعي، قبل أن يتدخل رئيس الحكومة عزيز أخنوش ليطالب بمهلة للتأجيل والمراجعة.
هكذا ظهر الارتباك، وتكشّفت مرة أخرى هشاشة العلاقة بين التدبير التقني الذي تراهن عليه الحكومة وبين الانتظارات الحقيقية للمجتمع.
ولم يعد الموضوع محصورا في تفاصيل تقنية مرتبطة بمراقبة السرعة أو توزيع الخوذ، بل صار سؤالا سياسيا بامتياز: هل نحن أمام سياسة عمومية تشتغل بعقلانية ميدانية، أم أمام قرار تقني منزوع من سياقه الاجتماعي لا يزيد سوى في توسيع هوة الثقة؟
الحقيقة أن الأرقام الصادمة التي تسجّلها هذه المركبات في إحصائيات ضحايا الطرق صادمة. فمنذ سنوات، تحولت الدراجات بمحرك إلى معضلة حقيقية تشغل الدولة والمجتمع معا، ليس فقط لأنها تحصد أرواح مئات الشبان سنويا، بل لأنها تكشف في عمقها عن ثغرات أوسع في التخطيط العمومي، وعن سوق سوداء موازية تعيد إنتاج الخطر رغم كل الجهود الرسمية.
ولعل الضجة الأخيرة حول مراقبة السرعة القصوى لهذه الدراجات ليست سوى حلقة جديدة في مسلسل طويل بدأ قبل أعوام، وما يزال يبحث عن حل متوازن وواقعي.
لم يبدأ النقاش حول مراقبة سرعة الدراجات النارية، ولا معضلة هذه الوسيلة في شوارع المغرب هذا الأسبوع كما يعتقد الكثيرون؛ بل هو مسار طويل تعود بداياته إلى لحظة إدراك الدولة أن مستعملي الدراجات بمحرك يشكلون الفئة الأكثر هشاشة في حوادث السير، حيث تشير الأرقام الرسمية إلى أن أزيد من 1400 مغربي قضوا في حوادث مرتبطة بالدراجات سنة 2022 وحدها، أي ما يناهز 40 في المائة من مجموع قتلى الطرق.
أمام هذه المأساة الدامية، انطلقت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، تحت إشراف وزارة النقل واللوجستيك، في بلورة برنامج خاص بالدراجات ثنائية وثلاثية العجلات، أُطلق عليه “الدراجة الآمنة”، رسميا في فبراير 2024 بعاصمة الدراجات بمحرك، مراكش، وفي عهد الوزير السابق محمد عبد الجليل، بمشاركة كل الفاعلين الأمنيين والمؤسساتيين.
لم تكن الخطة مجرد حملة تواصلية، بل تضمنت أدوات عملية: من توزيع الخوذات الواقية في إطار شراكات مع الفاعلين في التأمين، إلى إطلاق وحدات متنقلة لمراقبة المخالفات، مرورا بتشديد الرقابة على خصائص الدراجات المعروضة للبيع، وتثبيت الرادارات لمراقبة السرعة.
كما ارتبطت هذه الخطة بمسار أوسع من العمل المندمج على السلامة الطرقية، ربط كل هذه التدابير بالاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026.
الجديد في 2025 كان هو إدخال آلية قانونية صارمة لمراقبة مطابقة الدراجات، من خلال استعمال أجهزة قياس السرعة القصوى (speedomètres) للتأكد من أنها لم تخضع لتعديلات غير قانونية.
لكن خلف هذا الجهد التنظيمي والتقني، تتوارى صورة أخرى أكثر تعقيدا. فالمغرب يعرف منذ سنوات انتشار سوق سوداء موازية لترويج الدراجات المعدّلة وقطع الغيار المهربة، تنشط في أسواق كبرى مثل القريعة ودرب عمر، وفي مدن الشمال بحكم القرب من معابر التهريب.
ورشات صغيرة في الأحياء الشعبية تستقبل الزبائن الباحثين عن السرعة والصوت المزعج، فيما يتكفل مهرّبون وتجار انتهازيون بتمرير القطع عبر قنوات غير قانونية.
هذا التشابك يجعل من الظاهرة شبكة مصالح اقتصادية واجتماعية يصعب اختراقها بمجرد حملة زجرية أو قرار إداري. ومن هنا يتضح أن خطة “الدراجة الآمنة” لم تسقط من السماء هذا الشتاء، بل هي ثمرة مسار طويل واجهته منذ البداية عقبة أساسية: غياب الرؤية السياسية عند الحكومة.
فهذه الأخيرة تشتغل بمنطق تقني صرف، وكأن الأمر يتعلق بعملية حسابية باردة، يكفي معها تسخير الأدوات الإدارية والتقنية المتاحة لها، رغم أن المسألة تمس المجتمع في عمقه: شبابا، وعمالا، وأسرا فقدت أبناءها.
لقد بذلت وكالة “نارسا” جهدا تواصليا كبيرا، والوزير عبد الصمد قيوح أجاب في البرلمان عن أسئلة البرلمانيين حول الموضوع، لكن هناك شرخ بين الجهاز التنفيذي والمجتمع. والإصلاحات، أيّا كان طابعها، لا تنجح إلا حين تتغذى من نبض الشارع وتُترجم إلى لغة الناس. وهذا ما تفتقده المقاربة الحكومية الحالية.
أما الجدل الجديد الذي تفجّر عقب خبر تدخل رئيس الحكومة عزيز أخنوش لوقف مسطرة مراقبة السرعة القصوى، فمظهر لخلل آخر.
بينما ساد انطباع عام أن الأمر يعكس ارتباكا أو تناقضا حكوميا، أرى العكس تماما: من حق، بل من واجب رئيس الحكومة أن يتدخل في كل صغيرة وكبيرة، ما دام الدستور يحمّله المسؤولية الكاملة عن العمل الحكومي بجميع قطاعاته.
لا يوجد في الدستور ولا القوانين التنظيمية والعادية، ما يتيح للوزراء أن يتصرفوا كجزر مستقلة، فرئيس الحكومة هو المسؤول الأول عن توجيه وتصحيح وتنظيم السياسات العمومية. وتدخله هنا ليس خرقا ولا قرصنة، بل تفعيل لجوهر صلاحياته.
الغريب هو مسارعة البعض إلى تحويل الواقعة إلى مادة للتشكيك والاتهام، كأن مجرد تفاعل عزيز أخنوش مع ضجة اجتماعية يصبح استثمارا سياسيا فاسدا. والحال أن السياسة الحقيقية لا تكون إلا في الإنصات لانتظارات الناس والتجاوب مع مطالبهم. وإذا كان هناك عائد سياسي لهذا التفاعل، فهو عائد مستحق، لأن رئيس الحكومة الذي لا يتدخل في ملفات تؤرق الشارع يكون قد تخلّى عن أهم أدواره.
ثم إن قيوح وزير في حكومة أخنوش، وحصل على اختصاصاته بمرسوم تفويض وقّعه رئيس الحكومة نفسه، فما الداعي لبناء قراءات توهم الناس بأن أخنوش سيحصل على ولاية ثانية محمولا على أكتاف سائقي الدراجات؟
هل نسي هؤلاء أن الفئة التي يُفترض أنها استفادت من قرار تعليق مراقبة الدراجات وحجزها، هي ذاتها التي تكتوي بنار أسعار المحروقات التي يظل أخنوش أكبر فاعل فيها؟ أليسوا هم أنفسهم الذين يعانون من غلاء الخضر والفواكه، ومن ضغط تكاليف الصحة والسكن وكل الخدمات الأساسية؟
مأساة المغربي أنه لا يكاد ينجو من اختزالات السياسيين حتى يقع فريسة لاختزالات المعلّقين والمحلّلين، بينما يظل انتظاره البسيط هو أن تُمارَس السياسة بمعناها الأصيل: خدمة المجتمع، لا تسويق الأوهام.
المشكل لا يكمن إذن في “تضارب الصلاحيات”، بل في غياب حكومة سياسية قادرة على الإمساك بخيوط الملف من جذوره: من ظاهرة الدراجات المعدلة، إلى الاقتصاد الموازي الذي يغذيها، وصولا إلى الظواهر الاجتماعية الجديدة مثل خدمات “التوصيل” و”التريبورتور”.
نحن بحاجة إلى حكومة تملك أقداما راسخة في الأرض، تستطيع التقاط نبض المجتمع وتحويله إلى سياسات قابلة للنجاح، لا حكومة تكتفي بقرارات تقنية تُصاغ في المكاتب وتُواجه في الشارع بالرفض أو الاستهزاء.
إن أزمة الدراجات ليست قضية خوذة أو رادار أو مخالفة فقط، بل مرآة تعكس عمق الخلل في علاقتنا بالسياسات العمومية. والدرس المستفاد أن الإصلاح لا يمكن أن يُقاس بعدد البلاغات والعمليات التواصلية، بل بمدى قدرة الفاعل السياسي على كسب ثقة المجتمع وإشراكه في صياغة الحلول.