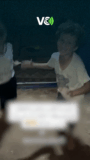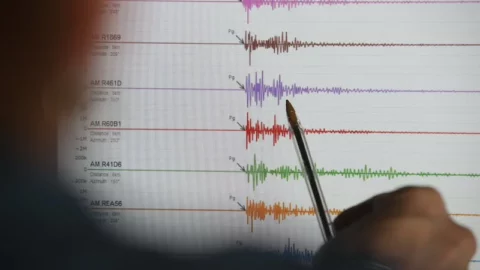فلاحة تزرع العبودية

بعدما كدنا نيأس من رحمة الله بفعل سنوات الجفاف المتعاقبة، جاد علينا الله في الأيام القليلة الماضية برحمته، واستقبلت أرضنا في أسبوع واحد ما يفوق المليار متر مكعّب من المياه التي أحيت الأرض والنفوس.
سارعت الهيئات والمؤسسات السياسية والاقتصادية إلى القيام بالإسقاطات الإحصائية لنتائج هذه التساقطات المطرية، والتي ستتمثل أساسا في عشرات ومئات الآلاف، إن لم يكن الملايين من مناصب الشغل التي ستحتسب ضمن الحصيلة الإيجابية لهذه التساقطات، لكن لا أحد تساءل يوما عن طبيعة هذا الشغل الذي توفّره الفلاحة المغربية.
كان لدي دائما شعور بالامتعاض من التعاطي الكمّي مع الشغل الذي توفّره الفلاحة المغربية، خاصة منها الفلاحة الكبرى والمصدّرة، لأنني أعرف كما يعرف الجميع، أن الأمر يتعلّق بظروف قاسية ومهينة ترقى إلى مرتبة العبودية.
لكننا اليوم أمام نتائج دراسة ميدانية أنجزت بطريقة علمية دقيقة، تؤكد هذا الانطباع، وتحوّله إلى معطيات موثوقة، تفيد أن جل المغاربة الذين يشتغلون في استغلاليات فلاحية أو صناعية-غذائية، هم مواطنون من الدرجة الدنيا، و”عبيد” يستغلّهم مشغّلوهم ويعرّضونهم لأقسى أنواع الإهانة والاعتداءات الماسة بالكرامة.
يتعلّق الأمر بدراسة حول المسؤولية الحقوقية للمقاولات الفلاحية، أنجزها كل من معهد الرباط للدراسات الاجتماعية، ومنظمة “محامون بلا حدود”، وشملت وحدات إنتاجية فلاحية من مختلف الأصناف والأحجام، موزعة بين جهتي الرباط سلا القنيطرة، وطنجة تطوان الحسيمة، وتضمّنت مقابلات علمية مع العشرات من المتدخلين والمسؤولين والعاملين في هذه الوحدات، وانتهت إلى خلاصات صادمة.
ففي قلب الحقول والضيعات التي تُروى بعرق العمال، وفي المصانع الغذائية حيث يتحول الإنتاج إلى ثروة في حسابات البعض، يكشف الواقع عن وجهه الأكثر قسوة.
لا حديث هنا عن “الشغل اللائق” أو “العدالة الاجتماعية”، بل عن منظومة تستنزف الإنسان قبل أن تستخرج المحصول.
هنا في سجّل فرص الشغل الفلاحية التي ستخرج الحكومة لتعلنها بابتهاج كبير، يشتغل العامل 12 ساعة، لكن أجره لا يتعدى 7 ساعات في أحسن الأحوال، بينما تتلاشى الساعات الإضافية في ظلمة التلاعبات المحاسبية.
وبطبيعة الحال، فإن التصريحات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) تبقى أقل بكثير من عدد الأيام التي قضاها العامل في العمل، كأنهم يشتغلون في عالم مواز، حيث الجهد لا يُحسب، والتعب لا يُعوَّض.
في هذه الضيعات والمعامل، العامل هو ترس في آلة لا تهتم لسلامته ولا لصوته. فظروف العمل هنا يمكن أن تحيل إلى أي شيء عدا الظروف الإنسانية، حيث الحمولة الثقيلة واجب يومي، والتعرض للحرارة الحارقة أو البرد القارس جزء من الوظيفة، واستنشاق المواد السامة دون حماية روتين مألوف.
“كاين مثلا فتطوان وحدة إنتاجية، العاملات كيديرو شغلهم في الثلاجات لأنهم كيعالجو الحوت crevette فظروف صحية مشي هي هاديك” يقول أحد المتحدثين إلى الباحثات، مضيفا الى ذلك هزالة الأجور. “النهار كامل كتعطيني 10 درهم ولا 11 درهم للكيلو غرام، هداك الحوت لي كنهضرو عليه هداك الكروفيط قد هكا (إشارة إلى حجمه الصغير جدا) باش المرأة تدير كيلو خاصها ساعات وساعات يلاه كتصاوب واحد جوج كيلو كيعطيو لها 25 درهم فالنهار وكتعاني”، يضيف المتحدّث نفسه.
وعندما يتعلّق الأمر بعاملة فلاحية، فإن الظلم يصبح مضاعفا وممنهجا. هذه المواطنة المغربية العاملة في الفلاحة ليست عُرضة للتمييز في الأجر فقط، بل هي مخلوقة محاصرة في وظائف متعبة تُستبعد منها “بالصدفة” فرص الترقية والمسؤولية.
أما الأمن الجسدي، فهو رفاهية بعيدة المنال، حيث تتكرر حالات العنف اللفظي، والتحرش، والاعتداءات الجنسية، في فضاء العمل الذي يُفترض أن يكون آمنا.
“القطاع الفلاحي را ما فيهش حق الإنسان، را فيه العبودية، والعبودية ديال القرون الوسطى”، يقول ممثل نقابي في إحدى الوحدات الفلاحية ممن التقتهن الباحثات في هذه الدراسة. فيما تقولها إحدى العاملات صريحة وواضحة بشأن الاستغلال الجنسي الممنهج للعاملة الفلاحية: “كلشي حقو فالزردة، شتي الرجال كلهم حقهم فالزردة: القصرية اللي شافها باغي يدوق منها”.
وتكشف الدراسة النقاب عن أوضاع خطيرة، تجعل اليد العاملة النسائية الرخصية مفضلة عند المشغّلين، لأن النساء، حسب خلاصات الدراسة، تعتبرن “أسهل في السيطرة”، و”أقل وعياً بحقوقهن”، وكأن سوق الشغل في المجال الفلاحي لا يبحث عن اليد العاملة بقدر ما يبحث عن الفريسة الأسهل، لنتبجّح في النهاية بأرقام الصادرات وحجم السوق الذي اكتسحته منتجاتنا الفلاحية في العالم.
“في القطاع الفلاحي ولا l’agroalimentaire ، الاختيار ماشي اعتباطي بل اختيار مدروس، حيت المرأة في الثقافة ديالنا غتسكت، غتصبر، غتدوّز، وما غديش تطالب، غدي تقبل الوضعية. وكذلك نقطة أخرى، كتعيل العائلة (إذن خصها تدخل الفلوس للدار وبالتالي كتقبل انتهاكات حقوق الإنسان”، يقول أحد المستجوبين، فيما تضيف شهادة أخرى أن البوح والشكوى شبه مستحيلين، “حيت اللي هضر، يخرج، ايقوليك تبعيها، أو فالمثال الوقافة تديك للبوست (poste) صعيب، وتجي قدام الناس، وعرفتي؟ كتعطيك غير الهضور القاصحين، نتي ماغتقدريشي، يعني فينما كانت شي تمارة تديك ليها”.
الكلمة العليا للصمت إذن في هذا السياق الفلاحي المغربي، سواء من جانب الضحايا أو الشهود. “الا سكتي هانتي خدامة، هانتي قلبك كيتقطّع على ديك الإنسانة وخاصك دافعي عليها، ولكن متقدريش، كتقولي يلا هضرت صافي مشيت فيها، وأنا محتاجة بهاديك الخدمة، عندي واليديا خدامة عليهم أولا وليداتي أولا المهم أنا محتاجة”، تقول إحدى الشهادات التي وثّقتها الدراسة.
واقع الاستعباد هذا يكرّسه بعض المنتجين والمستغلين الفلاحيين، لكن له وجه آخر في الميدان، يمثّله “الكابرانات”، وهم في الغالب رجال، ممن يشرفون على مراقبة العمال الذين غالبا ما يكونون نساء.
“راه بعد المرات… ذوك الأجيرات اللي تيجيو كيتشكاو، كتلقى المشكلة فهذاك الكابران… وا حلّها نتا، معندكشي كيفاش غادي تدير فتحلها، “راه تيتعامل معايا خايب”، “كيعايرني”، “كي…” تتولي أنت … عوض تعيط على المشغل، كتولي تعيط على الكابران، هو اللي كتولي كتهضر معه”، يقول أحد المكلفين بمراقبة أحوال الشغل، ممن شملتم الدراسة.
في مثل هذه الظروف يصبح الاحتجاج ترفا لا يقدر عليه أحد، وتتحول المطالبة بالحقوق إلى تذكرة عبور نحو الطرد والانتقام، ويصبح الاستعباد الحديث واقعا يفرض نفسه.
وهذه ليست مجرد قصص متفرقة، بل معاناة يومية لمئات الآلاف من المغاربة الذين يدفعون ثمن صمت الدولة وجشع الرأسمالية المنفلتة.
فإلى متى سيظل هؤلاء العمال في الظل، وإلى متى سيستمر هذا النزيف الاجتماعي دون ردع أو حساب؟ ومتى نكفّ على الأقل عن التبجّح بأرقام فرص الشغل التي ننسبها إلى الفلاحة؟