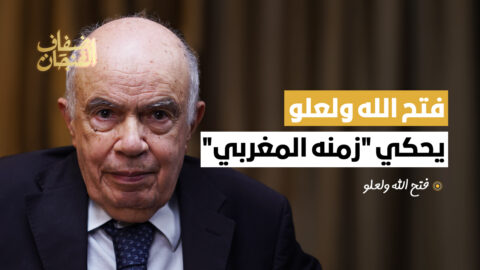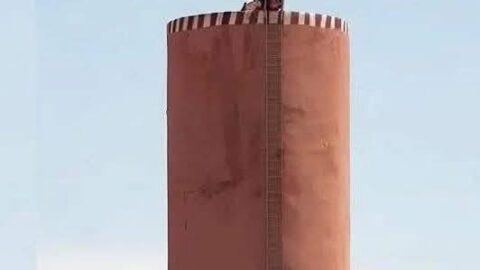شكون هما المخاشفة؟

لفهم ما يحصل مع المغاربة هذه الأيام، نحتاج إلى مراجعة قطعة من الموروث الغنائي، وتحديدا تلك الأغنية التي أبدعها المرحوم الحسين السلاوي منذ ما يقرب من القرن، والتي ينصح فيها المستمع بالانتباه: “رد بالك لا يفوزوا بك القومان يا فلان”.
ويهمّنا في كلمات هذه الأغنية تحديدا، ذلك التعريف الذي قدّمته لمفهوم “المخاشفة” الذي استعمله السلاوي في وصف فئة من أخطر المتحايلين على السوق.
“شكون هوما المخاشفة؟”، يسأل المغنّي، قبل أن يعود ليجيب: “اللي يبيعو الروس مع الكرشة.. هو يعبر وانت اعزل.. لا يعملك منخار دلعجل.. تبقى فالطاجين تتدور وتصبحنا بلا فطور…”.
من هنا يمكن اشتقاق مفهوم “التخوشيف” كحيلة يمارسها بعض التجار، الذين يخفون البضاعة، أو يتستّرون على عيبها، وينشرون الهلع، ثم يبيعونها بأضعاف سعرها.
كان ذلك في زمنٍ كان فيه التخوشيف مجرد حيلة تجارية، لا أكثر.
لكن من كان يظن أن هذه الخدعة الصغيرة ستترقى بمرور العقود إلى سياسة اقتصادية، ثم إلى منهج في التدبير، حتى صارت قانون المرحلة، لا ينافسه دستور ولا تناقضه أي وثيقة رسمية؟
ففي مغرب اليوم، لم يعد التخوشيف مجرد عملية تجارية عابرة، بل صار من أدوات التدبير اليومي، يتحكم في الأسعار والأسواق، ثم يتسلل إلى الإدارات، قبل أن يتحول إلى عقيدة جزء من مسؤولي الدولة في التعامل مع الشعب.
لم يعد التخوشيف سلوكا معزولا يمارسه تجار المضاربة فقط، بل أصبح قاعدة في العمل الحكومي والاقتصادي، حيث يتم اللعب بمشاعر الناس وتخويفهم من المستقبل، حتى يتقبلوا الأمر الواقع، سواء الغلاء، أو نهب المال العام، أو حتى انتزاع ممتلكاتهم بدعوى “التنمية” التي لا يرون منها إلا الدخان والغبار.
لنبدأ من الأسواق. الأسعار ترتفع دون سبب واضح، وأحيانا بسبب تصريحات رسمية تبرر الأمر بالحرب هناك أو بالجفاف هنا، بينما الحقيقة غالبًا في مكان آخر: الاحتكار، التلاعب بالمخزون، والتوافقات الخفية بين كبار المتحكمين في السوق.
يمارس هؤلاء التجار التخويف بطرق مبتكرة، يروجون إشاعات الندرة، فتتهافت الناس، ثم تبدأ موجة الغلاء، فيتحول المواطن إلى رهينة بين يدي قوى خفية تتحكم في رغيفه اليومي.
والدولة؟ أين الدولة؟
إنها تتفرج، وأحيانا تشارك، إما بالصمت أو بالتواطؤ. تمتص الغضب بوعود الإصلاح، ثم تعود لتلقي باللوم على المواطن نفسه: “أنتم السبب، أنتم من يشتري رغم الغلاء.. خلّيوه يخماج!”.
كأن المطلوب أن يصوم المغاربة عن الأكل حتى ينضبط السوق. هذا هو التخوشيف في صورته الصافية: قلب الحقائق، وتحويل الضحية إلى متهم، ثم تسليم مفاتيح السوق إلى كبار المتلاعبين، الذين يزدادون ثراء مع كل أزمة جديدة.
أما في السياسة، فالتخوشيف لم يعد مجرد تكتيك، بل صار قاعدة.
يقال للمواطن إن البلد يمر بأزمة اقتصادية، وإن الدولة مضطرة لشد الحزام، فيتم الحدّ من التوظيف، وتقليص الدعم، ورفع الأسعار، وفرض الضرائب الجديدة، وكل ذلك باسم “الإصلاح”، لكن في الوقت نفسه، لا يتوقف النزيف: رواتب المسؤولين في ارتفاع، الامتيازات قائمة، والمشاريع التي تفصّل على مقاس شركات معروفة لا تتوقف.
كيف يمكن للصندوق أن يكون فارغا دائما عندما يتعلق الأمر بالمستشفيات والمدارس والبنية التحتية، لكنه ممتلئ عندما يكون الحديث عن تعويضات الوزراء، أو الصفقات الكبرى، أو التفويتات المشبوهة؟
السياسيون يمارسون التخوشيف بأقصى درجاته: يُرهبون الناس بخطر الإفلاس والانهيار، حتى يقبلوا بأي حل، حتى لو كان ذلك يعني دفعهم إلى هاوية اجتماعية لا قاع لها. التخويف صار أداة حكم، وسلاحا لترويض الجماهير، يُستخدم لإقناعهم بأن الحل الوحيد هو “القبول بالواقع”، لأن البديل أسوأ… هل تذكرون عبارجة “واش بغيتونا نوليو بحال سوريا؟”؟
وإذا كان هناك مقياس حقيقي لمدى تغلغل التخوشيف في أجهزة الدولة، فهو طريقة تعاملها مع الكوارث الطبيعية.
حينما تضرب الفيضانات أو الزلازل أو الحرائق، يُترك المواطنون لمصيرهم. يباتون في العراء، وتُوزع عليهم وعود الدعم، لكن عندما يطالبون بحقوقهم، يُقال لهم إن “الإمكانيات محدودة”، وإن الدولة لا تستطيع تعويض الجميع. وهكذا، بدل أن يكون القانون الخاص بتعويض ضحايا الكوارث هو المرجع، يصبح التخويف هو القاعدة: إذا اشتكيت، ستخسر أكثر، وإذا طالبت بحقوقك، فالدولة قد تتجاهلك تماما.
كارثة الزلزال التي ضربت الأطلس الكبير وشرّدت الآلاف لم تكن فقط كارثة طبيعية، بل كانت أيضا اختبارا لمدى هيمنة التخوشيف.
المنكوبون لم يحصلوا على تعويضاتهم كما تنص فصول القانون المهمل، بل تُركوا في العراء، بينما كان المسؤولون يعِدون على المنصات ويبررون التأخير بتعقيدات “إدارية”، وكأنهم يتحدثون عن ورقة ضاعت في أرشيف، وليس عن أرواح تبحث عن مأوى.
لا يتوقف التخوشيف عند الأسواق والاقتصاد والسياسة، بل يصل إلى العقار.
في الرباط، سكان حي المحيط يعرفون جيدا ما معنى أن تكون فقيرا في زمن التخوشيف. منازلهم ليست مجرد إسمنت وحجارة، بل تاريخ وذكريات، لكنهم اليوم يواجهون معركة غير متكافئة مع من قرروا أن هذه الأرض يجب أن تصبح استثمارا جديدا.
لا يهم إن كان ذلك مخالفا للدستور الذي يضمن حق الملكية، ولا يهم إن كانت هذه البيوت قائمة منذ عقود، لأن منطق التخوشيف يقول إن “المصلحة العامة” تعني مصالح الخاصة.
والقادم أسوأ: حتى ملاعب الكرة، التي كانت يوما أماكن للفرجة الشعبية، لم تعد في مأمن. ملعب محمد الخامس، رمز الكرة في الدار البيضاء، يُمهَّد لتحويله إلى مشروع عقاري، لأن في زمن التخوشيف، لا وجود لمكان عام لا يمكن بيعه لمن يدفع أكثر.
لم يعد التخوشيف مجرد خدعة، أو ممارسة سرية، بل صار منهجا عاما، يُستخدم لتوجيه المجتمع حيث تريد السلطة، ويُمارَس بأساليب متنوعة: الاقتصاد، والسياسة، والإدارة، وحتى في تدبير الكوارث والأزمات.
لكن، وكما في كل مراحل التاريخ، هذا النوع من الحكم له حدوده. الشعوب قد تصبر، لكنها لا تنسى، والتخويف قد ينجح لبعض الوقت، لكنه لا يبني دولا مستقرة، ولا يخلق مجتمعات متماسكة.
عاجلا أم آجلا، سيوصلنا التخوشيف إلى نقطة الانفجار. حينها، لن تنفع التصريحات، ولا التبريرات، لأن الحقيقة التي يحاول البعض إخفاءها تحت طبقات التخويف ستظهر واضحة: لا أزمة حقيقية، بل فقط إدارة فاشلة وانتهازية، ولا خطر داهم، بل فقط رغبة في السيطرة، ولا دولة ضعيفة، بل فقط دولة تُدار لصالح قلة، بينما الأغلبية تُرهب حتى لا تطالب بحقها.
لكن الشعوب لا تعيش بالخوف، والتاريخ أثبت أن التخويف قد يُجبر الناس على الصمت، لكنه لا يمكن أن يقنعهم بأن الظلم عدالة، أو أن الاستسلام حل…
عرفنا التخوشيف.. لكن يبقى سؤال الحسين السلاوي مطروحا: شكون هما المخاشفة؟