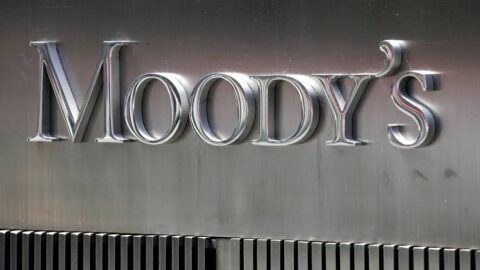جنائز العيد في غزة

أنا لا أكره الفرح، ولا أرفض الاحتفال. بل أومن أن الفرح، في زمن القهر، هو فعل مقاومة، وإصرار على البقاء.
وإننا نفرح كلما وجدنا إلى ذلك سبيلا، لأننا بذلك ننتصر لفكرتنا في وجه آلة التيئيس والإحباط.
لكن ما يجري في غزة يجعل الفرح نوعا من الخيانة، أو على الأقل من الغفلة والتغافل.
في أوقات كهذه، حين تنطلق مواكب الزينة في مدننا، وتضيء الألعاب النارية سماء المدن البعيدة، تواصل الأرض في غزة ابتلاع أبنائها، ويصبح للعيد طعم الرماد، وتتحول التهاني المتنقلة في الهواتف والشاشات إلى خناجر تقطع في القلب.
كيف نبتسم، وأمهات هناك يُمزّقن صمت الليل بصراخ لا يُسمع إلا في السماء، وينتشلن أشلاء أطفالهن من بين الأنقاض؟
كيف نغنّي، وهناك من يرفع حجرا تلو آخر بحثا عن يد صغيرة أو دمية محروقة؟
كيف نحتفل، وهناك من يخطّ أسماء العائلة على أكفان بيضاء، لأن السجلات لم تعد تكفي؟
بالأمس فقط، الأحد 30 مارس 2025، أي يوم الأرض الفلسطيني وأول أيام عيد الفطر، لم تكن غزة على موعد مع الفرح، بل مع فصل جديد من القتل.
يوم أمس فقط خرجت أمهات كثر، مثلما خرجت أم الصحافي الشاب حسام شبات، تهرع إلى النافذة لتسمع صوت تكبيرات العيد، تظنّ للوهلة الأولى أن صوتا من السماء يبشّر بالسلام، لكنها سرعان ما تستوعب المشهد، فتنهار: ابنها حسام، الذي ربّته بعد موت والده، لم يعد، ولا العيد عاد، فتصرخ: “آه يا حسام يمه وينك؟!”.
في غزة اليوم، لا عيد يشبه الأعياد، ولا زمن يشبه ما اعتدناه من مواقيت الفرح.
لا زيارات ولا كعك ولا ثياب جديدة. بل خيام ممزّقة، وأجساد مبتورة، وندوب لا تندمل.
لا زغاريد فرح هناك، بل دوّي قنابل وصراخ أطفال تحت الركام.
لا موائد عامرة هناك، بل ممرات مكتظة في مستشفيات منهارة، وروائح دم امتزجت برماد القصف.
العيد في غزة ليس يوم فرح، بل فصل إضافي من رواية الفقد.
في غزة هذا العام لم تكن هناك أغان، بل نداءات استغاثة.
بالأمس فقط انتُشلت جثث ثمانية من أطقم الإسعاف والدفاع المدني من تحت الركام في رفح، الذين قُتلوا لأنهم اختاروا أن يلبّوا نداء الجرحى.
وفي خان يونس، استشهدت طفلتان بثيابهما الجديدة، ووالدهما ممدد بجوارهما، ويده تقبض على “العيدية” البسيطة التي لم تُسلّم.
هذا العيد هو الثالث الذي تمرّ فيه غزة في أتون النار، منذ الثامن من أكتوبر 2023، حين بدأ الاحتلال حربه المفتوحة على القطاع.
أكثر من 50 ألف شهيد، جلّهم من المدنيين، وثلثهم أطفال. آلاف الغارات وزّعت الأطنان من النيران، وتدمير ممنهج للمنازل والمستشفيات والمدارس، بل وحتى المساجد.
جريمة مستمرة، لا تحرج مرتكبيها، بل يتفاخرون بها.
في غزة، تأكل الحرب الأرواح والذاكرة، وتحوّل الحياة إلى مجرد صدفة، أو استثناء يؤكد القاعدة/الموت.
الأم التي كانت تصنع كعك العيد، صارت تصنع القبور. والأب الذي كان يحمل أبناءه إلى المسجد، صار يحمل جثثهم إلى المقبرة. والأطفال الذين كانوا يفرحون بالعيدية، صاروا يستشهدون وهم يحملونها.
لكن أخطر ما في القصة، أخطر حتى من القنابل والرصاص، هو الصمت. الأخطر من القصف، هو التواطؤ.
العالم يشاهد كل شيء، ومع ذلك، يواصل إرسال السلاح والدعم السياسي والمالي لإسرائيل.
أمريكا، وأروبا، وحتى بعض العرب، جميعهم شهود وشركاء. يقتلون الفلسطينيين ويطالبونهم بالصمت. يذبحونهم، ثم يطلبون منهم أن يلقوا السلاح، ويغادروا بلادهم.
في غزة، يجري الآن تنفيذ “رؤية ترامب” لتفريغ القطاع من سكانه، عبر القتل والدمار والتجويع.
تم تعيين يعقوب بليتشتاين رئيسا لهيئة تهجير الغزيين، لم يعد الأمر مجرد تحليل أو استنتاج، بل خطة معلنة.
أربعون في المئة من سكان غزة –تقول إسرائيل– يريدون الرحيل، فهل نساعدهم على ذلك بالصمت؟
ها هو ذا جيش الاحتلال يعترف باستخدام المدنيين دروعا بشرية. مسؤول إسرائيلي قالها صراحة لصحيفة هآرتس: المدنيون يُستخدمون ست مرات يوميا، وفق “بروتوكول البعوض”، كدروع بشرية.
أيّ سقوط أخلاقي هذا؟ أيّ حضيض إنساني هذا الذي يجرّ العالم إليه الاحتلال الصهيوني؟
حتى المسعفين قتلوهم وهم يرتدون شارة الهلال الأحمر. فتحوا النار على سيارات الإسعاف، وقتلوا المنقذين وتركوا جثثهم تتحلل في الرمل. ثم قالوا إنهم اشتبهوا فيهم.
أية عدالة تبقى، إذا كانت الإنسانية نفسها تُباد بهذه البرودة؟
كل هذا، ثم يتحدث نتنياهو عن “الهجرة الطوعية” و”إلقاء السلاح”. وكأن غزة هي التي غزت، وليست المحتلة. وكأن المقاومة جريمة، بينما الاحتلال فعل قانوني!
هذه هي الحرب الأخطر، الحرب على الوعي، والقتل الممنهج لفكرة الصمود في الأرض.
يحتفل المسلمون، عبر العالم بالعيد. بينما في غزة أصبح العيد جنازة.
في بعض أنحاء العام يحتفل الناس بالألعاب النارية، وفي خان يونس هناك نيران المدفعية.
عندنا تُعقد أسواق العيد، وفي رفح هناك أسواق الجثث.
عالمٌ يتصدّع في إنسانيته كما تتصدّع جدران غزة تحت القصف، ويتعرّى في صمته كما يتعرّى الضمير حين يبرّر الجريمة.
عالم فقد القدرة على الحزن، واختار أن ينظر إلى المذبحة بأعين باردة، كمن يشاهد فيلما طويلا عن موت لا يعنيه.. عينه تشاهد وفمه يتذوق قطع “شيبس” المملحة.
لا نرجو من العالم أن يقاتل من أجل غزة، بل فقط أن يكفّ عن تمويل القاتل.
نرجو أن يترك لنا فقط حقنا في الوجود، وأن يعترف بألمنا، وأن يُدين الجريمة.
أما نحن، وإخوتنا في فلسطين، فسنظل نعيّد، حتى في العزاء. سنحمل كعك العيد إلى المقابر، وسنقرأ الفاتحة على الأمل، ثم نرفع راياته من جديد.
مهما طغا الظلم وتجبّر، فإن غزة، لن تُهزم، لأنها لا تقاتل فقط من أجل الأرض، بل من أجل المعنى. من أجل أن يبقى الإنسان إنسانا.
وحتى ذلك الحين، نعيد ونقول: كل عام وأنتم أقرب إلى الحرية.. في الحياة كما في الموت.