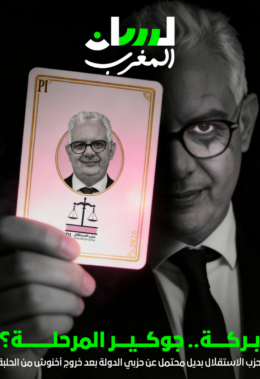انعكاسات تَفوُّق الإناث في التحصيل الدراسي على المجتمع المغربي

لقد أضحت الفجوة بين الجنسين في الأداء الدراسي واحدة من أبرز القضايا التربوية التي جذبت اهتمام الباحثين خلال العقود الأخيرة، إذ تحولت إلى مصدر قلق حقيقي يطرح تحديات جديدة أمام المنظومات التعليمية، سواء على المستوى الوطني أو الدولي.
وقد دفع هذا الواقع العديد من المختصين إلى دق ناقوس الخطر بشأن مستقبل التوازن التعليمي بين الجنسين، وتأثيره على توزيع الأدوار وموازين القوى داخل المجتمع.
ظهرت الارهاصات الأولى لهذه الإشكالية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية منذ ما يزيد عن ثلاثة عقود، غير أن الفارق الجوهري بيننا وبين تلك الدول تمثل في طريقة التعامل مع الظاهرة؛ فهناك بادرت مراكز البحث إلى إجراء دراسات معمقة لتحليل أسبابها واقتراح حلول علمية للتصدي لها، بينما اكتفينا نحن في المغرب بالتفرج والتذمر والشكوى وتبادل اللوم والانطباعات، دون اعتماد مقاربات بحثية أو علمية منهجية تتيح فهمًا دقيقًا للظاهرة وسبل معالجتها.
فبعد أن كان التركيز في العقود الماضية منصبًّا على إنصاف الفتيات وضمان ولوجهن إلى التعليم، أصبح النقاش اليوم يدور حول تراجع أداء الذكور في مقابل تفوق الإناث بمختلف المستويات الدراسية، حيث تشير المعطيات الرسمية، الوطنية والدولية، إلى أن الفجوة بين الجنسين في التحصيل الدراسي مستمرة في التفاقم وأصبحت تمثل كابوسا حقيقيا لدى وزارات التعليم بالعالم.
فقد كشفت الأرقام الصادرة عن وزارة التربية الوطنية والمندوبية السامية للتخطيط بالمغرب تفوق الفتيات بانتظام على الذكور في نسب النجاح والتحصيل الدراسي. فعلى سبيل المثال، في امتحانات البكالوريا لسنة 2025، بلغت نسبة النجاح لدى الإناث 71.3٪ مقابل 61.8٪ لدى الذكور. لكن المشكلة الحقيقية لم تقف هنا فحسب، بل امتدت الى سيطرة الفتيات على نحو 90٪ من المراتب العشرة الأولى في أغلب المؤسسات التعليمية، بل ووصلت نسب نجاحهن ببعض المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود ومباريات التوظيف إلى ما يزيد عن 95٪.
لذلك، سأحاول في هذا المقال، وبقدر من التواضع، تقديم خلاصة مركّزة لعدد من المقالات والأبحاث الأمريكية والكندية والأوروبية، موضحًا أبرز المتغيرات المحتملة المفسرة لهذه الظاهرة، مع التركيز على المتغيرات المشتركة مع منظومة التربية والتكوين بالمملكة المغربية، والتي يمكن حصرها في أربع متغيرات أساسية:
- تغيير المناهج الدراسية.
- تخفيض سن التمدرس.
- كثرة الواجبات الدراسية المنزلية.
- نقص الأساتذة الذكور في التعليم الابتدائي أو ما يسمى بتأنيث المدرسة.
1 – تغيير المناهج الدراسية وتأثيره على الذكور.
يشير العديد من الباحثين الكنديين وخاصة الباحث بيير بوتفان في دراسته (2007 ) Le problème de réussite scolaire des garçons
إلى أن تطور المناهج خلال التسعينيات وبداية الألفية الثالثة جعلها أكثر تركيزًا على الكفايات التواصلية واللغوية والتنظيمية، وهي مجالات تميل فيها الفتيات للتفوق الطبيعي، مقابل تراجع الاهتمام بالأنشطة العلمية والعملية التي تُحفّز الذكور عادةً. حيث أجمع الكل على أن المدرسة الحديثة لم تعد تساير الخصوصيات النمائية والسلوكية للذكور كما في العقود السابقة، واتجهت الى مناهج دراسية تعتمد على اللغات والحفظ والانضباط الذاتي، وهي مجالات تميل فيها الفتيات إلى التفوق الطبيعي.
وتؤكد دراسة أجرتها وزارة التربية في كيبيك (2012) أن 68% من المعلمين يعتبرون أن المناهج الحالية غير محفزة كفاية للذكور، خاصة في المراحل الابتدائية. كما بينت دراسة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصاديةOCDE (2015) أن الذكور يتفوقون في البيئات التعليمية التي تعتمد على التجريب والمشاريع التطبيقية، بينما يتراجع أداؤهم في الأنشطة اللغوية الطويلة والواجبات الكتابية المتكررة. مما يجعل الفتيات أكثر قدرة على النجاح، نظرًا لتطور مهاراتهن اللفظية المبكرة، وهو ما يفسر نتائج اختبارات كل من PISA وTIMSS والتي تظهر تفوقًا مستمرًا للفتيات في القراءة عبر جميع الدول الأعضاء.
هذا التحليل ينطبق جزئيًا على المناهج المغربية فبعد إصلاح الميثاق الوطني للتربية والتكوين سنة 2003، أصبحت الكفايات التواصلية والتعبيرية تحتل مساحة كبيرة في العملية التعليمية التعلمية بمنظومة التربية الوطنية، مما يجعل المناهج الحالية تمنح امتيازًا بطريقة غير مباشرة للإناث في المراحل الأولى من التمدرس.
2 – تخفيض سن التمدرس و آثاره السلبية على الذكور.
قد يستغرب البعض ويقول ما دخل تخفيض سن التمدرس في هذه الظاهرة فعمليا كلما خفضنا سن التمدرس الا واعطينا امتيازا للإناث بطريقة غير مباشرة مقابل الذكور، حيث تشير أبحاث كل من هيئة التعليم الوطنية الأمريكية (NEA) وأبحاث بوتفان (2015) أن الفتيات يبدأن في المدرسة بنضج لغوي ووجداني يفوق الذكور بعام تقريبًا في المتوسط. وعندما يتم إدخال الأطفال إلى المدرسة في سن مبكرة 5 أو 6 بدل 7 سنوات، فإن الفارق في النضج ينعكس مباشرة على الأداء والتحصيل الدراسي مما يحدث منذ السنوات الأولى فجوة بين الذكور والاناث، تتحول كما يؤكد الباحث الأمريكي توماس دي (Thomas Dee, 2006) مع مرور الوقت إلى فجوة في الدافعية والثقة بالنفس وتقدير إيجابي للذات تتعاظم مع الوقت، مما يعزز تفوق الفتيات على الذكور على المدى البعيد.
فرغم أن تعميم التعليم وتخفيض سن التمدرس إلى ست سنوات كان قد اعتبر آنذاك من أبرز الإصلاحات التربوية بالمغرب، فإن تقارير وزارة التربية الوطنية أظهرت ارتفاع نسب التكرار في السنوات الأولى لدى الذكور أكثر من الإناث وهو ما جعل العديد من التربويين يناشدون الآباء وأولياء أمورهم الى تأخير تسجيل ابناءهم بالمدارس الابتدائية.
فالإشكال هنا ليس في تخفيض سن التمدرس في حد ذاته، بل في عدم مواكبته بتكييف للمناهج وطرق التدريس لتراعي الفروق النمائية بين الجنسين.
3 – كثرة الواجبات الدراسية المنزلية وتأثيرها على التحصيل الدراسي للذكور.
تمثل الواجبات المدرسية المنزلية أحد أبرز العوامل التربوية المؤثرة في دافعية المتعلمين وجودة تحصيلهم الدراسي، غير أن الدراسات الحديثة تشير إلى أن الإفراط في هذه الواجبات قد ينعكس سلبًا على التعلم، خصوصًا لدى الذكور مقارنة بالإناث.
فقد أظهرت دراسة لمنظمة OCDE 2014حول وقت الدراسة المنزلي أن الفتيات في المستوى الابتدائي يخصصن في المتوسط نحو خمس ساعات أسبوعيًا لإنجاز الواجبات المدرسية المنزلية، مقابل ثلاث ساعات فقط للذكور. ويُعزى هذا التفاوت إلى ما تتميز به الفتيات من قدرة أعلى على التنظيم الذاتي والانضباط، في حين يحتاج الذكور إلى تخصيص وقتٍ أكبر للعب والنشاط الحركي خارج المنزل لما له من أهمية بالغة في بناء شخصيتهم وتنمية توازنهم النفسي والاجتماعي.
ومن هنا، تتحول الواجبات الطويلة إلى ميزة نسبية للفتيات، بينما تصبح عبئًا ضاغطًا على الذكور، مما يرفع لديهم مستويات التوتر والإحباط، ويدفع بعضهم إلى سلوكيات معارضة مثل الرفض أو التسويف أو الإنجاز السطحي، وهو ما ينعكس سلبًا على دافعيتهم وثقتهم في قدراتهم وعلى نتائجهم الدراسية بوجه عام.
فاللعب بالنسبة للطفل وخصوصا اللعب البدني ليس ترفًا، بل حاجة نفسية وتربوية أساسية، إذ يساهم في تنمية المهارات الحركية والاجتماعية والتواصلية، ويُنمّي قدرته على حل المشكلات والتعبير الذاتي. وقد أكدت الدراسات التربوية الصادرة عن منظمتي OCDEو UNESCO حول رفاه المتعلم أن الإفراط في الواجبات المنزلية لا يؤدي بالضرورة إلى تحسن التحصيل الدراسي، بل قد يُحدث أثرًا عكسيًا من خلال توليد الضغط الذهني والنفور من الدراسة. كما تبيّن أن التلميذ الذكر الذي يُحرم من أوقات اللعب المنتظمة يُظهر غالبًا سلوكيات عدوانية أو ميولًا إلى الملل والعزوف عن التعلم، بخلاف الفتيات اللواتي يتمكنّ من الحفاظ على تركيزهن بفعل استقرار البيئة المنزلية وهدوئها.
فالذكور عندما تُثقل كاهلهم بالواجبات الطويلة، يجدون أنفسهم في صراعٍ مستمر بين متطلبات الدراسة وحاجتهم إلى اللعب، فيلجأ بعضهم إلى إنجاز الواجبات بسرعة دون تركيز أو إلى نسخها من الزملاء، ما يفقدها قيمتها التربوية الحقيقية.
ومن جانب آخر، انتقد Marcoux (2018) التحول الذي عرفته الممارسات التربوية الحديثة، حيث أصبحت الواجبات المنزلية في كثير من الأحيان امتدادًا مباشرًا للدروس الصفية واستكمالا للمنهاج الدراسي بدل أن تكون وسيلةً لقياس مدى استيعاب المتعلم وترسيخا لمكتسباته الأساسية، وهو ما يفقدها بعدها التحفيزي ويجعلها أداة ضغط أكثر من كونها وسيلة دعم.
وتشير بيانات Statistique Canada (2020) الى أن 62% من الأمهات يساعدن بناتهن يوميًا، مقابل 44% فقط يساعدن أبناءهن الذكور. مما يعني أن الأسر تميل إلى تقديم دعم أكبر للفتيات في إنجاز الواجبات المدرسية، بينما يُترك الذكور لتدبير الأمر بأنفسهم، مما يزيد الفوارق بين الجنسين.
4- نقص الأساتذة الذكور في التعليم الابتدائي وتأثيره على التحصيل الدراسي للذكور.
يشير الباحث الكندي بوتفان في أحد أبحاثه إلى أن “المدرسة الحديثة فقدت توازنها الرمزي” نتيجة تراجع حضور المعلمين الذكور، لا سيما في التعليم الابتدائي، حيث لا تتجاوز نسبتهم 11% في مقاطعة كيبك. ويؤدي غياب هذه النماذج الذكورية إلى إضعاف الهوية المدرسية للذكور، مما يجعلهم أقل تحفيزًا وانضباطًا دراسيًا.
فالمدرس يمثل نموذجًا سلوكيًا وقدوة إيجابية تعزز الثقة والانتماء لدى التلاميذ. وتشير الإحصاءات إلى أن الذكور الذين يدرّسون على يد معلمين رجال يحققون نتائج أفضل بنسبة تتراوح بين 8% و12% في المواد اللغوية مقارنة بمن يدرّسهم أساتذة إناث فقط. ومع هيمنة النساء على أكثر من 60% من مناصب التعليم الابتدائي في العقدين الأخيرين بالمغرب، يتوقع أن يزداد اختلال هذا التوازن بشكل أكبر في المستقبل.
يتضح من التحليل السابق أن تفوق الإناث وتراجع الذكور في التحصيل الدراسي ليست ظاهرة بيولوجية فقط، بل نتاج تفاعل معقد بين العوامل البيداغوجية والنفسية والاجتماعية، فالمناهج الحالية، وسن التمدرس المبكر، وطبيعة الواجبات المدرسية وكثرتها، وتأنيت المدرسة الابتدائية كلها مكونات تعكس نظامًا تربويًا لا يراعي الفروق النمائية والسلوكية بين الجنسين.
ولذلك، يقترح بوتفان (2021) جملة من الإجراءات الإصلاحية أهمها:
- تكييف المناهج لتشمل أنشطة تجريبية وتفاعلية محفزة للذكور.
- إعادة النظر في سن التمدرس الإجباري وربط الالتحاق بمدى النضج الفردي لا بالسن القانوني فقط.
- تقليص حجم الواجبات المنزلية والتركيز على التعلم الممتع بدل التلقين.
- تكوين المعلمين في التعامل مع الفروق بين الجنسين دون أحكام مسبقة.
- تشجيع حضور المعلمين الذكور في التعليم الابتدائي كقدوات إيجابية.
5- انعكاسات الظاهرة على المجتمع المغربي.
ما يجب ان نستوعبه جميعا كمجتمع مغربي أن انعكاسات هذه الظاهرة لن تقف في مجرد أرقام تبرز تفوق ونجاح للإنات مقابل الذكور وحصولهن على وظائف أكثر والسلام، بل ان انعكاساتها ستمتد لا محال الى المجتمع وسوق العمل والعلاقات الأسرية.
فبحسب المندوبية السامية للتخطيط، فقد ارتفعت نسبة النساء الحاصلات على شهادات عليا بشكل ملحوظ خلال العقدين الأخيرين، وتزايد حضورهن في المجتمع في قطاعات مثل التعليم والصحة والوظيفة العمومية بصفة عامة، هذا التحول أدى إلى بروز تفاوتات جديدة في الأدوار الاجتماعية، إذ أصبحت نساء كثيرات في مواقع اقتصادية متقدمة مقارنة بالرجال.
غير أن هذا التفوق الدراسي والمهني صاحبه وللأسف ارتفاع في معدلات تأخر الزواج، أو ما يُعرف بـالعنوسة، إذ تشير تقارير المندوبية السامية للتخطيط لسنة 2025 إلى وجود أكثر من أربعة ملايين امرأة فوق سن الثلاثين لم يسبق لهن الزواج، لا سيما بين النساء الموظفات. ويرى بعض الباحثين أن ذلك يعكس ما يُسمّى بـاختلال التوازن الاجتماعي في الزواج، نتيجة التفاوت بين الجنسين في التعليم والوظائف والمكانة الاجتماعية.
ففي الثقافة المغربية، ما تزال الأعراف تُعيق زواج المرأة المتعلمة من رجل ذي مستوى اجتماعي أو اقتصادي أدنى، مما يولد توترًا بين النجاح المهني والاستقرار الأسري.
وقد فسرت دراسات سوسيولوجية مغربية، مثل أبحاث فاطمة المرنيسي والدكتور مصطفى محسن، هذه الظاهرة باعتبارها انعكاسًا مباشرًا لتحول الأدوار الاجتماعية وتبدل معايير المكانة الاجتماعية داخل المجتمع.
لكن يبقى السؤال الجوهري الذي يطرح نفسه في سياق هذه الظاهرة هو: هل جاءت هذه التحولات التربوية، من تعديل المناهج الدراسية، وتخفيض سن التمدرس، وكثرة الواجبات المنزلية، وتأنيث المدرسة الابتدائية، بشكل طبيعي وبدافع تربوي صرف؟ أم أنها دبرت بليل وكانت نتيجة توجهات مدروسة ومخطط لها من قبل مراكز تفكير استراتيجية، تهدف إلى تعزيز الحركة النسوية وإعادة توزيع الأدوار الاجتماعية وموازين القوى داخل المجتمعات؟
ويزداد هذا التساؤل مشروعية إذا علمنا أن هذه التغييرات تزامنت تاريخيًا مع صعود الحركات النسوية على الصعيد العالمي، ومع تصاعد المطالب بما يعرف بـ“الكوطا النسائية” في مجالات السياسة وتولي المناصب العليا ومراكز القرار.
في الختام، فلا ينبغي استخدام هذه الظاهرة كذريعة لتبرير تقاعس الذكور في التحصيل الدراسي، إذ لا يمكن تفسير تراجعهم فقط بهذه العوامل، فهناك بلا شك عناصر أخرى مؤثرة. ومن الضروري أيضًا تسليط الضوء على النماذج الذكورية المتفوقة ودراستها عبر أبحاث اجتماعية وسوسيولوجية، لتكون قدوة يُحتذى بها، ولتوفير أسس علمية يمكن الاستناد إليها في الإصلاحات المستقبلية، بما يسهم في استعادة التوازن داخل المجتمع ويعيد الأمور إلى مسارها الصحيح.
ذ.جمال هبوز
*إطار في التوجيه التربوي زاكورة
المراجع والمصادر
- بوتفان، بيير. Le problème de réussite scolaire des garçons. جامعة كيبيك، 2010.
- وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. تقرير حول نتائج امتحانات البكالوريا لسنة 2025. الرباط، 2025.
- المندوبية السامية للتخطيط. المرأة والرجل في أرقام. الرباط، 2024.
- Thomas Dee. Teachers and the Gender Gaps in Student Achievement. The Journal of Human Resources, 2006.
- Stanford University. Homework and Motivation Differences by Gender. Department of Education, 2014.
- National Education Association (NEA). Gender Differences in Early Learning. Washington, 2018.
- المرنيسي، فاطمة. الحريم السياسي: النبي والنساء. الدار البيضاء، 1991.
- محسن، مصطفى. سوسيولوجيا التربية والتحول الاجتماعي في المغرب. الدار البيضاء: إفريقيا الشرق، 2012.
- منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE). نتائج دراسات PISA وTIMSS. باريس، 202.