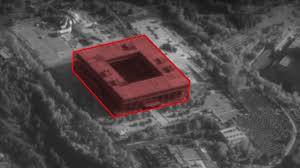الريف يمدّ يده

كان لابد من عودة إلى جنازة أحمد الزفزافي التي جرت الأسبوع الماضي، لأنها لم تكن مجرد وداع لرجل جاوز السبعين، وحمل قضية ابنه على كتفيه حتى آخر رمق، بل كانت لحظة سياسية بامتياز، لحظة كشفت عن عمق جرحٍ نحاول منذ ثماني سنوات إنكاره، فيما يزداد حضوره إلحاحا.
لقد حجّ الآلاف لتشييع “أب قائد الحراك”، ولاحظنا كيف انضم جيلٌ جديد إلى الهتاف وهو الذي لم يكن قد جاوز عتبة العاشرة حين اندلعت شرارة محسن فكري.
ثم كانت كلمةٌ قصيرة لناصر الزفزافي، الذي خرج من سجنه لساعات، تعيد النقاش إلى سكّته الأصلية: نحن أبناء وطن واحد، من صحرائه إلى ريفه.
هذا هو السؤال الحقيقي الذي يضعنا أمامه الريف: هل نملك الشجاعة لنُحوّل الألم إلى بداية جديدة، أم نواصل لعبة الإنكار وتبادل الاتهامات؟
دعونا نقولها من جديد: لم يكن حراك الريف، منذ البداية، مؤامرة ولا انفصالا. بل كان صرخة اجتماعية صافية ضد التهميش، تبلورت في برنامج مطلبي واضح: مستشفى، وجامعة، وفرص شغل كريم، وربط حقيقي بباقي البلاد.
لكن ما بدأ كاحتجاج اجتماعي مشروع، يرفع مطالب التنمية والكرامة، سرعان ما تحوّل إلى ملف أمني معقّد في لحظات انزلاق جرى تنسيقها عن سبق إصرار في ثلاث لحظات رئيسة.
لحظة أولى حين خرجت أحزاب سياسية، بدل أن تقوم بدورها الطبيعي كوسيط، لتوزّع على شباب عُزّل تهمة “الانفصال” بلا دليل ولا موجب.
ثم لحظة ثانية، أشد خطورة، حين وُصِف المحتجون بكونهم “دواعش”، فتم استدعاء المخيال الأمني بأثقاله الثقيلة، وتحوّل ملف اجتماعي إلى تهديد أمني في المخيّلة الرسمية.
ثم جاءت اللحظة الثالثة، لحظة الانزلاق الأكبر، حين جرى فتح الباب واسعا أمام لغة التخوين والعمالة، عبر اجترار تهمة الانفصال، بواسطة أدوات إعلامية معروفة ب”قربها”، بدل لغة الحقوق والمواطنة والتنمية.
لم تكن هذه اللحظات مجرد هفوات لغوية أو فلتات لسان في لحظة ارتباك سياسي، ولم تكن أخطاء ساذجة في التقدير أو سوء تعبير يمكن تجاوزه؛ بل كانت غطاء سياسيا مُحكم النسج، وفّر للدولة المبرّر والشرعية الشكلية للذهاب بعيدا في المقاربة الأمنية.
تحت ذلك الغطاء، تحولت المطالب إلى تهديدات، والاحتجاج إلى جريمة، والشارع إلى ملفّ قضائي. هكذا انتقلنا من مشهد الساحات الشعبية المليئة بالشعارات والطبول والآمال، إلى قاعات التحقيق والمحاكمات الثقيلة، وصولا إلى أحكام صادمة خلّفت ندوبا عميقة في الوجدان الجماعي للريف والمغرب معا.
لقد اخترنا، بوعي أو بتواطؤ الصمت، أن نلعب دور المصارع الذي لا يمد يده لتهدئة الثور الغاضب، بل يلوّح أمامه بقطعة قماش حمراء ليزداد هيجانا. والثور هنا استعارة تشير إلى نزوع التصعيد الموجود عند الطرفين، بل ربما كان “ثور” الدولة أكبر وأكثر خطورة.
وبدل أن نبحث عن حلول عقلانية تفتح نوافذ الثقة وتبني جسور الإنصات، انخرطنا في صناعة مشهد المواجهة.، فُطلقت التهم جزافا، وجرى تضخيم الخوف، وتحوّل صوت الغضب الشعبي إلى فزاعة تُعرض في واجهات السياسة والإعلام، ليُقال إننا أمام تهديد للوطن لا أمام نداء من داخله.
لقد كان في وسع الدولة أن تفتح أبواب المؤسسات وتستمع، لكننا جميعا ساهمنا في دفعها نحو الخيار الأسهل والأقسى: تأبيد الأزمة عبر تأبيد الخوف.
النتيجة اليوم أن الريف ما زال يعيش الشرعية نفسها للاحتجاج: لا مستشفى يلبّي كل الحاجيات المحلية في الحسيمة، ولا جامعة، ولا مناصب شغل كبرى سوى تلك التي تتأتى بعد ركوب قوارب الموت، ولا جسور ثقة مع الدولة.
والأسوأ أن جرح السجن ما زال ينزف، مع ستة معتقلين يرمزون إلى ذاكرة جماعية لم تنطفئ.
نعم، لقد صدرت سلسلة قرارات عفو أطلقت سراح العشرات من معتقلي الحراك. لكن جوهر الأزمة لم يُعالَج. لأن العفو ليس هدفا في حدّ ذاته، بل هو أداة سياسية لصناعة التهدئة وتوفير أجواء تسمح بالتجاوز والانطلاق من جديد.
وهو أيضا خطوة لا يمكن أن تؤتي ثمارها إذا لم تُرفَق بإصلاحات تعيد الثقة وتُرجع السياسة إلى معناها.
لقد أبانت جنازة أحمد الزفزافي أن الكرامة ليست شعارا أجوف. بل هي مطلب متجذّر في وعي الناس. وأن الوطنية ليست حكرا على مؤسسات الدولة وخُدّامها، بل يعيشها المواطن في لحظات الفقد كما في لحظات الفرح. وأن الريف، الذي قاوم قرنا من التهميش والعنف، لا يطلب سوى أن يُعامَل كجزء كامل من المغرب، لا كملف أمني مفتوح بشكل دائم.
لا أحد ينتظر اليوم اعترافا بالذنب من هذا الطرف أو ذاك. وكل ما نحتاجه هو نقد ذاتي.
على الدولة أن تسأل نفسها: ماذا جنت من رمي شباب بالنزعات الانفصالية؟ وماذا استفدنا من شيطنة احتجاجٍ اجتماعيٍّ انتهى إلى أحكام قاسية زادت الفجوة اتساعا؟ وعلى القوى السياسية أن تنظر في المرآة: كيف تحولت إلى أدوات في لعبة التأزيم بدل أن تكون وسطاء في الحلول؟
إن المصالحة التي نحتاجها لا تختزل في إطلاق سراح ستة معتقلين، رغم أن ذلك ضرورة أخلاقية وسياسية مستعجلة. بل المصالحة الحقيقية تعني القيام بمساءلة صريحة لما نُفّذ وما تعثر من مشاريع “منارة المتوسط”، وإدماجا حقيقيا للريف في البنية الوطنية عبر طرق، وجامعات، واستثمارات، وموانئ صغيرة تربط البحر بالبر، واعترافٌ بالحق في التعبير والاحتجاج والتغطية الصحفية، بدل سياسة التلبيس والتشهير، إلى جانب سياسات ثقافية تعترف بذاكرة المكان ولغته، وتُعيد للمغاربة ثقتهم في أن الدولة لا تعاقب الاختلاف، بل تستوعبه.
لقد مدّ ناصر الزفزافي يده يوم جنازة والده بخطاب وطني صريح. والكرة الآن في ملعب الدولة. ليس لأن الإفراج عن ستة معتقلين سيُغيّر وجه المغرب، بل لأن استمرار الملف مفتوحا هو حجر ثقيل يجثم فوق صدر الوطن.
الخيار واضح: إما أن نغتنم هذه اللحظة ونحوّل الجرح إلى فرصة لبناء مصالحة سياسية وتنموية وثقافية شاملة، أو نتركه مفتوحا ليصبح وصمة تلاحقنا في الداخل والخارج.
إنه وقت النقد الذاتي والشجاعة السياسية. وقت ينبغي أن تعترف فيه الدولة أن الانسحاب من مسؤولياتها الاجتماعية وتغليب المقاربة الأمنية كان خطأ استراتيجيا. وأن عجز القوى السياسية عن الوساطة ساهم في تحويل الأزمة إلى مأساة.
لقد رحل أحمد الزفزافي وترك وصيته الصامتة: لا تتركوا الريف يذبل في العزلة. فلنغتنم هذه اللحظة. ليس انتصارا لطرف على آخر، بل انتصارا لوطن يحتاج أن يدخل استحقاقاته المقبلة ببيت داخلي بلا تصدّعات.