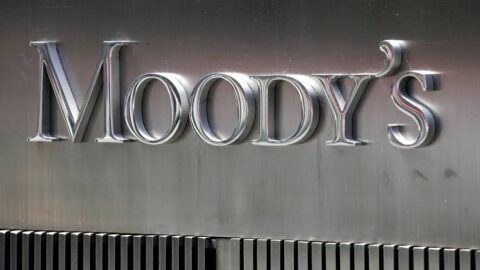الإنسان.. حفلة الهامش وجنازة القلب

هناك العديد من المواضيع الجيوسياسية والماكرو اقتصادية التي تحيط بنا وتستحق أن تناقش، لكنني اليوم أقترح أن ننظر إلى العالم من حولنا من زاوية “أرض-أرض”، أي من الأسفل ونحو أنفسنا، من خلال مجموعة من القصص…
هذا العالم من حولنا لا يفتقر إلي القصص. لكنها ليست قصصا نرويها لكي ننسى، بل وقائع تتراكم لتوقظ فينا سؤالا مرا: ماذا حدث للإنسان؟ وكيف صار هذا الكائن نفسه هو من يُنقذ ويقتل، يُغنّي ويُقمع، يُصفّق ويجلد الميت؟
في غضون أسبوع واحد فقط، خمس وقائع متفرقة على خارطة العالم، لكنها متشابكة في ما تقوله عن طينتنا البشرية، وعن هذا الكائن المتناقض الذي يسمّى “الإنسان”.
• في غزة، الموت لا يحتاج إلى دليل. طائرات إسرائيل تمطر الأرض بغضب الأسياد، والدم يتدفّق أنهارا، والجوع يلتهم الكبار والصغار.
يوم أمس فقط، 3 أبريل 2025، مدرسة دار الأرقم بحي التفاح، التي تحوّلت إلى ملاذ مؤقت لعائلات مشرّدة، لم تعد إلا ركاما يضم أجساد أكثر من 20 إنسانا، بينهم أطفال صغار، بالكاد أدركوا أن هذه الجدران التي احتموا بها، لن تحميهم من سماء يختبئ فيها القتلة.
قبلها بيوم، قُصف مخيم النصيرات، وارتفعت الشهادات لا كأرقام، بل كصرخات من بقي على قيد الحياة. الأمهات يحملن الأطفال ويمشين فوق أنقاض البيوت، والآباء ينقلون الأشلاء في البطانيات، بعد أن فشل العالم في تقديم كفن يليق بهم.
أما مستشفى الشفاء، الذي بات اسما على غير مسمى، فقد صار مسرحا لمجزرة، بعد أن اقتحمته القوات الإسرائيلية في 28 مارس وقتلت ما لا يقل عن 200 شخص، بينهم مرضى وأطباء ومُسعفون.
نعم، حتى من كانت مهمتهم إنقاذ الأرواح صاروا أهدافا للقنص والدفن في مقابر جماعية، كما كشفت الأمم المتحدة في اليوم الأول من أبريل… يوم العيد العالمي للكذابين.
وفي 3 أبريل مجددا، قُصفت منازل عائلات بأكملها في خان يونس وغزة، وقُتل أكثر من 55 شخصا دفعة واحدة، بلا سابق إنذار، بلا ممر إنساني، بلا نجدة من الأرض ولا غضب من السماء.
هذه ليست حربا، هذه عملية منهجية للإبادة والتطهير العرقي، ومحو مجتمع كامل من الوجود.
لكنها، كما اعتدنا، تُروى في نشرات الأخبار كأنها تفاصيل جوية، لا جرائم إبادة.
• في الجانب السفلي من الكرة الأرضية، كما نتصوّرها على الأقل، وبينما كانت غزة تئن، كانت الحياة تصنع لحظة مختلفة تماما في مدرجات ملعب “لوفتوس فيرسفيلد” ببريتوريا، جنوب إفريقيا.
مباراة في دوري أبطال إفريقيا بين ماميلودي صنداونز والترجي التونسي، تتحول إلى مشهد استثنائي في زمن السقوط الجماعي.
أحد مشجعي الترجي، وقد اشتد التدافع في المدرجات، يتدلى من أعلى الحاجز، وكان قاب قوسين من الموت. حينها اقترب منه خصمه، مشجع صنداونز، اسمه سيبونسيو ماسانغو، ومدّ يده، سمع المشجع التونسي يخاطبه: “أرجوك لا تفعل، عندي ثلاثة أطفال”… ، ظنًا منه أن خصمه قد يدفعه.
لكن ماسانغو، بوجه هادئ وصوت مطمئن، رد عليه: “لن أتركك تسقط، أنا هنا لمساعدتك”، وشده إلى بر الأمان.
تلك اللحظة، التي لا تزيد عن ثوانٍ، كانت كافية لتذكّرنا بأن في هذا الكائن البشري بقية إنسان.
لحظة لا تحتاج إلى بيان ولا قرار أممي، فقط قلب ينبض، ويد تعرف متى تمتدّ لتمنع الموت.
• من الضفة الأخرى للمحيط الأطلسي، جاء خبر رحيل سعيد بنجبلي في بوسطن، فاختلطت المرارة بالحسرة.
سعيد لم يكن فقط مدونا بارزا في بدايات “الويب المغربي”، بل كان أحد وجوه حراك 20 فبراير، ومن الذين رفعوا شعار التغيير وسكنوا الأزقة الافتراضية بحثا عن أمل.
لكن السنوات لم ترحمه، والاضطراب النفسي الذي عاناه –اضطراب ثنائي القطب– أخذه تدريجيا إلى عزلة قاتلة.
في 2 أبريل 2025، عُثر عليه جثة هامدة. وتقول روايات مقربين منه إنه اختار إنهاء حياته بنفسه، بعد سنوات من المعاناة الصامتة.
لكن بدل أن نحزن عليه، أو نصمت احتراما لألم ذويه، خرج البعض يلوّح ببطاقة “الإلحاد”، ويتساءل إن كان سعيد يستحق الدعاء والرثاء.
وكأن المعاناة تحتاج إلى شهادة إيمان، وكأن الانتماء الفكري يُحدّد من يستحق الدموع.
لقد رحل بنجبلي، لكن رحيله فضح هشاشة القيم التي يتغنى بها البعض: لا تعاطف، لا إنسانية، فقط ميزان حسابات إيديولوجي.
• نحط الرحال في بلادنا، وتحديدا في تمارة، قرب العاصمة الرباط، القصة أكثر رمادية، وأكثر تقاطعا مع عقدة السلطة فينا.
امرأة، حامل في شهرها الثالث، تتشاجر مع رجل سلطة محلي. لا نعرف ما إن كانت البادئة، أو كانت الضحية. ما نعرفه أن كاميرا التقطت اللحظة التي صفعت فيها القائد، وتم تداولها على نطاق واسع.
لكن ما لم تقله الكاميرا، قاله ملف محاكمتها: ربما كانت قد تعرضت للضرب أو الاستفزاز أولا، وإنها دخلت السجن وهي تنزف، وفقدت جنينها بين الجدران.
في جلسة 3 أبريل، شكّك الدفاع في شهادة طبية قدمها القائد، كتبتها طبيبة متخصصة في “طب الشغل”، لكنها منحته فترة عجز تكفي لاعتقال من صفعته:30 يوما، وإن كانت الصفعة لم تخلّف سوى احمرارا في الخد.
استعملت الطبيبة كلام القائد وكتبته بقلم حبر أزرق في الشكاية، إنه يشعر بالصدمة والإهانة لأن امرأة صدمته، ولا يرغب في الالتحاق بمكتبه… إنه مكتئب.
سألنا متخصصا في الطب النفسي، فقال إن من غير الممكن لأي طبيب غير متخصص أن يقدّر العجز الناجم عن الضرر النفسي…
دفاع المتهمة طلب استدعاء الطبيبة ومتابعة المرأة في حالة سراح.
لكن القضاء قرر التأجيل، والسيدة باقية رهن الاعتقال، تحمل تبعات الجنين المفقود، و”صورة فيسبوكية” حولتها من مواطنة إلى خطر على الأمن العام.
هناك قانون ومحكمة سيناقش الأمر، لكن عذرا: لماذا اعتقال الزوج وشقيقه؟ ألا يوقعنا الأمر في شبهة التنكيل بالطرف الضعيف في المواجهة؟ ألسنا مهددين بفخ السلطة التي تنتقم لرموزها وتخضع القانون لرغباتها؟
• سوف لن نأتي بقصة من أوربا، لكننا سنقترب منها كثيرا، ونحط الرحال في طنجة، مدينة الجمال المعلق بين بحرين..
هناك قرر منظمو احتفالات العيد أن يقدموا حفلا شعبيا مفتوحا للأطفال والعائلات.
لكن على الخشبة صعد فنان غنى بإسهاب عن “كاسي العامر” و”القرعة” و”السكرة الزوينة”، أمام جمهور يضم أطفالا لا يعرفون بعد الفرق بين العصير والخمر.
الواقعة أثارت صدمة وغضبا مشروعين، واستدعت ردودا قاسية، منها من طالب بسجن المغني، وقد استجيب لهم، ومنها من دعا إلى محو كل من يمثّل “الذوق الهابط”.
لكن، في خضم الصدمة، علينا أن نُمسك العصا من الوسط: نعم، ما حدث انحدار مروع، ودليل على انهيار الذوق والتوجيه والتربية. لكن لا، ليس الحل هو الاعتقال، ولا كتم الأصوات بالقوة.
الغناء، حتى حين يكون مبتذلا، هو تعبير. والرد عليه يكون بالنقد الفني ودعم الفن الراقي، لا بالزجر الأمني.
من نلوم؟ المغني؟ أم الجهة التي منحته المنصة؟ أم نظام تربوي يستهلك التفاهة بلا مقاومة؟
كل هذه القصص – من غزة إلى طنجة، من بريتوريا إلى تمارة، ومن بوسطن إلى أجهزتنا – تفضح تناقض الإنسان.
هو الكائن الذي يقتل بالرصاص، ويُنقذ باليد.
هو الذي يغني للخمر، ويجلد الموتى، ويعتقل الحبالى.
كائن هشّ، متردّد بين رحمة بداخله، ووحشية يفرزها ضعفه أمام السلطة أو الغضب أو الحقد.
إننا لا نحتاج إلى حكم، بل إلى مرآة.
لا نطلب عقابا، بل وعيا.
لعلّنا، وسط هذا الضجيج، نتوقف لحظة لنسأل: أي نوع من البشر نحن اليوم؟
وما الذي يمنعنا من أن نكون أفضل… قبل أن يفوت الأوان؟