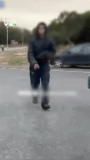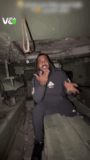الفعالية قبل الديمقراطية

لا تبدو السنة 26 من حكم الملك محمد السادس مختلفة كثيرا عن السنوات التي سبقتها، من حيث استمرارية الوقائع والمواقف والأفعال، بحيث لا يمكن الحديث عن قطائع كبرى، أو تقلبات جوهرية في الخيارات والسياسات.
منذ بداية حكم الملك محمد السادس كانت الطموحات والانتظارات تتوقع قطعا مع السلطوية والانتقال نحو الديمقراطية. وفي العقد الأول، اشتد التنافس بين تصورين؛ من جهة أولى، دلّت وقائع كبرى مثل تجديد الثقة في حكومة اليوسفي، ثم لحظة الإنصاف والمصالحة، ومبادرات إصلاح المدرسة والأسرة والأمازيغية، على طموح مهم، عبّرت عنه خطابات ملكية بـ”المجتمع الديمقراطي الحداثي”.
لكن محدودية نتائج تلك المبادرات، وحاجة الملك الجديد إلى شرعية الإنجاز، ثم الحرب على الإرهاب، أظهرت وجود طموحات موازية، لا تتقاسم بالضرورة السعي نحو الديمقراطية.
بعد سنة 2007، وصف باحثون كل مبادرات وبرامج العقد الأول، بأنه تعبير عن الرغبة في “تجديد للسلطوية” أكثر مما عبّر عن الرغبة في الانتقال عن الديمقراطية. ولعل تعيين إدريس جطو وزيرا أولا ثم تأسيس حزب الأصالة والمعاصرة لاحقا قد عبر عن ذلك الانحراف بوضوح.
خلال العقد الثاني، زعزعت احتجاجات “الربيع العربي” التوجهات السابقة، وفرضت أجندة جديدة على رأسها دستور جديد، وحكومة يقودها حزب معارض من خارج النسق القيمي للنظام، لكن الإصلاح الدستوري لم يؤد إلى إصلاح سياسي، بحيث ظل توازن القوى مختلا لصالح المؤسسات العميقة (الأمن، الاقتصاد، القضاء…)، بدليل أن الاستراتيجيات الأساسية للدولة ظلت تنبع من غير المؤسسات المنتخبة، وبالتالي لا تخضع للنقاش العمومي الحر، بل تقيّم بناء على فعاليتها في الواقع.
ورغم المقاومة التي أبدتها الأحزاب والمجتمع المدني من أجل أن تستعيد السياسة بريقها، خصوصا خلال الولاية الحكومية الأولى بعد دستور 2011، إلا أن تداعيات السياق الإقليمي مرة أخرى، ونتائج ذلك المسار نفسه كانت دون التوقعات إن لم تكن أسوأ، بدليل التدبير العنيف لحراك الريف ثم ما جرى في انتخابات 2021 من ممارسات أسفرت عن مؤسسات مغشوشة.
دخل المغرب العقد الثالث من القرن الحالي في ظلال وقائع غير سياسية، مثل جائحة كورونا ثم زلزال الحوز، والتي كشفت عن مدى الاختلال القائم في ميزان القوى بين مؤسسات الدولة المعيّنة ومؤسساتها المنتخبة، كما أنها شكلت فرصة للمؤسسات العميقة في الدولة لتأكيد قوتها وفعاليتها إزاء هامشية المؤسسات المنتخبة.
وبينما يؤكد الأكاديمي عبد الله ساعف ما حصل منذ جائحة كورونا بأنه “عودة للدولة القوية”، تحدث الأكاديمي عبد الحي المودن عن “فعالية الدولة”، حيث باتت الفعالية خيارا مفضلا للدولة في مقابل خيار المساطر الديمقراطية، كيف حدث ذلك؟
وتندرج السنة 26 من حكم الملك محمد السادس إذن ضمن مسار تعزيز “فعالية الدولة”، في مقابل تراجع الميول نحو الديمقراطية، ليس بمعنى تكريس هامشية المؤسسات المنتخبة فقط، بل السيطرة عليها من قبل قوى غير حزبية، مثل الأعيان ورجال الأعمال والتكنوقراط، كما تؤكد ذلك مخرجات انتخابات 2021. وهي اختيارات ليست وليدة السياق المغربي فقط، بل نتيجة ظروف دولية وإقليمية كذلك.
إذا عدنا إلى التوصيف المعمول به في خطابات بعض الفاعلين والباحثين، فإن العبارة المستعملة لوصف الوضع هو “أزمة السياسة”، بما هي أزمة فاعلين وأزمة ممارسة كذلك. فعلى المستوى الحكومي، مثلا، تتجلى الأزمة في غياب التواصل العمومي.
ويحلل علي اليوسفي علوي، الوضع القائم بالقول: “هناك وجود مؤسسات تشتغل، لكنها لا تتواصل”. ما يعني أن الأزمة عنده أزمة تواصل سياسي، أي غياب النقاش العمومي حول السياسات والقرارات، بسبب قصور الحكومة في هذا المستوى.
لكن هذا الوضع لا يتعلق بظرفية أو بشخص (أخنوش مثلا)، بل بمسار تشكل نتيجة للظروف التي سادت بعد نهاية الحرب الباردة، والتي أدت إلى تراجع الأحزاب الاشتراكية واليسارية، وصعود خطاب العولمة والليبرالية الجديدة.
وفي المغرب، كان لتلك التحولات، إلى جانب عوامل ذاتية مرتبطة بالثقافة الحزبية وطبيعة النظام السياسي، أثر في تفتيت المشهد السياسي تدريجيا، وهو وضع يمكننا ملاحظته في السياق المغربي، كما عاشته فرنسا منذ بداية الألفية، ودول أخرى.
ولعل من النتائج الملموسة لهذا المسار، “وجود أزمة اقتناع بجدوى الحزب السياسي في حد ذاته” بحسب اليوسفي علوي، انعكس على أزمة الممارسة كذلك. فمن المعلوم أن وظيفة الحزب في علم السياسة تتمثل في وظيفتين رئيسيتين هما: التأطير والتمثيل. لكن الملاحظ أن الأحزاب المغربية انسحبت، في مجملها إلا استثناء، من وظيفة التأطير.
وفي الوقت نفسه تبدو حريصة على القيام بوظيفة التمثيل، علما أن التمثيل يتأسس على التأطير وليس العكس. هذا القلب في الوظائف أدى بالحزب إلى الانفصال عن قواعده. غير أن هذه التشخيص لا يقتصر على الأحزاب، في نظر علي اليوسفي علوي، بل يطال النقابات والجمعيات كذلك، فالقطع مع القواعد بات مثل مرض أصاب الجميع.
ومن نتائج ذلك، الإصابة بأمراض أخرى، مثل عزلة المؤسسات التمثيلية عن الشعب، بحيث تبدو الحكومة والبرلمان منفصلان عن الواقع السياسي، وقائمة في أفضل الأحوال على إرادة الأعيان وشبكاتهم الاجتماعية، وليس على إرادة المواطنين.
لم يعد الحزب مشروعا للتغيير السياسي، وبالتالي للحكم. بل جرى تأطير الهدف منه في “المشاركة في الحكومة”، كما يقول الجامعي والسياسي، محمد الساسي، ويعبّر ذلك عن “تحول في طبيعة العمل الحزبي”.
يستشهد الساسي بتصريحات قادة أحزاب سياسية مثل عباس الفاسي الذي صرّح بعد تعيينه وزيرا أولا بأن برنامجه هو “برنامج جلالة الملك”، في حين أكد عبد الإله بنكيران باستمرار بأنه جاء لـ”يساعد جلالة الملك” في الحكم، وهو توجه أفضى في النهاية إلى القبول بـ”برنامج الملك”، ما جعل برامج الأحزاب “نسخة مكررة” لبعضها البعض، وجعل من التنافس فيما بينها ليس حول الخيارات والسياسات، بل حول من يطبق برنامج الملك أفضل من غيره، وفي القرب منه كذلك.
والواقع أن أزمة السياسة تشكلت تدريجيا خلال العقدين الماضيين، بالرغم من الديناميات التي عرفها المغرب منذ بداية حكم الملك محمد السادس، حيث جرى الحديث عن “الانتقال الديمقراطي” وطموحه بناء “مجتمع ديمقراطي حداثي”، ما لبث أن تراجع تحت تأثير الحملة العالمية على الإرهاب، ومقاومة البنيات السلطوية للإصلاحات السياسية والاقتصادية.
لاحقا، أعطت احتجاجات “الربيع العربي”، في مطلع العقد الثاني من القرن الحالي، دفعة نوعية للخطاب حول الديمقراطية وحقوق الإنسان، خصوصا وضع دستور جديد في المغرب اعتبر الاختيار الديمقراطي ثابتا من ثوابته، لكن تلك المكتسبات على مستوى النصوص لم تغيّر كثيرا في موازين القوى الواقعي، والدليل على ذلك أن الخيارات الاستراتيجية التي تتبناها الدولة ظلت تنبع من خارج المؤسسات المنتخبة، ولا تخضع للنقاش العمومي الحر.
وقد ساعد السياق الإقليمي المناهض لمخرجات الربيع العربي، ثم السياق الوطني بأحداثه المرجعية، خصوصا حراك الريف ثم جائحة كورونا وزلزال الحوز، في تعميق الاختلال القائم في ميزان القوى بين مؤسسات الدولة المعيّنة ومؤسساتها المنتخبة، وكشفت عن انحياز واضح للدولة نحو “الفعالية” في مقابل تهميش المساطر الديمقراطية.
ويمكن القول أنه مع بداية العقد الثالث من حكم الملك محمد السادس، تطور الوضع السياسي في المغرب نحو معادلة واضحة وصريحة “الفعالية بدل الديمقراطية”. ولعل ما يعزز هذا التوجه مغربيا، أزمة الديمقراطية في العالم كذلك.
ومنذ 2016، بات مفهوم “التراجع الديمقراطي” يُستعمل عالميا لوصف أزمة الديمقراطية في بلدان كثيرة من الشمال والجنوب العالميين، بل إن التراجع سجّله مؤشر الديمقراطية لـ”الإيكونوميست” في بلادها الأصلية مثل أوربا الغربية وأمريكا الشمالية، وهي الأزمة التي باتت تعبر عنها ظاهرة الشعبوية، التي ترفع شعارات لا تتعارض مع المبادئ الديمقراطية فحسب، بل تكشف عن محدودية النموذج الديمقراطي الليبرالي نفسه.
وتشكل الشعبوية تحديا للديمقراطية، وتمكن لسياسات القوة في مقابل تراجع حكم القانون وسلطة القيم. بهذا المعنى تساهم في تكسير جاذبية النموذج الغربي. ومن شأن الصراع القائم بين النظام الدولي الليبرالي بقيادة أمريكا، والنظام الدولي البديل الذي تنشده القوى الدولية الصاعدة مثل الصين وروسيا، أن تعزز من مساحة المناورة لدى دول الجنوب، بل أن تهمش النموذج السياسي الديمقراطي، وأن تعمق من أزمته، لصالح النموذج القائم على الفعالية والجدارة والكفاءة التقنية.
ورغم أن الصراع بين النموذجين لم يسفر بعد عن نتيجة حاسمة، إلا أن المغرب يبدو قد حسم خياره لصالح النموذج الثاني منذ بداية العقد الثالث على الأقل، وتشكل السنة الجديدة في حكم الملك محمد السادس محطة أخرى في تعزيز فاعلية النموذج نفسه، بدليل الملاحظات التالية:
- هيمنة البرامج والمشاريع الملكية المهيكلة للسياسات العامة للدولة، مثل مشاريع كأس العالم 2030، ومشاريع الدولة الاجتماعية والتنموية، وبعض الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالمقاولات الاستراتيجية والمالية العمومية، وهي مشاريع خارج النقاش العمومي، محاطة بهالة من التعبئة وحتى التقديس، لا تقبل التشكيك أو النقد. تبدو الحكومة في هذا السياق، مجرد تلميذ نجيب يجتهد في التنزيل والتنفيذ، وليس مقبولا منه إعادة النظر في الأولويات مثلا أو التصرف وقف المتاح ماليا وقانونيا وشعبيا. تمنح تلك البرامج والمشاريع الكبرى للدولة موقعا ومكانة مركزية، تبدو معها الأكثر فعالية، والأكثر قوة ونفوذا وصلابة.
- تتراجع مكانة مختلف الفاعلين، سواء الأحزاب أو النقابات أو الجمعيات أو حتى الأفراد، بحيث تحتل مواقع تكميلية أو ثانوية، وحتى هامشية. يتساوى في ذلك الفاعلون من داخل المؤسسات المنتخبة أو المعارضون للنظام من خارجها. في المجمل، تبدو برامج هؤلاء الفاعلين صغيرة، مشتتة ومحدودة، بل متواضعة. واللافت كذلك، أن القوى المتنافسة في الحكومة أو في المعارضة، توجه قدرا كبيرا من جهودها للدفاع عن أهليتها في تنفيذ برامج الملك، أكثر مما تتنافس في إبداع أفكار وحلول بديلة. ولهذا السبب، أصبحت البرامج الحزبية متشابهة من حيث الخيارات والأولويات التي تظل ملكية بامتياز، وإن كانت تختلف في الإجراءات والتدابير التقنية، ما يجعل العروض متشابهة رغم الانقسامات القائمة لأسباب تاريخية أو إديولوجية.
- سجل الأستاذ عبد الله ساعف، في سنة 2024، أن المشاريع الكبرى والمثيرة للدولة (في قطاعات البنية التحتية، والفلاحة، والتكوين المهني، والحماية الاجتماعية، والمياه، والطاقات المتجددة، والصناعات، والتكنولوجيا الرقمية، وغيرها) تتجاوز المشاريع التي يمكن إطلاقها من قبل الفاعلين السياسيين الآخرين الذين يبدو أن قدراتهم على ابتكار وتصور وإنتاج مشاريع – برامج وتنفيذها يتم عرقلتها من قبل المبادرات الهائلة للدولة. وهي مبادرات صار لها طابع استباقي وتجديدي أكثر من أي وقت مضى. وبالتالي أصبحت توجهات واستراتيجيات وبرامج الدولة تجعل من مشاريع ومرجعيات وبرامج ورؤى الأحزاب السياسية وباقي الفاعلين ثانوية، بل تافهة. إن المستويات التي بلغها عمل وحركية الدولة تتجاوز الآن مستويات نظيراتها السابقة. ويبدو أن عصر البرامج الأيديولوجية والمذكرات المطلبية والبرامج الانتخابية (التشريعية والمحلية) قد انتهى. وأدوات العمل القديمة التي كان معمولا بها فقدت من جاذبيتها. ملاحظة الأستاذ ساعف تبدو صالحة في سنة 2025 كذلك، فالمسار هو نفسه ماض ويتقدم.
- بالرغم من تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين، نتيجة ارتفاع الأسعار ونسبة التضخم وارتفاع نسب البطالة وتوالي سنوات الجفاف، إلا أن دينامية الاحتجاج في تراجع خلال السنوات الأخيرة. وهي مفارقة لافتة، تفسّر في الغالب بـ”عودة الدولة” عبر فاعلية عمل الأجهزة الأمنية، والمؤسسات الاجتماعية والثقافية الأخرى. وعموما، مرت السنة 26 من حكم الملك محمد السادس بدون احتجاجات كبرى، رغم السخط الاجتماعي الملموس في وسائل التواصل الاجتماعي إزاء السياسات الاجتماعية لحكومة أخنوش. وعموما، تظهر الاحتجاجات التي سجلت منذ غشت 2024 حتى يوليوز 2025 (مسيرات العطش، مسيرة آيت بوكماز، الاحتجاجات النقابية….) عن محدودية واختلالات في السياسات الاجتماعية للدولة، التي أظهرت أكثر من مرة أن المشكل لا يتعلق بمحدودية في الموارد.
- رغم التعقيدات في السياق العالمي والإقليمي، كما يعبر عن ذلك حرب الإبادة الجماعية في غزة، وجرائم التهجير القسري في الضفة والقدس، ثم الحرب على لبنان وسوريا وإيران، وقبل ذلك التصعيد الجزائري منذ حادثة الكركرات في نونبر 2020، يبدو المغرب ملتزما سياسة حذرة ومحتاطة، لإدراكه أن التحولات الجارية في العالم وفي المنطقة سيكون لها انعكاس على تموقعه الجيوسياسي وخياراته الاستراتيجية.
في هذا السياق، باتت قضية الوحدة الترابية للمملكة هي البوصلة المحددة والموجهة للسياسة الخارجية. وقد تم الإعلان بوضوح معايير جديدة في تدبير المغرب لعلاقاته الدولية، تقوم على الموقف من وحدته الترابية أساسا.
وقد حقق هذا النهج مكتسبات ثمينة للمغرب، تواصلت خلال سنة 2025 (فتح قنصليات في الصحراء، الاعتراف بالسيادة على الصحراء أو دعم الحكم الذاتي أساسا للحل…)، وهو مسار تعزز خلال هذه السنة بالموقف الفرنسي والبريطاني، وبمواقف دول افريقية وازنة مثل كينيا واثيوبيا، وبمواقف دول أخرى في أمريكا اللاتينية مثل الشيلي ونيكاراغوا.
- في هذا السياق كذلك، جرى التعاطي مع مشاريع “صفقة القرن” الأمريكية، مثل “اتفاقات أبراهام”، والتي ربطت بين اعتراف أمريكا بمغربية المناطق الجنوبية وبين إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وهي صفقة لم تتضرر كثيرا بسبب جريمة الإبادة الجماعية في غزة والعدوان البربري على فلسطين ولبنان وسوريا وإيران، رغم التأكيدات المتواصلة من الملك والحكومة على الموقف المغربي من القضية الفلسطينية. من المؤكد أن المغرب يستشعر تناقضا واضحا، فالتزاماته مع أمريكا وإسرائيل باتت تؤثر سلبا على التزاماته مع القضية الفلسطينية، وهو تناقض لا ندري كم سيستمر من الوقت، وتحت أي ظروف يمكنه الحسم في اتجاه أحد الخيارين، خصوصا وأن الشارع المغربي لم يتوقف طيلة سنتين تقريبا عن الاحتجاج للتعبير عن التضامن مع غزة وفلسطين.
خلاصة القول أن السنة 26 من حكم الملك محمد السادس عززت أكثر من الخيارات الاستراتيجية للدولة، القائمة على الفعالية والجدارة، بينما تتراجع الميول نحو الديمقراطية. وهي مفارقة تعزز من الشعور بأزمة السياسة داخليا، التي تجعل من مختلف الفاعلين (الأحزاب، النقابات، المجتمع المدني…) على هامش الفعل والقرار العمومي، بينما تفتح الطريق أمام القوى غير الحزبية لمزيد من السيطرة على مراكز القرار، بما في ذلك على المؤسسات المنتخبة. لكن مع هذا الوضع الداخلي، لا يمكن إنكار المكتسبات التي يحققها المغرب كدولة، باتت تعزز وترسخ من مكانتها الإقليمية والدولية على نحو متواصل، والتي تجعل منه قوة صاعدة على المستوى الإقليمي، كما سبق أن حدد ذلك لنفسه قبل سنوات.
لقراءة الملف الكامل الذي خصصته مجلة “لسان المغرب” لهذا الموضوع في عددها الـ75، يرجى الضغط هنا