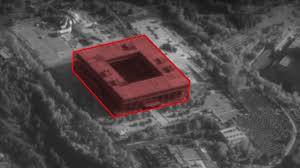أحمد الزفزافي.. الظل الأخير

نودّع اليوم رجلا لم يكن مجرّد أب يبكي ابنه القابع خلف قضبان السجون، بل كان رجلا حمل على كتفيه جرح المغرب كلّه، وسار به في مسالك الرباط والدار البيضاء وباريس ومدريد، ليقول للعالم إن في هذا الوطن بقعة تنزف منذ زمن طويل.
نودّع الرجل الذي كان صوته يختصر أنين الأمهات ودموع الآباء وحنق الشباب المحبط. رحل ولم يجن من الدنيا سوى لقب لم يختره: “أب الحراك”.
ومع رحيله، لم تفقد عائلة الزفزافي وحدها سندها، بل فقد المغرب كله أحد آخر الشهود الكبار على مأساة لا نزال نكابر في الاعتراف بعمقها.
لم يكن أحمد الزفزافي مجرّد والد معتقل سياسي، ولا كان رجلا يطلّ على الناس من باب العاطفة الأبوية الضيّقة، بل صار في السنوات الأخيرة وجه المغرب المظلوم، وصوت وجعه، وحارس ذاكرة جرح لم يندمل بعد.
رحل الرجل يوم أمس الأربعاء 3 شتنبر 2025، بعد صراع مرير مع المرض، ومع الغبن والقهر.
رحل وقد نذر ما تبقّى من عمره لحمل قضية ابنه ورفاقه على كتفيه، كما لو أن الريف كلّه صار أبناءه.
حين اندلعت شرارة الاحتجاجات والاعتقالات والمحاكمات في الحسيمة عام 2017، كانت البلاد أمام امتحان عسير، وانتهى المشهد بأحكام قاسية.
في قلب تلك العاصفة، ظهر أحمد الزفزافي، وقد تجاوز السبعين، رجلا نحيل الجسد، لكن روحه مشتعلة، كأن العمر كله اختُصر في تلك اللحظة. لم تمنعه شيخوخته ولا أوجاعه من أن يقطع المسافات المرهقة بين الحسيمة والرباط والدار البيضاء، رحلة أسبوعية على طرق ملتوية، ليجلس على مقاعد المحاكم التي تحولت إلى مسرح لأكبر قضية سياسية في العقدين الأخيرين.
كان أحمد يرفع رأسه عاليا في كل جلسة، يواجه التّهم بوجه متجعّد من أثر السنين، لكنه صلب كجبل الريف. لم يساوم ولم يلن، وكان صوته يخرج صافيا لا يهاب، محمّلا بصدق الفلاحين البسطاء ومرارة الريفيين المهمّشين: أبناؤنا ليسوا مجرمين، أبناؤنا يطالبون بالكرامة.
تحوّلت تلك العبارة إلى شعار يتردّد خارج أسوار المحكمة، وإلى مرآة عكست حجم الفجوة بين ما وقع في الشارع وما يُكتب في محاضر التحقيق.
لقد جسّد أحمد، في تلك اللحظات، ما يشبه الدور التاريخي للآباء حين ينهضون للدفاع عن أبنائهم، لكنه تجاوز الأبوة الفردية إلى أبوة رمزية، حمل فيها أبناء المغرب المهمّش جميعا على كتفيه.
كان صوته شهادة مضادة في مواجهة رواية رسمية ثقيلة، وكان حضوره شاهدا على أن هؤلاء المعتقلين لم يأتوا من فراغ، بل هم ثمرة أرض مهملة وأجيال مسحوقة. ومن خلاله، بدا أن جزءا من المغرب وقف أمام العالم، يطالب بحقه في الكرامة قبل أي شيء آخر.
كان جسده يشيخ كل يوم، لكن صوته ظلّ فتيا، يجلجل في القاعات وفي الشوارع، وفي تصريحات للصحافة الوطنية والأجنبية، حتى تحوّل الرجل إلى رمز من رموز الحراك، إلى الحدّ الذي أحرج معه الدولة والمجتمع معا. نعم، لقد أحرجنا أيضا كمجتمع، بإصراره وصموده، وكشفه المزدوج لقسوة الدولة وجبن المجتمع.
لقد حمل أحمد الزفزافي عبء حراك بكامله، بعد أن زُجّ بأبنائه في السجون. كان يعرف أن صمته خيانة، وأن استسلامه إعدام مزدوج: إعدامٌ لابنه، وإعدامٌ لذاكرة حراك الريف.
هكذا صار الرجل مدرسة في الصمود، يُذكّر من يعرفون التاريخ بحكايات الآباء الريفيين الذين وقفوا في صفوف عبد الكريم الخطابي قبل قرن من الزمن.
لم يكن صدفة أن يكون سليل أحد وجوه المقاومة الريفية، ولا أن يرث أحمد تلك الصلابة التي لا يلين عودها.
قليلون هم الذين يقدّرون ثقل ما فعله هذا الرجل. فهو لم يكن يُدافع فقط عن ابنه ناصر، بل عن معنى الأبوة في أسمى صورها: أبٌ يرفض أن يُسلَّم أبناءه للمقصلة، أبٌ لا يبيع أولاده في سوق المساومات، أب يقف عاريا أمام دولة بكاملها ليقول لها: أنتم تخطئون في حقّنا.
لذلك لم يكن أحمد الزفزافي مجرّد رجل غاضب، بل صار في النهاية أبا رمزيا لجيل كامل حُكم عليه أن يرى أبناءه يذبلون في الزنازين.
وفي موازاة هذا الوجه الملحمي، كان في الرجل وجه آخر: إنسان بسيط، ابن مدشر صغير، لم يكمل تعليمه العالي، عمل مقتصدا في دار للأطفال لعقود، وربّى أبناءه على الصدق والكرامة.
لم يعرف أحمد الزفزافي يوما أن القدر سيجعل منه أيقونة وطنية. لكنه واجه قدره كما يليق بالرجال: بجرأة وهدوء، وبعناد وصبر، وبدموع لم يخفها، وبأمل لم يتخلّ عنه.
اليوم، ونحن نودّع أحمد الزفزافي، لا نودّع رجلا عاديا. بل نودّع آخر الحرّاس الكبار لقضية معتقلي الريف، الرجل الذي حافظ على شعلة الحراك مشتعلة حتى في أصعب اللحظات، وحمى ذاكرة أبنائه من التزوير والنسيان.
رحيل أحمد الزفزافي يضعنا أمام سؤال ثقيل:
ماذا سنفعل بكل هذا الإرث من الألم؟
وهل سنواصل طريق التجاهل، أم سنجرؤ أخيرا على تضميد الجرح؟
ليس من الإنصاف أن يظل المغرب عالقا في مشهد 2017، ولا أن تبقى السجون شاهدة على عجزنا الجماعي عن إيجاد مخرج كريم.
لقد رحل أحمد الزفزافي، لكن صوته ما يزال يتردّد فينا: العفو ليس ضعفا ولا هزيمة، بل شجاعة كبرى وحكمة تاريخية. والمبادرة بمدّ اليد والمصالحة ليست تنازلا، بل تأسيس لوطن جديد يملك أن يواجه المستقبل بلا أشباح الماضي.
إن المغرب لا يمكن أن يمضي إلى الأمام وهو يحمل قضية كغصّة عالقة في الحلق، وجراحا مفتوحة في الوجدان.
قد يطوي الموت صفحة جسد أحمد الزفزافي، لكنه ترك لنا وصية صامتة، أثقل من كل الكلمات:
“لا تتركوا أبناء هذا الوطن يسحقون بين الجدران، ولا تتركوا الريف يذبل في العزلة. افتحوا أبواب الأمل، بالعفو الجميل، وبمشروع سياسي وتنموي يلمّ الشمل ويعيد الثقة، ويستعيد المعنى الذي ضاع حين ضاعت الكرامة”.
في النهاية، غاب الرجل، لكن الحكاية لم تنته. بقيت صورته ماثلة في قاعات المحاكم، وصوته الجريح وهو يردّد: “الحرية لأبنائنا”.
رحل أحمد الزفزافي تاركا وراءه ما يشبه الظل الأخير الذي كان يقي أبناءه ورفاقهم من النسيان، ويمنح المغاربة مرآة يرون فيها وجوههم الحقيقية.
برحيل عيزي أحمد ينكسر ذلك الظل، فنجد أنفسنا في العراء، مكشوفين أمام سؤال لا مفرّ منه: هل نترك غياب أحمد يفتح الباب لغياب الذاكرة، أم نحوّله إلى بداية حضور جديد، أكثر شجاعة وأقوى صدى؟
إن رحيل أحمد الزفزافي ليس نهاية، بل دعوة لأن نصير جميعا ظلالا واقفة تحمي هذا الوطن من أن يذبل في صمته الطويل.