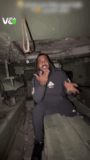صورة زيان.. صناعة الخوف
كذّب أشرّ ومنافق كبير من يزعم أنه شاهد تلك اللقطات التي يظهر فيها الوزير ونقيب المحامين السابق محمد زيان، وهو يِساق من طرف زمرة من عناصر الدرك الملكي، نحو قاعة محاكمته داخل “قصر العدالة” بمدينة الرباط.
ومخادع في حق نفسه قبل غيرها، من يزعم أن تلك النظرات التي بعثها زيان نحو عدسة الكاميرا، لم تخترق جدار فؤاده وتزعزع يقينه وطمأنينته.
الخوف هو عنوان ما خلّفته تلك المشاهد، القصيرة في مدتها، الثقيلة في وزنها، لدى طيف واسع من المغاربة.
أنا وجل من أعرف ممن تفاعلوا مع هذه الصور في السرّ والعلن شعرنا بالخوف، مهما كابرنا وحاولنا محاصرة المشهد في سياقه المسطري القضائي لسجين يِعرض على جلسة محاكمته.
لا شأن لي بالنوايا، ولا أحب ولا أرغب في الحكم عليها، ولا يهمني كثيرا أن أعرف هل الصدفة وحدها وضعت محمد زيان، الرجل الثمانيني الذي صال بين حقول السياسة وتقلّب بين المناصب وتردّد بين الحكم والموالاة، أمام عدسة الصحيفة التي يعتبر هو مؤسسها، ليطلّ من خلالها على هذا العالم بنظرة صامتة نطقت بكل الصراخ المعروف على هذا الرجل الاستثنائي.
شعرنا بالخوف، ليس لأن رجلا مشهورا ومرموقا اجتماعيا كان يساق أماما سجينا نحو قفص الاتهام، فالعدالة وِضعت لأجل هذا، والسجن اختراع عقلاني للإنسان، به حاول لجم نزوعاته الشريرة وحماية الجماعة من شر الأفراد.. بل الخوف كله من كون الأمر يتعلّق بمغربي سجين بسبب رأيه السياسي.
نعم، لا لشيء سوى أنه فتح فمه بكلام قد لا يتفّق معه بعضنا، وقد يمجّه بعضنا الآخر، لكنه في النهاية رأي سياسي، وأن نعمد، باعتبار القانون والقضاء تعبير عن إرادتنا الجماعية، إلى سجن أحدنا فقط لأنه عبّر عن رأي سياسي لا يعجبنا أو، لا يعجب بعضنا، معناه أن علينا أن نخاف.
لا يهمني أ تلقائية هي تلك الصورة أم مقصودة ومفتعلة، لكن يهمني أكثر أنها صنعت الخوف. وأن نصنع الخوف بأدوات الدولة، من أمن وعدالة ودرك وقضاء، معناه أننا نوشك أن ننحدر تحت عتبة الحضارة الإنسانية، ونعود إلى ما قبل التاريخ، حين كانت المخلوقات البشرية تساق كالقطعان نحو الحضائر تحت مفعول الخوف من العصا التي تهش عليهم.
خطير ومقلق جدا أن نطوّر في عصر الطاقات المتجددة والصناعات العسكرية وصناعة السيارات وصناعة الطيران… صناعة أخرى يقال لها صناعة الخوف.
هذه صناعة الدول الشمولية والمفلسة والعاجزة عن إنتاج البرامج والمشاريع والأفكار، وتدبير الاختلافات بالحوار والتداول والتحكيم… وأخطر ما تنتجه هذه الصناعة، هو الخوف السياسي.
لست بصدد التطفل على حقل علم النفس الذي يمكنه أن يفيدنا أكثر حول الشعور بالخوف ودلالته ونتائجه، لكن صناعة الخوف السياسي تهمني وتعنيني كمواطن، لأنها تعني سقوط كل ما حلم به جيلي، وأجيال من قبله، بإقامة مجتمع منزوع الخوف، يفوّض تدبير أسباب خوفه إلي دولة يقال لها دولة الحق والقانون.
انتشرت في المكتبات العربية مؤخرا ترجمة عربية لمؤلف أصدره المفكر الفرنسي روبير شارفان حول الخوف كسلاح سياسي، ذهب فيه إلى أن الحكم هو إثارة المخاوف في صفوف المحكومين ثم السيطرة عليهم عبر نشر الاطمئنان.
هو تعريف “بدائي” كي لا أقول “أوّلي” لحكم المجتمعات البشرية، لأن فكرة الدولة الحديثة، بل الحداثة نفسها في أحد وجوهها، وُلدت من الرغبة في تخليص الانسان من الخوف: خوفه من أخيه الانسان، ومن الآخر، ومن الطبيعة، ومن الأمراض والأوبئة… لهذا وِجدت الدولة في عصرنا هذا، أي لتخليص الانسان من الخوف، لا لإخافته.
لا يمكن أن نعاين عملية صناعة سافرة للخوف تجري أمام أعيننا ونصمت. لأن كل العلوم التي تفسّر وتحلل أشكال العيش المشترك للإنسان المعاصر، تخبرنا أن أسوأ ما تقدم عليه الدولة الحديثة هو أن تصنع الخوف.
فعلتها أمريكا كما أسهب حكيمها ناعوم تشومكسي وزملائه في تفسير كيف عبأت حكوماتها وما يعرف ب“لجنة كرييل”، الشعب لحمله على خوض الحروب العالمية، الأولى والثانية، وشاهدنا بأعيننا المجرّدة كيف خصّبت أحداث 11 شتنبر الخوف الكافي لغزو دولة مثل أفغانستان، وسمح الخوف من سلاح كيماوي مزعوم بتدمير دولة مثل العراق، ووفّر الخوف من “الإرهاب” المظلة التي جرت فيها آلاف الجرائم على يد الدول والأنظمة على مدى سنوات طويلة.
الخوف هو سلاح وأداة الحكام الظالمين، المفتقدين للشرعية والعاجزين عن تجسيد الإرادة الجماعية للشعب، وهو أداة تبرير الانتهاكات والتجاوزات والاعتداءات.
الخوف هو ما يحمل الانسان على مشاهدة الظلم والصمت عليه، وهو الذي يسمح للإنسان بتبرئة نفسه والتبرير لها بأنه مجرد أداة في يد غيره.
“عندما لا يكون الجمهور في حالة خوف على وجوده، تكون السلطة خائفة”، يقول الكاتب الإسرائيلي أليكس فيشمان في مقال له على أعمدة صحيفة يديعوت أحرونوت، موضحا لماذا تسعى القيادة السياسية طوال الوقت لبث شيء من الخوف في الجمهور كي تبقيه أسيرا لديها، “فالخوف يضمن تعلق الجمهور بزعمائه”، وبئس التعلّق هو.
الخوف حسب زيجمونت باومان، صاحب كتاب “الخوف السائل” هو الاسم الذي نطلقه على حالة “عدم اليقين” التي نعيشها، وجهلنا بالخطر المحتمل، وما ينبغي لنا أن نفعله لمنع حدوثه.
وهو حسب حكيمة علم السياسة، الألمانية حنة أرندت، “ما يجعل الناس مهيئين للخضوع للسيطرة الشمولية في عالم غير شمولي، هو الحقيقة التي مفادها أن العزلة، التي كانت يومًا ما تجربة يُعانيها المرء عادة في ظروف هامشية استثنائية، أصبحت تجربة يومية لجماهير غفيرة ومتزايدة كل يوم في هذا القرن”، أو كما ورد في كتابها “أسس الشمولية”.
وهو كما تعبّر عنه زميلتها المؤرخة، أوتا فريفرت، في كتابها “سياسة الإذلال: مجالات القوة والعجز”، “ما يجعل كثيرًا من الناس يختارون الصمت تجنبًا للإهانة…”، أو لم نشعر جميعا بوقع الإهانة في صور محمد زيان؟
أو لم تخلّف لدينا ما يُسمّى في علم النفس ب”الجرح النرجسي”؟
ألا تعلّمنا مثل تلك الصور أن نرتدع ذاتيا؟ ونفعل ما تحدث عنه مصطفى حجازي في كتابه “الإنسان المهدور”؟ أي أن يضبط كل منا سلوكه حين يجد أن تصرفه أو حتى تفكيره أصبح ذا كُلفة قد تكون كارثية إن هو تجرأ وأقدم، وقد يصل الأمر إلى ردع النوايا والأفكار؟
مع الخوف يفسد كل شيء،
تفسد الدولة لأنها تصبح مالكة لعصا سحرية توفّر لها الإذعان والامتثال، وبدل أن تبرر قراراتها بالمصلحة والضرورة، تجد في الخوف ما يطلق يدها ويعفيها من المسؤولية وتقديم الحساب. تصبح وهي سيئة قادرة على تبرير وجودها لأنها “تدفع ما هو أسوأ”.
ومع الخوف يفسد الفرد أيضا، إذ يصبح سلبيا ومنعزلا، قابلا بالظلم ومبررا له. يدفعه خوفه إلى الاحتماء أكثر من اللازم فيهلك نفسه، تماما مثلما يفعل الجهاز المناعي للإنسان، حين يفرط في إنتاج المضادات خوفا من خطر خارجي، فيؤدي إلى قتل صاحبه بدل إنقاذه.
أو لم يخبرنا الكواكبي في “طبائع الاستبداد” أن الاستبداد يضطر الناس إلى إباحة الكذب والتحايل والنفاق والخِداع والتذلل ومُراغمة الحس وإماتة النفس؟
قديما قالت العرب في حكاية مأثورة، أن الطاعون همّ بدخول مدينة، فخاطبه صديقه الجذام: “لا تقتل الجميع، بل النصف فقط”.
وعندما خرج الطاعون من تلك المدينة كان كل من فيها قد مات، فسأله الجذام مستنكرا: “لم فعلت ذلك؟”
فرد الطاعون: “أنا قتلت النصف والخوف أمات النصف الثاني …”.