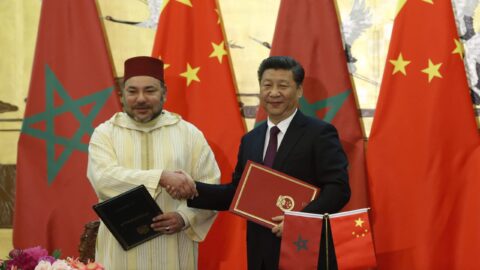العلوي يكرّم وأنوال تنسى

شهدت نهاية الأسبوع الماضي، تصادف حدثين لا رابط مباشر بينهما، لكنهما يعبّران عن واحدة من مفارقات علاقتنا بالذاكرة وصناعة السرديات.
حلّت الذكرى 103 لمعركة أنوال التي انتصر فيها المقاومون المغاربة على جيش الاحتلال التابع لواحدة من امبراطوريات ذلك الزمن (إسبانيا).. وتم الاحتفاء بالمذيع والمنشط التلفزيوني المخضرم، مصطفى العلوي، بالمكتبة الوسائطية لمؤسسة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء.
السيد مصطفى العلوي رجل طيّب وخلوق ولا تملك إلا أن تحبّه كشخص، بمجرد ما تتعرف عليه أو تتواصل معه بشكل مباشر. لكن العبرة هنا بما يرمز له هذا الاسم من حقبة تاريخية وطريقة في التدبير ونهج في التواصل مع المغاربة ومع العالم.
من الناحية التقنية، الرجل مرجعية حقيقية تستحق الاحتفاء والتكريم، بل ولم لا الاستفادة من خبرتها في التكوين والتدريب. لا يمكن لممارس أو متابع لحقل الإعلام أن ينكر المهارة الاستثنائية التي يتمتّع بها هذا الرجل في تطويع اللغة وفي الارتجال وفي إكمال الصورة بتعليق صوتي يخدم الغرض المقصود من التغطية.
لكن المقصود هنا بالمقارنة هو ما قاله السيد العلوي نفسه حين اعتبر نفسه “عبد مشرط لحناك” عند المخزن. هذا هو الرمز الذي جعل بادرة الاحتفاء بشكل متزامن مع ذكرى معركة خالدة خلّفت الكثير من دماء الشهداء وانتهت إلى نصر نوعي خلّدته ذاكرة العالم كواحد من أكبر الانتصارات، على الإطلاق، على قوى الاستعمار…
هل كان ينبغي الاحتفاء بذكرى هذه المعركة بدل تكريم وجه إعلامي يرمز للمخزنية؟ ليس بالضرورة. لكن وبما أن التزامن جرى بالفعل، وعن طريق الصدفة، فإنه مدعاة للتأمل والتفكير في هذا العقل الجماعي الذي يقودنا إلى مثل هذه المشاهد.
عرفت شخصيا السيد مصطفى العلوي منذ فتحت عيناي على نشرة الأخبار (الخطبة). وكانت تعليقاته العصماء وهو يشرح لنا ما يريده “المخزن” أن يعلق في أذهاننا من معنى للصور والأحداث.
وتعرفت عليه أكثر خلال فترة التكوين الإعلامي في معهد الصحافة، بين إعجاب البعض بأسلوبه ونفور البعض الآخر. وأذكر جيدا كيف كان خبير فرنسي تردّد علينا عدة مرات في دورات تدريبية في تقنيات الإلقاء التلفزي، يحرص خلال ورشات التدريب على ضبط الإيقاع والتحكم في التنفس، والاعتماد في ذلك على “البطن” بدل الرئتين… على أن يقول لنا بين الفينة والأخرى: تجنبوا أسلوب “موسطافا ألاوي”.
ثم تعرّفت عليه أكثر بعدما تخرّجت ورحت أبحث عن مستقر مهني عبر التقلّب بين تجارب مختلفة في فترة قصيرة، فصادف وجودي ضمن هيئة تحرير مجلة “نيشان”، الشقيقة الموءودة لمجلة “تيل كيل” الناطقة بالفرنسية، تكليفي بمهمة إنجاز “تحقيق-بورتريه” عن مصطفى العلوي، الوجه التلفزيوني، بعد انتشار أنباء تقاعده حينها.
واجهتني خلال مرحلة اشتغالي الميداني على جمع المعلومات الخاصة بالشخصية موضوع الملف، صعوبات كبيرة، بما فيها بعض “التحرشات” من قبيل تلك النصائح المنطوية على التخويف. ولم يزدني ذلك سوى إصرارا على إنجاز المهمة، فكانت النتيجة ذلك الغلاف الشهير للمجلة، والذي حمل عنوان “يتيم الحسن الثاني”.
بعدها أصبحت علاقتي بالرجل أشبه بعلاقة “القط والفأر”، حيث كنت “أتسلّل” بانتظام إلى بلاطو برنامجه التلفزيوني الشهير، “حوار”، مستعملا بطاقتي المهنية التي كانت تحافظ على هيبة ووقار يفتجان جل الأبواب.
كنت أصل بشكل مبكّر، وأتخذ لي مكانا يسمح برؤية كل ما يجري في فضاء التصوير، لتكون تغطيتي في اليوم الموالي طبقا من مشاهد الكواليس والوقائع الدالة، من قبيل رفض أحد الضيوف الجلوس إلى جانب اخر أو إصرار أحدهم على الجلوس في الصف الأمامي ضمن الجمهور…
كنا ونحن في صحيفة “أخبار اليوم”، الموءودة بدورها، نقسو كثيرا على السيد مصطفى العلوي. فنحن الذين نعتبر أنفسنا ضمن صفوة الصحافة المستقلة نرى فيه ذلك “النقيض” الذي يسيء إلى مهنتها أو يضعفها. وكان الرجل يبدي روحا رياضية و”قشابة واسعة” لا متناهية، فيعمد للاتصال بي ممازحا إياي بعبارات من قبيل “آ داك النمس بغيت غير نشوف وجهك”، لأنه لم يكن قد تعرّف علي مباشرة وأنا المختبئ بين سطور صحافة ورقية في زمن ما قبل الشبكات الاجتماعية.
ستأتي الفرصة التي ستسقط عني قناع التخفي هذا، حين اقترحني الصديق الحبيب بلكوش، وهو قيادي حينها في حزب الأصالة والمعاصرة، لأكون من بين الصحافيين الذين سيحاورونه في بلاطو برنامج “حوار” أواسط العام 2010.
ثم تكررت التجربة لاحقا في أبريل 2011، حين شاركته حلقة استضافة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية حينها، عبد الاله بنكيران.
أذكر كيف جاءني اتصال مصطفى العلوي فجأة، لأجد صوته يهاجمني بمجرد فتح الخط: “آش طابخين أ داك أولاد (…)”. كنت أستوقفه طالبا منه أن يشرح لي ما الذي يقصده، فكان أن فهمت منه أن قيادة حزب المصباح اقترحت اسمي عليه كي أكون من بين محاوري بنكيران، فظنّ أننا متواطئون في ذلك، بينما لم أكن أعلم بذلك أصلا.
بل إن السيد بنكيران سيوجّه لي الصفعة الأولى في الكواليس، وقبيل انطلاق البرنامج، حين حرص على إخباري مسبقا أنه شخصيا لم يكن وراء اقتراحي، عكس الزميلين الآخرين، لأقوم إلى حصة “الماكياج” وأنا أتساءل هل أنسحب من هذا البرنامج؟ ليأتي السيد مصطفى العلوي ويوجّه لي الصفعة الثانية.
وقف منشط البرنامج “فوق راسي” وراح يحذّرني بلغة تجمع بين المزاح والجدّ، من أي تصرّف محرج أثناء المباشر، مرددا: “راه والله ما نعقل عليك ا مسكين.. راه ننزل عليك في المباشر!”.
هكذا عرفت مصطفى العلوي من بعيد ثم عن قرب.
رجل مميّز، لا هو بالملاك ولا هو بالشيطان. يمكن أن نحبّه كما يمكن أن نستهجن أسلوبه. وبالتالي لسنا مجبرين على اتخاذ موقف سواء مع أو ضد تكريمه، خاصة أن المبادرة جاءت من جمعية يحق لأعضائها القيام بما يتناسب مع اختياراتهم وأهدافهم.
لكن المشكلة تصبح كبيرة حين ننظر إلى المشهد العام لا كأجزاء. أي حين نلاحظ أننا أنتجنا ما يفضي إلى الاحتفاء باسم يرمز لمنظور “مخزني” في التدبير والعيش المشترك، لكننا لا نلتفت إلى ذكرى معركة مجيدة حقق فيها أسلافنا نصرا نوعيا ضد جيش أوربي كبير، وتمكنوا فيه من قتل القائد العسكري وغنموا عتادا عسكريا ضخما.
هنا يصبح المشهد مختلا وغير طبيعي. خاصة أنّ ندبات التاريخ القريب لعلاقة السلطة المركزية مع منطقة الريف لم تندمل بعد. بل وفي سجوننا شباب خرجوا من بين تلك الجبال مطالبين بالتعليم والصحة والشغل… ومن نخبنا السياسية من يتهمهم بالخلفية الانفصالية.
هل ندرك أين يكمن السلوك الانفصالي الحقيقي؟ أليس في تجاهل ودفن مثل هذه الذكريات المجيدة؟
الأمر لا يقتصر على معركة أنوال، بل يكاد يشمل جل المعاركة التي خاضها المغاربة من أجل الكرامة والاستقلال والحرية… وهذا هو السلوك الانفصالي الحقيقي؟
إلى متى سنهرب من ذاكرتنا الجماعية خوفا من مواجهة التناقضات التي جعلت “المخزن” في كثير من الأحيان يقف إلى جانب الغزاة ضد المقاومين؟ هل نعدم المثقفين والمؤرخين القادرين على تفكيك وتركيب هذه الفصول من تاريخنا الحديث، بشكل يصالحنا مع ذاكرتنا ويعزز ايماننا بالمصير المشترك؟
أطال الله عمر السيد مصطفى العلوي.. وكل قرن وذكرى معركة أنوال مجيدة!