أين توارى منظّرو فلسفة الحضارة الغربية؟
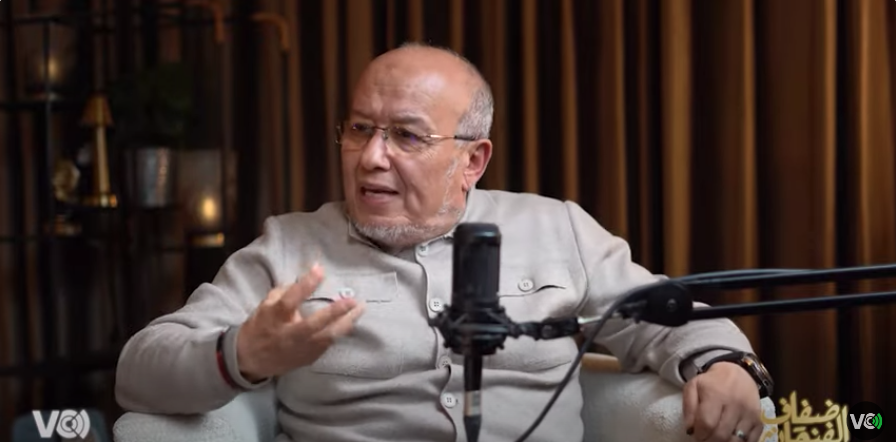
لطالما قدّم الغرب نفسه للعالم باعتباره ذروة الحضارة الإنسانية، مستنداً إلى تراث فلسفي عريض صاغه أعلام كبار من أمثال سقراط وأفلاطون وأرسطو، وصولاً إلى كانط الذي أسّس لمفهوم الكرامة الإنسانية والواجب الأخلاقي، ولوك وهيوم اللذين رسّخا قيم العقد الاجتماعي والحقوق الطبيعية، ونيتشه الذي بشّر بإنسان يتجاوز ضعفه ليرسم مصيره. وفي القرن العشرين ظهر أوزوالد شبنغلر بكتابه “أفول الغرب” محذّراً من انحدار الحضارة الأوروبية، وأرنولد توينبي بعمله الضخم “دراسة في التاريخ” مبرزاً دور التحدي والاستجابة في مسيرة الأمم، ثم جاء فرانسيس فوكوياما بصوته المنتشي معلناً “نهاية التاريخ” بانتصار الديمقراطية الليبرالية، في حين رسم صمويل هنتنغتون ملامح الصراعات المقبلة في كتابه “صدام الحضارات“.
كل هؤلاء، على اختلاف مناهجهم، أسهموا في صناعة صورة الغرب عن نفسه: نموذجٌ للعقل، للحرية، وللقيم الإنسانية. لكن أين أصواتهم اليوم أمام ما يحدث في فلسطين؟ أين الفلاسفة والمنظّرون الذين بشّروا بالعقلانية والأخلاق حين يواجه العالم مشهد إبادة وتجويع وتهجير قسري في غزة؟ هل الحضارة التي يتغنّون بها مجرّد زخرف لفظي ينهار أمام أول امتحان أخلاقي؟
لقد اعتُبر النموذج الأمريكي لزمن طويل قاطرة الحضارة الحديثة. غير أنّ العودة إلى التاريخ تكشف أنّه تأسّس على جريمة إبادة شعب بأكمله: الهنود الحمر الذين اعتُبرت أرضهم “خالية”، فاستُبيحت حياتهم وذاكرتهم. واليوم يُعاد السيناريو نفسه بصورة أخرى: رئيس أمريكي يضغط على الكيان الصهيوني، لا لإنهاء الحرب، بل للتعجيل بإتمام التهجير وإفراغ القطاع من سكانه تمهيداً لإعادة إعمار المنطقة وتحويلها إلى “ريفيرا الشرق الأوسط”. هكذا يُطلّ الاستعمار من جديد، ولكن بلسان “التنمية” و”الاستثمار”.
فهل يُعقل أن تُوصَف هذه الأنظمة التي تُحاصر الفلسطينيين، وتُسهم في تجويعهم، وتمنع عنهم الغذاء والدواء، وتدعم الكيان المحتلّ بالسّلاح؛ بأنّها أنظمة متحضّرة؟ أليس ما يجري تناقضاً فاضحاً بين المبادئ التي خطّها كانط عن الكرامة الإنسانية، وبين سياسات تقرّر أن يُخيَّر شعب أعزل بين الموت جوعاً أو الموت قصفاً؟ بل إنّ الرئيس الأمريكي نفسه لم يعد يجرؤ؛ بعد أن فُتح ملف “جزيرة الجنس” وقضية إبستين؛ على ممارسة أي ضغط -ولو رمزي- على الكيان المحتلّ، بل لجأ إلى معاقبة الوفد الفلسطيني بحرمانه من التأشيرات، وراح يلوّح بنهج الأسلوب نفسه ضد دول أعلنت رغبتها في الاعتراف بالدولة الفلسطينية. أيّ حضارة هذه التي تجعل المصالح السياسية فوق كل قيمة إنسانية؟
في هذا السياق، يكتسب استدعاء أصوات بعض المفكرين العرب معنى خاصاً. فقد كتب عبد الوهاب المسيري في نقده للمركزية الغربية والصهيونية، أنّ المشروع الغربي الحديث يقوم على “رؤية مادية شمولية تُحوّل الإنسان إلى أداة وتُحيله إلى مجرد مادة استعمالية”. وهذا ما نراه اليوم في غزة: الإنسان الفلسطيني يُختزل إلى رقم في نشرات الأخبار، وإلى “عائق ديموغرافي” ينبغي التخلّص منه. أما المهدي المنجرة؛ فقد حذّر مبكّراً من أنّ صراع المستقبل لن يكون حضارياً بالمعنى الإنساني، بل صراعاً على الهيمنة، وأنّ “الغرب يعيش أزمة قيم تجعله يفرض حضارته بالقوة لأنّه لم يعد قادراً على الإقناع”. أليست هذه الكلمات أصدق تعبير عن المشهد الراهن حيث تُساق الشعوب إلى الجوع والتهجير تحت شعارات مضلِّلة كـ “الهجرة الطوعية” أو “الحق في الدفاع عن النفس”؟
إنّ ما يحدث اليوم في فلسطين ليس حدثاً عابراً في رزنامة السياسة الدولية، بل هو لحظة كاشفة: اختبار حقيقي لمصداقية القيم الغربية. وحين يصمت منظّرو الحضارة الغربية، أو يبرّرون ما يجري، فإنّهم لا يفضحون فقط ازدواجية المعايير السياسية، بل يُظهرون كذلك أنّ الفلسفة الغربية تخلّت عن وظيفتها النقدية، وانحازت إلى منطق القوة. لقد كان شبنغلر يرى قبل قرن أنّ الغرب دخل مرحلة الأفول، وربما يكون الصمت الفلسفي اليوم عن مأساة غزة هو الدليل الأوضح على أنّ نبوءته لم تكن مجرّد خيال أدبي، بل وصفاً دقيقاً لانحدار حضارة فقدت بوصلة الأخلاق.
وختاما: إنّ الحضارة لا تُقاس بإنجازاتها المادية وحدها، ولا تُختزل في ناطحات السحاب ولا في العتاد العسكري، بل تُقاس بقدرتها على صون الإنسان الضعيف، وحماية حقّه في الحياة والكرامة. وإذا كان الغرب قد صاغ صورةً براقة لحضارته عبر قرون من الفلسفة والفكر، فإنّ غزة اليوم تُسقط القناع وتُظهر للعالم وجهاً آخر: وجهاً للصمت، للتواطؤ، وللأزمة الأخلاقية العميقة. ويبقى السؤال: هل سيجرؤ منظّرو الحضارة الغربية يوماً على مواجهة هذا التناقض الصارخ؟ أم أنّ التاريخ سيُسجّل أنّ من تكلّم بصدق كانوا قلة من أبناء هذه الأمة، كالمسيري والمنجرة، الذين رأيا بوضوح أنّ حضارةً لا تحمي الإنسان ولا تنحاز إلى الحق؛ إنما تُعلن -من حيث لا تدري-

















